الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن
ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...
حقق عبد الرحمن بدوي شهرته في عالم الفلسفة: تأريخًا، وترجمةً، وتحقيقًا، باسطًا نفوذه الكبير على حقبة مهمة من تاريخ الفكر العربي المعاصر، غير أن الكثيرين لا يُركزون على وجهه الأدبي الذي أثار معاصريه من النقاد؛ فقد ألّفَ في الرواية التي بثّ فيها رؤاه السياسية الموجهة للشباب المصري، لتضاف إلى كتابه عن نيتشه الذي كان شديد التأثير على جماعة الضباط الأحرار، ليُلخص أحد تلامذة بدوي القول عن أحد أهم روايته وهي «هموم الشباب»: «في رواية هموم الشّباب وضع بدوي منشورًا للشباب في مصر. واستوحى من الـمـاضي برنامـجًا للعمل في المستقبل. ولم يقرأ أحد هذه الرّواية، والذين قرأوها نسوها أو تناسوها، فكأنه لم يقل لنا، وإنما لأجيال من بعدنا!».[1]
مقدمة
يذهب فتغنيشتاين إلى أنه حينما يعجز أهل الفكر عادة عن التّنظير للأشياء أكاديميًا، يلجؤون إلى خدعة سردها روايةً وحَكْيًا، من هنا قد يكون لجوء عبد الرحمن بدوي إلى الرواية التي لم يُترجم إلى العربية أهم ما كُتب فيها عالميًا فحسب[2]، وإنما أَبدع روايات تُرجم بعضها إلى أكثر من لغة[3]، حيث صار يتمنى لبقية أعماله مصيرًا يشبه مصير رواياته[4]، ليكون جُهده في صنف الرواية موازيًا لبقية جهوده على مستوى باقي الجبهات الفكرية من التأليف في الفلسفة، وتاريخ الأفكار، والأدب؛ إبداعًا وترجمة وتحقيقًا، وكل ذلك عملًا بنصيحة أستاذه ألكسندر كوارييه وهو يلخص له سبب علاقته المتشنجة بزملائه في الجامعة المصرية: «إن كل كتاب تصدره هو بمثابة خنجر تطعن به الزملاء العاجزين الحاقدين مهما بلغت مرتبتهم في الوظيفة!».[5]
ما نعرفه عن عبد الرحمن بدوي هو نقله للعربية لأول سرديات العالم: «الدّون كيخوطي»، غير أنه كَتب الرّواية قبل ترجمتها، مزاوجًا بين الأكاديمي والإبداعي، فاتحًا بذلك تجربة جديدة لعلاقة الفيلسوف بالرّواية في العالم العربي[6]، خاصة وهو يعترف أنه وُلد من صلب روائي كبير هو مصطفى لطفي المنفلوطي الذي كان بدوي معجبًا بأسلوبه. فلم يتوقف عند التهام روايته «ماجدولين»، كما يقول، بل استظهر الكثير من صفحاتها، خاصة ذات النفحة الشّعرية، واستعاد قراءته عدة مرات وهو في سن العاشرة[7]. ويمكننا أن نتصور كم عدد الرّوايات التي سيقرأ بدوي بين سن العاشرة وما بعدها.
1 ـ عبد الرحمن بدوي أديبًا
حقّق بدوي موسوعية لا يكبحها شيء، ساعده على ذلك سعة ذاكرته، وقدرةٌ أكبر على التّكديس والتّخزين[8]، لتبقى الرّواية بالتالي الميدان الوحيد الذي يمكن أن يوظّف فيه الموسوعيُّ موسوعيته، خاصة والميزة التي لطالما ميّزت كبار الرّوائيين أنهم كلهم ذوو ثقافة موسوعيّة، فبلزاك كانت قصصه كأنها بحثٌ جامعي. وسرفانتيس كان يظهر أنه صاحب تجربة ذهنية وتاريخية وعسكرية خارقة، وروائيو ألمانيا كانت لهم معرفة غير محدودة بالفلسفة والعلم من غوته وانتهاء بتوماس مان[9].
كان بدوي ذا موسوعية مذهلة تتواشج فيه المرجعيات والرّؤى الفلسفية حد الغرابة، فهو كاتب دساتير الثورة[10]، ومؤرخ في الفلسفة والمذاهب الكلامية، وصاحب الرّؤية الشّعرية، والتجارب الحياتية التي خبر فيها مكائد السياسة ونوازع العاطفة والأهواء، فإلى جانب كونه قضى شطرًا من عمره بين الانتماء لأحزاب سياسية مختلفة وبين بلدان كثيرة، فإنه عاش تجارب عاطفية مجهولة نبّه على بعضها بشيء من التفصيل، ومرّ على بعضها الآخر مرور الكرام تمامًا كما كان يمر على علاقاته الغرامية التي كان يكسر بها تعب التحقيق والتدقيق بين النّسخ وعناء مجهوده الجبار في ترجمة النصوص من شتى اللغات، «فالرّوائي، فضلًا عن كونه فنانًا؛ يُعنى بجماليات عمله، إذْ يلتقي فيه المؤرخ بالفيلسوف. لأن حوادث قصصه، وإن تكن من صنع الخيال، ما هي إلا انعكاسات أو رموز لحقيقة عصره التي يمحصها، أو تركيزات لمعانيها، مع شرح وتعليق يغدقان عليه صفة الفيلسوف»[11].
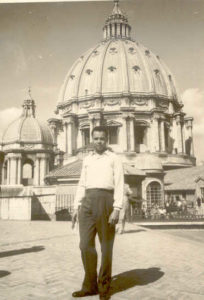
رغم أن عبد الرحمن بدوي صام عن الكتابة الإبداعية في شكلها الرّوائي، وقطع مع كتابة الشّعر والرّواية بعد رواية «هموم الشّباب» وبعد ديوان «مرآة نفسي»، فقد اكتفى عنها بترجمة أهم الرّوايات، والدواوين الشّعرية، والمسرحيات من لغات عالمية إلى العربية. بداياته الأولى كانت مع الرّواية والشعر، التي «لم يحقق في أيهما أي نجاح»[12] فحسب، بل مُني فيها بفشل وإخفاق ذريعين، حتى أنها كانت مثار تهكم لا ينتهي من بدوي، وأسلوبه في صناعة الشّعر وحبك الرّواية، فسيد قطب الذي يحسب له تقديمه لنجيب محفوظ والتنبيه إلى موهبته الرّوائية من خلال تقديمه لروايته «كفاح طيبة»، يشطب على كل تجارب بدوي الإبداعية، ويبالغ في السّخرية منها[13].
يعترف بدوي نفسه بما جرَّه شعره عليه من انتقادات ينعتها بدوي بالعنيفة، غير أنه يتعلل بأن سبب تلك الحملة هو انحيازه للمرأة والجمال، على نحو ما؛ لم تتحمله العقلية العربية الذكورية السائدة[14]. وليتملص أكثر من موجة الانتقادات، أكّد أن ديوانه الأول «مرآة نفسي» هو مجموع قصائد كتبها وهو في سن ما بين الرابعة عشر والتاسعة عشر[15]، أي ليس شعرًا لأيام ما بعد حصوله على الدكتوراة. وفي حوار له يذكر أن له ستة دواوين شعرية تقع في قرابة ثلاث مئة صفحة. ليصف إنتاجه الشّعري، بأنه يفوق ما كتبه أيٌّ من الشّعراء العرب الحاليين، وفي مقابل ذلك فكل الشّعراء العرب، عنده، يلزمهم أن يرموا في البحر فآخر شاعر بالنّسبة له هو أحمد شوقي وجبران خليل جبران، ليبقى شاعر كبَدر شاكر السّياب شاعرًا بدون قيمة[16].
2 ـ السيرة ورواية «هموم الشّباب»:
يلجأ عبد الرحمن بدوي منذ بداية روايته: «هموم الشّباب»[17] إلى تخصيص صفحة كاملة للتأكيد على عدم وجود اتصال بين مجريات الرّواية وحياة مؤلّفها، دون أن يلجأ إلى وضعها باسم مستعار أو بصفة أخرى تخفي حقيقة مؤلّفها، كما فعل القريب منه زمنيًا محمد حسين هيكل[18]. وكأن هناك خوفًا ما تملك بدوي خشية تأويل بعض القراء لروايته باعتبارها سيرة، خوفٌ يفسره تنبيهه الحاد اللّهجة للقارئ كي لا يعدَّها «سيرة» ليبقى الحفاظ على السّر إحدى معاني الكتابة لديه[19].
تدور أحداث رواية «هموم الشّباب» ضمن الزّمن الذي يشكل زمن سيرة بدوي نفسه، أي إلى الجيل المخضرم الذي خبر التّحولات التّاريخية الحاصلة في العالم وفي مصر، جيل تكوَّن في ظل الاستعمار الانجليزي، والحكم الملكي، وإرهاصات ثورة الضباط الأحرار، وعاصر انعطافات الفكر، والفلسفة، وانحرافات السياسة، والثقافة في مصر، وانخرط فيها بالتّمجيد مرة وبالاستخفاف مرة، وتعرّف على رموز التّحرر الوطني سياسيًا وفكريًا، وتعرف على نماذج الخيانة، الشّيء الذي يجعل كثيرًا من عناصر سيرة بدوي تظهر متناثرة ومشتتة في الرّواية، وكذا مواقفه وتوجهاته السياسية؛ لتشارك رواية «هموم الشّباب» في رسم الملامح العامة لحياة وطباع عبد الرحمن بدوي.
خلف حياة بطل رواية «هموم الشّباب»، هناك سيرة متوارية للمؤلف، فبطل الرّواية عاش إزاء الكتب أكثر من عيشه في أتون العالم، ليخرج عنها فجأة إلى عالم اللّيل وعالم النشاط السياسي السّري، في تعبير عن نموذج الإنسان المصري المعبر عن هموم مرحلة تاريخية، وعن قيمِ جيل، وأبعاد مآسي اجتماعية يمثلها سجناء النشاطات السياسية، ويمثلها عالم بنات الليل. ورغم أن بدوي يتحاشى أن يربط سيرته بسيرة البطل، غير أنه احتفل دومًا باسمه، ومهووس بالتّرجمة لنفسه، والتّعريف بشخصه، وبإظهار مكارمه، فبالتّأكيد لن يجد أحدًا يكتب عنه غير نفسه، ولن يجد من يؤدي دور البطولة في رواية غيره، ولهذا نجده يمجد ذاته قبل موته دون انتظار خطاب يخلد اسمه، ويحتفي بذكراه، ولهذا كما أرخ لنفسه في موسوعته الفلسفية مع فلاسفة العرب القدامى ضمن مادة «بدوي». ليكون هذا الاعتداد بالذّات دافعًا له ليؤلف رواية عن ذاته في رغبة مفضوحة في المجد والخلود.
تبقى رواية «هموم الشّباب» شبيهة بـرواية أستاذه المنفلوطي «النّظرات»، من جهة تركيزها على عيوب المجتمع، ونقدها مساوىء الأخلاق التي عاشها أهل المدينة؛ مثل المجون، والقمار، والرّقص، والخمر، وعوالم الرّذيلة. وشبيهة برواية المنفلوطي «الشّاعر» من جهة دعوتها الوطنية. وسيظل التّأثير قائمًا على صعيد روح الكتابة؛ ففي رواية عبد الرحمن بدوي شيء من أسلوب المنفلوطي[20] المتوزع بين الفصاحة السّهلة، وحسن الصّياغة، والميل إلى التّرسل، والانزياح المتكرر ثم إلى الإيغال في السّجع وما يتخلل ذلك من التكرار والإطناب في الوصف.
أكيد لم تكن رواية «هموم الشّباب» بالبعيدة عن حكم النّقاد من حكمهم على ديوانه الشّعري، فهي أصلاً لم تكن بالرّواية السّاخنة والحركية التي تحبس الأنفاس، وإنما على العكس؛ فقد تخللها فقرات طويلة من البرود والبطء لكثرة التّوصيفات، ولاسترسال بدوي في شرح المواقف وتفسيرها، وذلك إما عند حديثه عن حياة أحد أفراد الرّواية، أو أحد أحداثها التاريخية، حتى لَينسى نفسه في الحكي المتواصل، فيبتعد عن أحداث الرّواية، فينزاح وبشكل متكرر لتقديم تفسيرات غير متوازنة، فتصير الرّواية للحظات دروسًا، لا تكاد تنتهي إلا لتبدأ؛ في التاريخ مرة أو في السياسة مرات، ولتصير لمرات أخرى محاضرات في الفلسفة وتاريخها، أو لتصير مجرد تعقيبات عالِـم اجتماع عن ظواهر مجتمعية ما[21]، بشكل يجعل الأحداث بطيئة حد القرف، وبشكل لم يؤهل الرّواية إلى المستوى الذي يمكن أن تحجب فيه اسم صاحبها، كما هو حال محمد حسين هيكل مع روايته «زينب» أو مارغريت ميتشل مع روايتها «ذهب مع الرّيح».
للحظات يحس القارئ أن بدوي لم يكن يكتب رواية، وإنما سطّر هوامش لفلسفته في الحياة، ودوّن نتائج تأملاته عن المجتمع المصري، ثم يتذكر فجأة فيرجع مرة للأحداث التي يراها مقيمة لأركان الرّواية، مع استعراض فلكلوري لقدراته اللغوية، وكأن هناك رغبة للإيحاء بعلو قريحته في التّعبير والوصف عن مواضيع تتعلق بالحياة، والفلسفة، والمعرفة، والموسيقى، وعن أسلوب العيش في الشرق والغرب في أواخر الثّلاثينات، في طرح طويل ومتصل لقضايا كثيرة يناقشها الرّاوي مع نفسه معظم الوقت، ومع الآخرين أحيانًا، ولا يتردد في أن يجعل شخصيات أخرى غير الرّاوي تطرحها[22].
الرواية ترجمة للذات انطلاقًا من سيكولوجية الأديب، فيكتب بدوي – مثلًا – عن طفولة بطله التي تبقى متناسقة تمامًا مع أبعاد طفولته: «وكنت أنا الولد المتلاف من بين أبناء هذا الجيل: كنت أبغض التّوسط في كل شيء، ولا أقف إلا عند الأطراف البعيدة؛ وكنت حريصًا على أن أنال القسط الأوفر من التجارب الحية الحادة في كل ناحية، أطرقها من نواحي الحياة: المادية والرّوحية؛ وما عرفت يومًا السّكون إلى عاطفة أو الاستقرار عند مذهب أو التّعلق برأي واحد»[23]، إنه تعبير وجداني لا يليق إلا بطفولة بدوي نفسها، وتسجيل سردي لعواطفه وانفعالاته تجاه العالم والناس والمذاهب والأفكار.

رواية «هموم الشّباب» تبقى أيضًا سيرة تستجمع الأسئلة والهواجس والمشاكل التي يفترض أنها طُرحت على جيل عبد الرحمن بدوي، ابتداء من الدّين إلى العلاقة بالموسيقى، بل وإلى العلاقة ببنات الهوى وأندية الليل، ناهيك عن العلاقة بالعائلة وبالوطن والحب والخيانة، لتكون الرّواية ضربًا من أدب الاعتراف، ما دام الأمر يتعلق بحياة تشبه حياة عبد الرحمن بدوي في كثير من جوانبها فالرّوائي كما يؤكد الميلودي شغموم: «لا يمكنه أن يكتب إلا عن نفسه. بمعنى أن ذاته بكل ما تجيش به من ماض، وأحداث، وتوترات، واستيهامات، ومخاوف، هي المكون الأساسي لعالمه المفضل الذي يتكرر في أعماله. وهذا العالم حاضر في نسج الشخوص وتحريكها ورصد انكساراتها، التي لا تعدو أن تكون غير انكسارات المبدع»[24]. ولنكن إذن أمام نوع من المماهاة بين البطل والمؤلف، وهذا ما حاول الأخير التّخلص منه، ربما لخوفه من تحديد نقاط التّشابه التي سيلاحظها القارئ العارف ببدوي، إنها في الحقيقة رغبة في تفادي إحراج ما، مع جرأة غير معهودة في معالجة موضوع بطلته، معشوقة البطل.
خاتمة:
عرفنا جميعًا عبد الرحمن بدوي من خلال كتبه الفكرية، غير أننا لم نعرف وجهه الرّوائي، مع أنه وهب الخزانة الرّوائية ترجمات الأدب العالمي، ووهبها روايات من إبداعه الشّخصي، كتبها لوعيه بأهمية الشّكل الرّوائي، وبقيمة دور الرواية في التوجيه والتحريض، لا ليضفي تشويشًا مقصودًا على هوية عبد الرحمن بدوي الأكاديمية، ولكن لمحاولة تمرير فكره وموقفه السياسي عبر تغطية فنية مراوغة، وبالتالي توصيل قناعاته من خلال الكتابة السّردية القائمة على الانسياب وجنوح التخييل.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
[1] أنيس منصور، لو جاء نوح، دار الشّروق، القاهرة، الطّبعة الثّانية، 1420 ه ـ 1999 م، ص 195.
[2] ترجم عبد الرحمن بدوي كلا من: دونكيشوت لسرفانتيس، وفاوست وتاسو لجوته، ورواية من حياة حائر بائر، ايشندورف، وأندين، Undine لفوكيه، وحياة لثريو دي تورمس، وأعمال أخرى.
[3] يؤكد عبد الرحمن بدوي في حوار له نهاية الثّمانينات أنه يُعدّ للنشر مجموعة من الأعمال الرّوائية منها: «المسلسل الرهيب» تتضمن خلفية تاريخية تتعلق بحملة السّويس وأحوال أوربا لذاك الزمن، وتجربة حياته في سويسرا من 56 إلى 59، ورواية أخرى بعنوان: «لن أختار»، وهي رواية تُعبر عن تجربة حية؛ وهي مزيج من الحب والسّياسة والأفكار الوجودية. إلى جانب مأساة جابر بن حيان وهي مسرحية تاريخية، لها مدلول إنساني وفلسفي (سالم حميش، معهم حيث هم، قرطاج: بيت الحكمة، 1988، ص 125).
[4] يقول عبد الرحمن بدوي: «أتمنى أن تجد هذه الأعمال عند صدورها نفس الإقبال الذي حظيت به هموم الشباب، هذه القصة التي ترجمت إلى عدة لغات، واهتم بها مستشرقون، ومؤرخو الحركات السياسية في العالم العربي، وذلك لأنها تعبر بصدق عن أوضاع الشباب وأفكارهم بين الحربين العالميتين وخلال الحرب الأخيرة» (عبد الرحمن بدوي، ضمن معهم حيث هم، حاوره سالم حميش، ص 125). لكن الغريب أنه ببحثنا المضني في أرشيف المجلات القديمة والمكتبات العالمية عن ترجمة للرواية لا نعثر على أي دليل على ترجمات لها، ولا حتى عن دراسة متكاملة عنها، يتعلق الأمر ربما من بدوي بمحاولة تشكيك مضادة منه في رأي الذين شكوا في قدرته الإبداعية.
[5] عبد الرحمن بدوي، سيرة حياتي، ج 1، ص 66.
[6] كثير من المحسوبين على الفلسفة سيخوضون غمار الكتابة الروائية، نذكر منهم: محمد عزيز لحبابي روايتين مع جيل الظمأ (1967) وإكسير الحياة (1974)، وعبد الله العروي مع رواية الغربة (1971) ثم اليتيم (1978) ثم الفريق (1986) ثم غيلة (1998) ثم رواية أوراق (1989) فالآفة (2006)، ثم محمد عابد الجابري مع حفريات الذّاكرة (1997)، ثم سالم حميش مع مجنون الحكم (1990)، والعلامة (1997)، وهذا الأندلسي ! (2007).
[7] سيرة حياتي، ج 1، ص 27.
[8] يقول بدوي عن بطل روايته «هموم الشباب» الذي ليس في حقيقة الأمر غير بدوي نفسه: «لا أكاد أعبر عن أي شعور لدي إلا مقرونًا بفقرات طويلة لمؤلفين أعزاء لدي أحفظها وأؤديها عن ظهر قلبي، تعينني على هذا ذاكرة جبارة لعل فيها من الضرر أكبر مما فيها من الفائدة والغناء» (هموم الشّباب، ص 6). بل وفي سنواته الدراسية لم يكن يراجع دروسه كما بقية زملائه، وإنما يقوم بحفظ النصوص الأصلية يقول: «أما في السنة الثالثة فكان النّص اللاتيني الذي اختاره Patry هو رسالة: «في الشيخوخة» لشيشرون، وفي السنة الرابعة كان رسالة «في الصداقة» De Amicitia لشيشرون أيضًا. (…) استظهرتهما عن ظهر قلب هما وترجمتاهما الفرنسية. ولهذا حصلت على الدرجة النهائية في اللغة اللاتينية في هذه الأعوام الثلاثة» (سيرة حياتي، ج 1، ص 116)، وغيرها من نصوص الفلسفة، هذا دون حفظ روائع القصائد والخطب والرسائل التي تعد من غرر الأدب العربي. فقد استظهر قصائد للمتنبي، وصفي الدين الحلي، وأبي العتاهية، وصالح بن عبد القدوس؛ وغيرهم، كما استظهر خطب علي بن أبي طالب، وزياد ابن أبيه، والحجاج، وواصل بن عطاء، فضلًا عن رسائل عبد الحميد الكاتب، والجاحظ (سيرة حياتي، ج 1، ص 26).
[9] انظر عبد الله العروي، عبد الله العروي: من التّاريخ إلى الحب، حوار أجراه: محمد الدّاهي، شارك فيه: محمد برادة، وزارة الثقافة والفنون والتّراث – دولة قطر، نوفمبر 2013، عدد 29، ص 44.
[10] كان بدوي عضوا في لجنة الحقوق والواجبات، ولجنة الشّؤون الانتخابية. (ينظر عبد الرحمن بدوي، سيرة حياتي، م ن، ج 1، ص 338.) وأسهم في وضع المواد الخاصة بالحريات والواجبات، على الرّغم من كون القائمين على ثورة يوليو لم يأخذوا بدستور اللجنة لما فيه من تقرير وضمانات للحريات وضمانات للحكم الدّيمقراطي السّليم. وحاول جاهدًا أن يترك بصمته دون أن يدع الفرصة لقانوني كبير هو عبد الرّزاق السّنهوري في أن يستأثر بصياغة مواد الدّستور، لهذا ستكون أقوال بدوي في محاضر جلسات هذه اللجنة مستغرقة لأكثر من نصف صفحاتها التّي زادت على الخمسة آلاف صفحة.
[11] جبرا إبراهيم جبرا، الرّواية والإنسانية، الأديب، العدد رقم 1 1 يناير 1954، ص 35.
[12] فاروق عبد القادر، أوراق نهاية القرن، غروب شمس الحلم، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ط 2، 2002 م، 1423 ه، ص 423. وفي هذا الصدد يقول سيد قطب عن ديوان «مرآة نفسي»: «لقد كنت أقرأ بعض ما ترجمه الدكتور عبد الرحمن بدوي من الشّعر الغربي فأحس هذه الفهاهة وهذه الرّكة، فأقول: “لعله اضطراب فهمه للنصوص، وعدم قدرته على التّعبير عنها تبعًا لهذا الاضطراب …”. فلما قرأت مرآة نفسه عرفت السّبب وتبينت العلة. ورثيت للمساكين الذين مروا بهذه المرآة حين ترجم لهم هذا الشّاب العجيب! لقد علمت أن سائلاً سأل ناشر هذه الكتب: من الذي يقرأ كتب الدكتور بدوي؟ فكان جوابه: إنها تقرأ في العراق! وإنني لأسأل بدوري: ترى هذا الدّيوان كذلك قد طبع للعراق…؟ (…) ومعذرة للقراء! إنهم لم يعهدوني أكتب بهذه اللّهجة عن أحد ولا عن عمل أدبي كذلك. (…)» (سيد قطب، مرآة نفسي ديوان للدكتور عبد الرحمن بدوي، ضمن مجلة الرّسالة، يونيو، 1946، ص 602).
[13] فاروق عبد القادر، أوراق نهاية القرن، غروب شمس الحلم، ص 423.
[14] حوار: الشّعر الحديث تفاهة، وأنا الفيلسوف الوحيد، ضمن مجلة الكرمل، أكتوبر، 1991، ص ص 126. 127.
[15] حوار: عبد الرحمن بدوي الباحث والفيلسوف، ضمن مجلة الوحدة: فكرية ثقافية شهرية، باريس: 1986، ع.17، ص 155.
[16] الشّعر الحديث تفاهة، وأنا الفيلسوف الوحيد، ص ص 126. 127.
[17] في بداية الرواية يخصص بدوي صفحة ليُبرّيء نفسه مما في الرّواية من أحداث قد تنسب إليه فيقول: «كل محاولة للربط أو المقارنة بين بطل هذا الكتاب وبين مؤلف مصيرها الإخفاق الشّنيع فما هو إلا عرض لمأساة صديق أفضى إليّ في لحظاته الأخيرة بمكنونها، وما كان لي بها ولا بأشخاصها الآخرين معرفة من قبل على الرّغم من وثاقة ما كان يربط بينه وبيني من صلة روحية عميقة. وما أنا بمسؤول عن شيء فيه، دق أو جلّ، فليُطمئن الجميع بالهم من هذه الناحية، وكل مسؤولتي في أني آثرت جانب النشر على جانب الطّي».
[18] عن الخجل من نسبة الرّواية إلى كاتبها يقول محمد حسين هيكل: «نشرت هذه القصة للمرة الأولى في سنة 1914 على أنها بقلم مصري فلاح. نشرتها بعد تردد غير قليل في نشرها وفي وضع اسمي عليها» (محمد حسين هيكل، زينب، دار القلم، ص 5.) بل حتى مع اعترافه بأنه كان فخورًا بها حين كتابتها، معتقدًا أنه فتح بها في الأدب المصري فتحًا جديدًا. فحين عودته إلى مصر في منتصف 1912، ثم لما بدأ الاشتغال بالمحاماة، بدأ يتردد في النشر خشية ما قد تجني صفة الكاتب القصصي على اسم المحامي، لكن حب الفتى لهذه الثمرة من ثمرات الشّباب انتهى بالتّغلب على تردده، ودفع به ليقدم الرّواية إلى المطبعة، وإن أرجأ نشر اسم الرّواية ومؤلفها والإهداء إلى ما بعد الفراغ من طبعها، واستغرق الطبع أشهرًا غلبت فيها صفة المحامي ما سواها، وجعلته لذلك يكتفي بوضع كلمتي «مصري فلاح» بديلاً عن اسمه (محمد حسين هيكل، زينب، دار القلم، ص 5).
[19] يقول بدوي في تقديمه لتحقيق الإشارات الإلهية: «الكتابة ضربٌ من الصلاة، وخير الصلاة ما اتجه إلى المجهول أبدًا، وصار سرًا أبدًا، فإذا بدا السّرُّ أو عُلِمَ المجهول، فأحرِقْ ما كتبتَ وقُل مع العارف الدّاراني: «والله ما أحرقتُكِ حتى كدتُ أحترقُ بكِ».
[20] في هذا الصّدد يقول بدوي عن أسلوب المنفلوطي: «وكان له تأثير بالغ في أسلوبي وفي مشاعري. وظل هذا التّأثير مدى طويلًا، حتى بعد أن عرفتُ أساليب أخرى واطلعت على روائع الأدب العالمي. ولا أزال أحن، حتى اليوم، إلى معاودة قراءة هذا الكتاب. ولم تنقص قراءتي لأصله الفرنسي من إعجابي» (سيرة حياتي، ج 1، ص 28).
[21] هذه الانزياحات تستغرق غالب كُتب بدوي، حيث تجد موسوعيته لنفسها منافذ، ففي كتابه «سيرة حياتي» مثلاً، عِوض أن نجده يتكلم عن سيرته بشكل أساسي، ينسى نفسه، ليخوض ولعشرات الصّفحات في كلام يخص متحف اللّوفر وتاريخه والمكتبة الوطنية وأقسامها، وعن تاريخ ليبيا القديم والتّفصيل حد الإطناب في تاريخ طرقها الصّوفية، وتاريخ إيران السياسي وجغرافيا هذا البلد. وعوض حديثه عن نفسه مرة ثانية سنجده يخصص الصّفحات لسيرة شاه عباس الأول، وللفتنة البابية والدّستور الإيراني، وليعرج على الحديث عن اليهود في إيران، ثم عن عاشوراء والصّفويين، بل ويفصّل في المذاهب والفرق حتى تنسى أنك أمام كتاب للحديث عن الذات إلى كتاب عن الملل والنحل.
[22] علي الرّاعي، الرّواية فى نهاية قرن، القاهرة، 2000، ص ص 243. 248.
[23] هموم الشّباب، ص 140.
[24] هشام العلوي، السّيرة الذاتية بالمغرب ثلاث زوايا للنظر في تجربتها، ضمن مجلة فكر ونقد، ص 60.
ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...
«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...
لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...
إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...
«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.