الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن
ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...
«الأفضل أن تحاول وتفشل، مقارنة بألا تفعل شيئًا وتنجح. ربما تبدو النتيجة واحدة، لكنك لن تكون كذلك. نحن دائمًا ما ننضج في خساراتنا أكثر من نجاحاتنا» – سورين كيركيغارد
يُعد پول أوستر أحد أهم الروائيين الأمريكيين في العصر الحالي، فقد تُرجمت أعماله إلى لغات كثيرة، وتحوّل بعضها إلى نصوص سينمائية، وقصص مصوّرة ومسرحيات، كما اقتبست بعض من كلماته ونصوصه وتحوّلت إلى كلمات لأغاني موسيقية. وبالرغم من الثيمة البوليسية العامة في روايات أوستر وأعماله السردية، إلا أنه يحيك عوالم الرواية وشخصياتها بطريقة يظهر فيها تأثره بعدد من الكتّاب الأمريكيين السابقين عليه مثل إدغار آلان پو، وصامويل بيكيت، وناثانيال هوثورن.
تتكرر في روايات أوستر بعض الأحداث التي تنعكس أحيانًا من حياته وهويته، مثل تكرار ثيمة الأب الغائب، وخسارة المال، ومواقف من التاريخ الأمريكي، وأحيانًا قد تؤدي الصدفة دورًا في رواياته مثل الشخصية السردية التي التقت بالكاتب نفسه في «ثلاثية نيويورك»، لكنني في هذه المقالة أحاول تقديم قراءة لأحد أقصر أعمال أوستر، وهي «في بلاد الأشياء الأخيرة»، التي تبحث فيها الشخصية الرئيسية عن أخيها في مدينة منهارة، تبدو فيها الحياة قريبة من الفزع والخسارة؛ خسارة كل شيء. وهكذا، مُشبّعةً بالقلق، تقول الشخصية الرئيسية: «الأمر الأساسي هو أن لا تعتاد أي شيء؛ لأن العادات مهلكة. حتى لو كانت للمرة المئة، يجب أن تواجه أي شيء وكأنما لم تعرفه البتة من قبل. لا يهم كم عدد المرات، ينبغي أن تكون على الدوام المرة الأولى. هذا مضارع للمستحيل، أعرف تمامًا، ولكنه القانون المطلق».
كتب أوستر روايته «في بلاد الأشياء الأخيرة»، وكأنها رسالة مطوّلة كتبتها الشخصية الأساسية، وقد حُفظتْ هذه الرسالة في أحد الدفاتر، ويبدو من أسلوب كتابتها أنّ صاحب الرسالة لا يعيش في ذات المدينة التي تجري فيها الأحداث، ولا يعاني من ظروفها؛ إذْ تجد أن الشخصية الأساسية قد تتوقف عن سردها حتى تصف البيئة مرة تلو الأخرى، وكأنها تحاول أن تبدد افتراضات القارئ، وتبني معه تصورًا أدق عن المدينة وتفاصيل الحياة فيها. كأن تكتب على سبيل المثال: «يجب أن تفهم كيف هي الحال معي الآن. أتحرك، وأتنفس ما يهبني إياه الهواء، آكل أقل ما في الوسع، لا يهم البتة ما يقول الآخرون، الاعتبار الأوحد هو البقاء واقفًا على قدميك».
من ناحية أولى، فالمدينة التي تجري فيها هذه الأحداث تعاني من انهيار اقتصادي، أتبعه تهافت الحياة اليومية التي تعرفها البشرية اليوم، والقلق هو الثيمة العامة للمعيشة في تلك المدينة حيث لا شيء ثابت، ولا شيء يبقى على حاله، «على الرغم مما تفترضه فإن الوقائع ليست معكوسة البتة؛ فمجرد استطاعتك الدخول لا يعني أنك ستستطيع بالتالي الخروج. فالمداخل لا تصبح مخارجًا، ولا شيء يضمن أن الباب الذي قد مررت عبره منذ لحظة سوف يظل هناك حين تلتفت بحثًا عنه مجددًا. هكذا تجري الأمور في المدينة، ففي كل مرة تعتقد أنك تعرف الجواب عن سؤال ما لا تلبث أن تكتشف أن لا معنى لذلك السؤال البتة».
هذه الحالة من القلق لا تقتصر بطبيعة الحال على المداخل والأبواب فحسب؛ بل تشمل حتى أساسيات الحياة مثل الطعام، والأمن، والسكن؛ فالتفكير بالطعام مثلًا لا يؤدي إلى إلا المتاعب كما تذكر الشخصية الرئيسية في رسالتها: «حين تتضاءل رغباتك تكتفي بالقليل، وكلّما قلّت حاجاتك أمسيت أفضل حالًا. هذا ما تفعله بك المدينة، إنها تقلب أفكارك رأسًا على عقب، وتمنحك رغبة بالحياة وهي في الآن عينه تجتهد لسلبك إياها». فأولئك الذين يرفضون الاستسلام للواقع ويجوسون الشوارع بحثًا عن كسرات الطعام لساعات طويلة، يجازفون بالأمن والسلامة البدنية، فضلًا عن أن العاثرين على كسرات الطعام يندفعون بحيوانية ممزقين الطعام بأصابعهم، فتجدهم يأكلون دون أن يملؤوا جوفهم أبدًا:
«ويتضح أخيرًا أن الطعام مسألة معقدة، وإنْ لم تتأقلم مع فكرة الرضى بما سيُعطى لك فلن تشعر بتاتًا بالسلام مع ذاتك. النقصان حالة متكررة الحدوث، والطعام الذي وهبك بهجة في أحد الأيام سيتوارى بأفضل احتمال في اليوم التالي».
لم تصل تلك المدينة إلى حالتها هذه بين ليلة وضحاها؛ بل إنّ ذلك ابتدأ بانهيار اقتصادي زلزل أركانها، فالوظائف الكريمة لم تعد متاحة للجميع في المدينة، «الأمر الأساسي هو البقاء على قيد الحياة»، تقول الشخصية الرئيسية في رسالتها، «فإذا نويت البقاء هنا، فإنه ينبغي أن تعثر على طريقة لكسب المال، ولهذا فالوظائف المتبقية قليلة جدًا»، فلا يمكن أن يصل المرء إلى وظيفة حكومية ما، كأن يعمل كاتبًا أو حاجبًا أو موظفًا بأحد مراكز التحويل، دون معرفة شخصية وثيقة بمن يمكن أن يتوسط له، ويسانده للحصول على هذه الوظيفة، ولا يقتصر هذا الأمر على الوظائف الحكومية فحسب؛ بل حتى الوظائف غير الشرعية في كل أرجاء المدينة. ولهذا فأكثر الوظائف شيوعًا في المدينة هي الكناسة؛ «هذا هو عمل المتبطلين، وأعتقد أن ما بين عشرة أو عشرين بالمئة من السكان يعملون فيها»، كما تقول الرسالة.
كما أن ادخار بعض المال يُعد ضربًا من المستحيل، «وإنْ تمكنت، فهذا يعني أنك تحرم نفسك من شيء ما أساسي؛ كالطعام على سبيل المثال»، وبذلك يجد سكان المدينة أنفسهم بين إنفاق كل ما يمتلكونه في سبيل الحصول على الأساسيات، أو الجوع في سبيل توفير بعض المال، مما يفضي بالضرورة إلى انعدام طاقتهم البدنية الضرورية للقيام بالأعمال. «هل اتضح لك المأزق؟ أنك كلما اجتهدت أكثر في العمل غدوت أضعف، وغدا العمل أشد وطأة».
أما بالنسبة للمساكن، «فنصف السكان بالتمام مشردون، وليس لديهم إطلاقًا أي مكان يقصدونه»، الأمر الذي يجعل التجول في المدينة خطرًا وقد يفضي إلى نزاعات ومشاجرات مفاجئة، لو دهست بالخطأ على قدم شخصٍ ما، أو تعديت حدود منطقته التي استولى عليها من الشارع؛ فالتجول بالشوارع أضحى عملية مقلقة: «يتوجب أن تكون عيناك مفتوحتين باستمرار، وأن تحدّق إلى الأعلى، إلى الأسفل، إلى الأمام، إلى الخلف، مراقبًا الأجساد الأخرى، على حذر من اللامتوقع، يمكن أن يمسي اصطدامك بأحدهم أمرًا مهلكًا». أما بالنسبة لأولئك الذين ما يزالون يملكون مساكنهم، فهم معرّضون للدوام إلى فقدانها بالقوة، ومن النادر أن تجد بين أهل المدينة من لم يفقد مسكنه نتيجة اقتحام مجموعة مدججة بالسلاح، فضلًا عن أن «معظم المباني لا يملكها أحد، ولهذا لا حقوق لك كمستأجر؛ لا عقد إيجار، ولا يوجد إثبات قانوني تستند إليه إن واجهتك أية مشاكل».
في ظل تلك الظروف، يبقى الموت هو الحاضر الأكبر في هذه المدينة، فذوو القلوب الشجية يموتون مبكرًا، وفي نومهم دائمًا، «يجولون لشهر أو اثنين وفي وجوههم ابتسامة غريبة، فيما تحلّق حولهم وهج آخرية عجيبة، كما لو أنهم قد بدؤوا مذاك يختفون». ربما تكون هذه هي الميتة الألطف في بلاد الأشياء الأخيرة، وفي ظل الظروف الصعبة التي تقاسيها المدينة المنهارة، تكتمل الظروف المناسبة لولادة أبشع ما في الآخرين، ولأكثر من طريقة للموت في هذه المدينة.
فهنالك مثلًا القفز انتحارًا من أسطح المباني العالية، أو الوثبة الأخيرة كما يُتعارف عليها في المدينة، «وهذه أيضًا تحوّلت إلى نوع من الشعائرية الشعبية»، وهي الميتة الأكثر شيوعًا من جهة أخرى. كما ذكرت الشخصية الرئيسية ثلاثة ميتات أخرى تتمثل في عيادات القتل الرحيم التي ختنجرف فيها من غير هدىً إلى النوم ولا تستيقظ أبدًا»، إلا أن هذا الأسلوب يبدو مكلفًا أيضًا، والبديل الأوفر هو الانضمام إلى نوادي الاغتيال، «وهذه تتفاقم شعبيتها حاليًا»، إذ يقوم النادي بجميع الترتيبات اللازمة لاغتيال الزبون مقابل رسوم مادية متواضعة، «ويبقى كل ما يتعلّق بمقتله سرًا، ابتداءً من الموعد والمكان والأسلوب المستخدم، وانتهاءً بهوية القاتل».
الطريقة الأبشع للموت والأكثر مأساوية كانت «فرقة من الناس تركض عبر الشوارع بأسرع ما في وسعهم، ملوحين بأذرعهم بعيدًا، زاعقة بأقصى ما تلفظه الرئتان»، حتى يسقطون واحدًا تلو الآخر من الإعياء، «المقصود هو الموت بأسرع وقت ممكن، أن تجهد نفسك بقسوة بالغة إلى درجة لا يتحملها القلب». ويبدو أن العداؤون يقومون بذلك كمجموعات في سبيل تشجيع بعضهم للاستمرار في الميتة البشعة، والتي يمكن أيضًا أن تقتل كل من يقف في طريق المجموعة.
ونظرًا لكثرة الوفيات في المدينة المنهارة، فإن مسألة الجثث على سبيل المثال أضحت أحد المشاكل العملية، فالناس «لا يموتون كما يحصل بالماضي: ملتقطين أنفاسهم الأخيرة بسكون على أسرّتهم، أو في جناح بهو مستشفى نظيف»؛ بل إنهم يموتون في أي مكان، وغالبًا في الشوارع. ونظرًا للشح الكبير في الموارد، فإن غالبية الجثث تُترك عارية بعدما ينهبها الآخرون، ويسلبونها من ممتلكاتها حتى يحين وقت التقاطها من قِبل العاملين في الكناسة، «وما يُسلب أولًا هو الأحذية؛ لأن الطلب عليها مرتفع، ويصعب العثور عليها، وتجذب الجيوب الانتباه بالدرجة الثانية»، وبالطبع جميع قطع الملابس لا تسلم من النهب.
لا شك أن ظروف المعيشة في العالم الذي خلقه پول أوستر في روايته تبدو مستحيلة، ولكن وعلى الرغم من ذلك يجد الناس طريقتهم الخاصة في التكيف مع تلك الظروف، والتمسّك بالحياة قدر الإمكان. ولربما يشتهر أوستر كونه روائيًا بوليسيًا، تبحث الشخصيات في عوالمه عن فك شفرة لغز ما، مثل بطلة البلاد الأخيرة التي تبحث عن أخيها في مدينة متهالكة، لكنني أعتقد بأن ألغاز أوستر تكمن في عبقرية سرده، ووصفه لانفعالات شخصياته الروائية واضطراباتها. «أسوأ ما في الحياة أن تكون ردود أفعالنا متوقعة»، يقول أوستر، «ليست متوقعة من جانب الآخرين فحسب، بل من جانب أنفسنا أيضًا»، وكما يقول أوستر في أحد اللقاءات الصحفية:
«أميل إلى أن أرى الإنسان كمجموعة أطياف؛ وهنالك أجزاء مختلفة منا تظهر وتعبّر عنا في أوقات مختلفة. نحن لا نشبه أنفسنا في كل الظروف، وكل واحد منا هو أشخاص مختلفون في ظروف مختلفة. لسنا متماسكين، لسنا منطقيين، أو على تناغم مع صورة واحدة محددة عنا، بل نحن دائمو التناقض مع ذواتنا. قد نحاول أن نكون ثابتين لكن ذلك مستحيل، للإنسان أطياف كثيرة ولذلك فإن مفهوم الشخصية الضيق والمحدود لا يفيه حقه؛ لأنه يسجنه في إطار محدد ذي تجليات محددة. وإني مقتنع بأن معظمنا، وأشمل نفسي بهذا الكلام، لا نفهم أنفسنا جيدًا، بل نحن حتى سر غامض لذواتنا قبل أن نكون لغزًا للآخرين».
والإنسان عمومًا كائن متكيّف مع محيطه، لا يذبل سعيه في تحسين ظروف معيشته، مهما كانت تلك الظروف: «كان الأمر اللافت هو سرعة تكيّف الجميع مع الرفاهيات المادية»، حتى أن البعض قد يشعر باستحقاقيته لتلك الرفاهيات أحيانًا إن اعتاد عليها في أيامه، كما تكتب الشخصية الرئيسية حتى تتابع: «وقد لا يكون ذلك بالغرابة التي يوحي بها. فجميعنا يعتبر الحصول على الأشياء حقًا مكتسبًا، ولكن حين يصل بنا الأمر إلى تلك الأشياء الأساسية؛ كالطعام والمسكن، فإنها قد تصبح حقًا طبيعيًا، ثم لا يمضي وقت طويل حتى نعتبرها جزءًا تكامليًا منا».
لا شك أن أوستر استطاع خلق كبسولة من القلق والفزع بكل تلك الظروف، فتدور الحبكة الأساسية عن مغامرة الشابة في المدينة الجديدة عليها بالكامل؛ حتى في قوانينها الطبيعية والتعاملات البشرية المختلفة، «كانت المدينة لا تزال جديدة بالنسبة إليّ آنذاك، وبدوت تائهة على الدوام» كما تكتب في رسالتها الطويلة، وليس الأمر مجرد قلق الانتقال إلى المدينة الجديدة؛ بل إن هذه المدينة تتلاشى ببطء أيضًا، «فتبدو المدينة وكأنها تستهلك ذاتها ببطء وثبات، حتى ما تبقى منها. ولا سبيل إلى تفسير هذا. أستطيع فقط تدوين ذلك، ليس بوسعي ادعاء الفهم».
ومن جهة أخرى فمن الوارد جدًا في حالة الفزع العامة مثل التي نجدها في بلاد الأشياء الأخيرة، أن تنحصر أفكار المرء على حاضره، وعلى ما يجده في أيامه بشكل ماديّ، أو كما تعبّر عن ذلك الشخصية الرئيسية: «لزمن طويل حاولت ألا أتذكر أي شيء، كنت قادرة بشكل أفضل على التدبّر، وقادرة بشكل أفضل على تحاشي العبوس. إن الذاكرة هي الفخ الأعظم»، وللقلق دوره في خلق حاجز ذهني يخنق أفكار المرء: «كنت شديدة الخوف إلى حدّ بدا معه دماغي وكأنه توقف عن العمل»؛ فالفزع الذي يصوّره أوستر لا يشلّ التفكير فحسب؛ بل هو قادر كذلك على مسح الأسماء من الذاكرة. كما نجد في النصّ التالي عندما التقت الشخصية الرئيسية بأخرى ثانوية:
«قلت وفي غضون ذلك، كيف السبيل إلى الخروج من هنا؟ آه لا، انبرى هازًا رأسه، إن هذا مستحيل. ما عاد يُسمح للسفن بالقدوم إلى هنا؛ وإن كان لا شيء يصل، فما من شيء يستطيع الخروج. سألت: ماذا بشأن الطائرات؟ فرد سائلًا: ما هي الطائرة؟ وهو يبتسم لي مرتبكًا بطريقة ما، كما لو أني أخبرته للتو نكتة لم يفهمها. قلت: إن الطائرة هي آلة تطير عبر الجو وتحمل الناس من مكان لآخر. هذا سخيف، قال وهو يرميني بنظرة مشككة. ليس هناك شيء كهذا. هذا مستحيل. سألته: ألا تتذكر؟ أجاب: لا أعرف عما تتحدثين. قد تتعرضين للمشاكل إن رحت تنشرين هذا النوع من الهراء. إن الحكومة تكره أن يختلق الناس القسم. هذا ضار بالأخلاق».
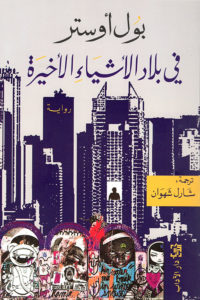
وهكذا، تنمحي الأشياء من حياة البشر في بلاد الأشياء الأخيرة، وتختفي دلالاتها من الذاكرة الجمعية تباعًا، ومن القواميس تباعًا بالضرورة إن كان هناك قواميس بتلك البلاد. «كيف يمكنك أن تتحدث مع شخصٍ ما عن الطائرات على سبيل المثال، إذا كان ذاك الشخص لا يفقه ما هي الطائرة؟» تكتب الشخصية الرئيسية في رسالتها، «إنها عمليّة إمّحاء بطيئة، ولكن يتعذر تجنبها. تميل الكلمات لأن تدوم أكثر بقليل من الأشياء، ولكنها في النهاية تضمحل أيضًا، وبمعيّة الصور التي استحضرتها يومًا». فاللغة في نهاية الأمر حيّة تتفاعل مع البشر وأساليب حياتهم اليومية، وكما أن مصير الأشياء الزوال وأن يستبدلها الإنسان بغيرها، مثل كبائن الاتصالات التي استبدلت اليوم بالهواتف المحمولة، فلن تدوم الأيام حتى تختفي جميع الكبائن من الشوارع، وينسى البشر اسمها بعد ذلك.
وهذا ما ظهر للشخصية الرئيسية في بادئ الأمر وكأنها مؤامرة كاذبة ضخمة أو تواطؤ عام للنسيان: «ليست المسألة أن الناس يتعمدون الكذب عليك، بل مجرد أنه حيثما يكون للماضي علاقة بالأمور، تميل الحقيقة إلى الغموض بسرعة كبيرة»، فكما أن التاريخ يكتبه المنتصرون، ففي بلاد الأشياء ينتصر العدم وينتشر النسيان حتى التلاشي الكامل للمدينة، فلا يبقى للأمل مساحة في الأرض. «حين يضمحل الأمل، وحين تكتشف أنك كففت حتى عن الأمل باحتمال الأمل، فإنك تسعى عندئذ لأن تملأ الفراغات الشاغرة بالأحلام. خواطر قليلة طفولية وحكايات لتبقى مستمرًا»، والأحلام الطفولية في بلاد الأشياء الأخيرة هي لغة الفناء، «ونظرًا لما قد ينتظرنا، فإنه لأمر مبهج أن نحلم بسخافات كهذه»، أو لغة الأشباح كما تم وصفها:
«كل هذا ينتمي إلى لغة الأشباح، وثمة أنواع كثيرة للحديث بواسطة هذه اللغة. معظمها يبدأ حين يقول شخص لآخر “أتمنى”. وما يأملون به يمكن أن يكون أي شيء ما دام أمرًا ممتنع الحدوث. أتمنى ألا تغيب الشمس أبدًا. أتمنى أن تنبت دراهم في جيوبي. أتمنى أن تصير المدينة كما كانت في الأيام الغابرة. أنت تفهم ما أعني. أشياء عبثية وصبيانية فاقدة المعنى وغير حقيقية. عمومًا يتمسّك الناس بالاعتقاد القائل إنه مهما كانت الأمور سيئة في الأمس فإنها كانت أفضل مما هي اليوم».
يقول الفيلسوف الإيطالي أمبيرتو إيكو في حديثه عن الذاكرة بأننا عبارة عن ذكرياتنا، أي أن فاقد الذاكرة لا يغدو ذاته بعدها على سبيل المثال بل يصبح شخصًا جديدًا مختلفًا. وفي بلاد الأشياء الأخيرة «الجميع معرّض للإصابة بالنسيان، حتى في أفضل الظروف»، كما كتب أوستر، «في مكان كهذا، حيث يتوارى عمليًا الكثير الكثير من العالم المحسوس، في مقدورك أن تتصوّر كم من الأشياء تصبح منسيّة على مرّ الوقت». وفي النهاية، فلا تكمن المشكلة في النسيان بحد ذاته، أو تفاوت الأشياء التي ينسونها؛ فما ينساه شخصٌ ما قد يبقى كذكرى لدى آخر، وهذا ما يظهر في عدة مواقف تواجهها الشخصية الرئيسية.
عمومًا فاللغة بالنسبة إلى أوستر لا تتعدى كونها أداة، الأداة التي نستخدمها لوصف العالم حتى نفهمه، كما أوردت الشخصية الرئيسية حين قامت بكتابة هذه الرسالة المطوّلة كمحاولة للفهم، وبالرغم من كون اللغة وسيلة لفهم العالم من حولنا إلا أنها بطريقة أو بأخرى محدودة أيضًا، بمفرداتها ومصطلحاتها على أقل تقدير إذا ما استبعدنا إساءة استخدمها أو استخدامها بشكل رديء. أو كما يقول أوستر في لقائه مع الصحفية جمانة حداد:
«واللغة هي بالنسبة إليّ محض أداة، وليست العالم في ذاته، إنها الأداة الوحيدة التي نملكها لفهم العالم، ولكنها ليست مرادفًا للعالم، لا بل إنها في شكل ما تحرمنا إياه. اللغة تبسّط وتصنف وتمنهج، أي أنها تحد. عالم إدراكاتنا معقد جدًا، وأشياء لا تحصى تتدفق إلينا في اللحظة الواحدة، لذلك فإن كل وضع أو حالة أو شعور نعيشه لا بد أن يكون أبعد من متناول الكلمات. نحاول أن نُسائل العالمَ باللغة وأنفسنا، لكنها في رأيي محض مقاربة أو تخمين».
ربما لا تكون للأعمال السردية أي قيمة مادية تُذكر، فلا هي أنقذت طفلًا ما من مجاعته ولا مريضًا من سقمه كما يعبّر أوستر عن ذلك في خطبته بمناسبة منحه جائزة أستورياس للآداب عام ٢٠٠٦م: «إذ إنّ الفن بالذات هو ما يميزنا عن بقية الكائنات في هذه المجرة، وهو تحديدًا البذرة الأساسية في تعريف العنصر الإنساني في الكائن الحي. أن تصنع شيئًا لمجرد المتعة والجمال، الجمال في تأمله مصنوعًا والجمال في خطوات صنعه. أرجو أن تفكروا كثيرًا فقط مجرد التفكير في الجهد المبذول أو الساعات الكثيرة جدًا والانضباط المطلوب ليصبح شخص ما عازف بيانو يُشار له بالبنان، أو راقصًا مبدعًا».
ولاشك أن أوستر ذاته قد أبدع في كتابته لرواية «في بلاد الأشياء الأخيرة» بما ينصّبه كأحد أبرز الروائيين والفنانين المعاصرين، فكما يقول في خطبته الآنفة: «السرد بطبيعة الحال يوجد في شكل مختلف من الفنون؛ إذْ إنّ وعاءه هو اللغة، واللغة هي شيء نشترك فيه جميعًا». ينطلق أوستر من أننا -كبشر- ومنذ نعومة أظافرنا، وتحديدًا منذ بدء التخاطب مع الآخرين، يكون لدينا نهم فضولي لسماع القصص، ولا يخبو هذا النهم حتى مع سماع القصص، بالرغم من تباين أساليب إشباعنا لهذا النهم والوسائل التي نفضلها عن غيرها. فقد كتب أوستر في رسائله إلى ج. م. كوتزي:
«لا شك أن في الرياضة مكوّنًا سرديًا قويًا. نحن نتابع التفافات الصراع وانعطافاته لنعرف النتيجة النهائية. لكن لا، ليست بالضبط كقراءة كتاب -على الأقل ليست كالكتب التي نكتبها أنت وأنا-. لكنها قد تكون على علاقة وثيقة ببعض أنواع الأدب. فكِّر مثلًا في روايات الإثارة، والروايات البوليسية، التي تبقى دائمًا نفس الكتب، تتكرر بلا نهاية، آلاف التنويعات البسيطة على نفس القصة، ومع ذلك تجد الجمهور جائعًا إلى هذه الروايات جوعًا رهيبًا. وكأنما كل واحدة هي أداء جديد لطقس ما».
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...
«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...
لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...
إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...
«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.