لوحات من الفلسفة الوجودية: إضاءة على أبرز مفاهيم ومقولات الوجود | أوس حسن
إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...
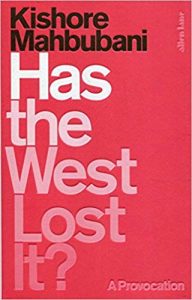 في كتابه القصير والاستفزازي “هل فقد الغرب صوابه؟”، يحدد الدبلوماسي السنغافوري كيشور محبوباني مفارقة غريبة. يُعتبر العالم في عصرنا هذا في أفضل حالاته، وذلك من نواح عديدة، إذ يعيش الناس حياة أطول وأكثر صحة وأمانًا من أي عصرٍ مضى عبر التاريخ. ووفقًا لمحبوباني، فقد أتى هذا التحسّن الهائل في الحالة الإنسانية نتيجة الأفكار والممارسات الغربيّة – العلوم الحديثة والديمقراطية الليبرالية والأسواق الحرة – التي امتدّت إلى مجتمعاتٍ أخرى. ومع ذلك، تُظهر الدراسات الاستقصائية أنّ لدى الناس في الغرب رؤية مستقبلية قاتمة وكئيبة لا مثيل لها في أيّ مكان آخر في العالم. فهل فقد الغرب صوابه بالفعل؟
في كتابه القصير والاستفزازي “هل فقد الغرب صوابه؟”، يحدد الدبلوماسي السنغافوري كيشور محبوباني مفارقة غريبة. يُعتبر العالم في عصرنا هذا في أفضل حالاته، وذلك من نواح عديدة، إذ يعيش الناس حياة أطول وأكثر صحة وأمانًا من أي عصرٍ مضى عبر التاريخ. ووفقًا لمحبوباني، فقد أتى هذا التحسّن الهائل في الحالة الإنسانية نتيجة الأفكار والممارسات الغربيّة – العلوم الحديثة والديمقراطية الليبرالية والأسواق الحرة – التي امتدّت إلى مجتمعاتٍ أخرى. ومع ذلك، تُظهر الدراسات الاستقصائية أنّ لدى الناس في الغرب رؤية مستقبلية قاتمة وكئيبة لا مثيل لها في أيّ مكان آخر في العالم. فهل فقد الغرب صوابه بالفعل؟
يشعر الغربيّون اليوم بالتشاؤم بشأن مجموعة كبيرة من الأمور، كالاكتظاظ السكاني، والاحتباس الحراري العالمي “أو الاحترار العالمي”، وويلات الليبرالية الجديدة، والإزالة المتسارعة للغابات، وانقراض الأنواع، وعدم المساواة المتزايد، وصعود الشعوبية اليمينية المتطرفة، والهجرة الجماعية، ووباء الاكتئاب والاحتراق النفسي burn-out، وزحف “الأسلمة” إلى المجتمعات الغربية، وسيطرة الروبوتات على العالم، أو ربما مجرد السّأم النهائي الذي ينتظرنا جميعًا عند نهاية التاريخ. وبالنظر المتمعّن إلى مخاوفهم المحدّدة، يمكننا تحديد أربعة أنواع نموذجية من التشاؤم. لدى كل واحد من هذه الأنواع فكرة مختلفة بشأن مجرى التاريخ البشري، لكنّها تشترك جميعا في نظرة عامة متشكّكة لفكرة التقدم. ويكشف التفكير في هذه الأنواع الأساسية الأربعة عن صلات غير واضحة بين المتشائمين من خلفيات أيدلوجية متباينة أيما تباين، كما يوضّح أوجه قصور كل نوع ومخاطره.
المتشائم الذي يشعر بالحنين The Nostalgic Pessimist
كل شيء كان أفضل في الأيام الخوالي، حيث كان العالم ذات يوم مكتملًا وجميلًا، أمّا الآن فقد استحال كلُّ شيءٍ خرابًا. يحدد المفكرون الذين يملؤهم الحنين إلى الماضي عصرهم الذهبي المفضّل في فترات تاريخية مختلفة، فيتوق بعضهم إلى ماضٍ كانوا محظوظين بما فيه الكفاية ليعيشوه في شبابهم، بينما يحدد البعض الآخر فترة يوتوبيّة في ماضٍ أقدم، مثل فترة الحقبة الجميلة belle époque قبل الحربين العالميتين، أو الحياة الزراعية البسيطة والمجتمعات المترابطة في العصور الوسطى، أو ربما في الماضي السحيق الذي عاش فيه أسلافنا على الصيد وجمع الثمار “في انسجامٍ مع الطبيعة.”
يُعتقد عمومًا أن تمجيد عصرٍ ذهبيٍ ماض سِمةً مُميِّزة للنزعة السياسية المحافظة، لكن يمكن العثور عليه عبر الفجوة الكلاسيكية بين اليسار واليمين. بيد أنّ طبيعة ذلك الماضي المثالي تتحدّد من خلال المعتقدات الأيدلوجية للمراقِب، فالمتشدّدون اليمينيّون يتغنّون بالوقت الذي كان فيه الناس (وخاصة الشباب) مطيعين للسلطة والتقاليد، بينما يتصوّر نظرائهم اليساريّون ماضيًا كان فيه التضامن والثقة المتبادلة قيما نبيلة ومُقدّرة على نطاقٍ واسع.
وتكمن المشكلة في التشاؤم المصحوب بالحنين إلى الماضي في أن الناس يبدؤون، عاجلًا أم آجلًا، في التساؤل عن سبب حدوث الأخطاء، وعلى من تقع عليه لائمة الفردوس المسلوب. عادة ما سيجري تحديد بعض أكباش الفداء أو غيرهم؛ كالنخبة المرتشية “الداعية للعولمة”، أو الغزاة المُعادين، أو ربما يكون النظام نفسه هو السبب. كان يا ما كان، كانت حضارتنا جميلة، لكن بعد ذلك، تولّت عصبة من الماركسيّين الثقافيين، أو الليبراليين الجدد الفريدمانيّين (نسبة إلى ميلتون فريدمان)، زمام الأمور، ودمّروا كل شيء. لقد عشنا ذات يوم في تناغم هادئ مع الطبيعة، لكن بعد ذلك، أتت مناجم الفحم والمصانع والجرارات الميكانيكية والأسمدة الاصطناعية، واضطرب النظام الطبيعي بطريقةٍ وحشية. إن الاعتقاد المفعم بالحنين بأنّنا نستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بكل بساطة يعزّز الرغبة في حدوث انتفاضات ثورية؛ من تحطيم للمؤسسات وتفجير للاتفاقيات الدولية وإسقاط للنظام الاقتصادي. وأشارت استطلاعات الرأي الصادرة عام 2016 إلى أنّ أفضل مؤشر يتنبأ بتصويت لصالح دونالد ترامب كان نظرة متشائمة للعالم، فمن بين أولئك الذين اعتقدوا أن الحياة ستكون أسوأ للجيل القادم، صوّت 63% لترامب، بينما صوّت 31% لكلينتون.
المتشائم المتوعّد “انتظر فقط، وسترى” The “Just You Wait” Pessimist
على العكس من الذين يحنّون إلى الماضي؛ توجد مجموعة مستعدّة للاعتراف بأن العالم قد تحسن بشكل كبير على مدار القرنين الماضيين، لكنّهم يؤكدون أن هذا الأمر يستحيل أن يستمر. يجب، عاجلًا أم آجلًا، أن يعاقب الإنسان الحديث لغطرسته، ولإيمانه الساذج بالتقدّم. أسمّي هذا الأمر مدرسة التشاؤم المتوعّد “انتظر فقط، وسترى”. يبدو أنّ كل شي يسير بسلاسة حتى الآن، لكنّنا سنواجه عمّا قريب بعض العتبات الحرجة، وسنتردّى بعد ذلك بلا هوادة في الهاوية. غالبًا ما يعاني المتشائمون من هذه المدرسة مما أطلق عليه الكاتب مات ريدلي “التهاب نقطة التحول: turning-point-itis”؛ وهو الميل إلى الاعتقاد بأن التاريخ قد بلغ نقطة حاسمة صادف وأنّنا نعيش في منتصفها. يأتي متشائمو “انتظر فقط وسترى” في أشكال مختلفة، وعلى الرغم من أنّهم قد ينبثقون من نقاط متنوعة على الطيف الأيديولوجي، إلا أن لديهم الكثير من العوامل المشتركة.
ففي أوروبا اليوم، فإنّ أهم النبوءات التي تشغل الكوارثيّين catastrophists هي تهديد التغير المناخي والخوف من أن الهجرة الإسلامية تعمل على تحويل أوروبا إلى ” أوروبا عربية، أو يورابيا Eurabia”. الأمر المثير للاهتمام هو أنّ هذين الشكلين من الكوارثيّة، من وجهة نظر اجتماعية، يكادان يستبعدان بعضهما بعضا دائما: كلما اشتدّ إيمان شخصٍ ما بأحد الأمرين كلما قلّت احتمالية قلقه بشأن الأمر الآخر. يميل الشعبيّون populists اليمينيون الذين يضمرون هواجس قاتمة تنذر بالشؤم بشأن الهجرة الجماعية إلى أن يكونوا محصنين ضد المخاوف المتعلقة بتغير المناخ، إلى درجة أنّهم يشكّكون في حقيقته من الأساس، بالإضافة إلى سخريتهم من نشطاء المناخ ونعتهم بـ “الهستيريّين الخُضر green hysterics” و “المهوّلين alarmists”. في المقابل، غالبًا ما يكون أولئك المنذرين بالكوارث المناخية القادمة غير مبالين لمخاوف الأسلمة والهجرة، والتي تعد مرفوضة بالنسبة لهم باعتبارها لا تزيد عن كونها مجرد خيالات تآمُريّة من متعصبين يعانون من رهاب الأجانب.
يمكن للتشاؤم المتوعّد أن يؤدي إلى دفع أشخاص عاقلين إلى اتخاذ إجراءات تبدو عقلانية تمامًا من منظورهم، لكنها تسبب أضرارًا أكبر بكثير من المشكلات التي كانت تهدف إلى حلها. إذا كنت تعتقد أن العالم في طريقه لا محالة إلى الجحيم ما لم تتخذ إجراءً فوريًا وجذريًا، فسيكون لديك مبرّرٌ عقلاني لتدابير متطرفة، بل وغير إنسانية، لم تكن لتخطر على بالك البتة في ظروف عادية. يستطيع الأشرار فعل أمورٍ سيّئة، لكن عقلية كارثية ومنذرة بالشؤم تستطيع تشجيع حتى الأشخاص الخيّرين على فعل أمورٍ سيئة. في بيانه الرِّق التكنولوجي Technological Slavery، جادل تيد كازينسكي المعروف بلقب “مفجّر الجامعات والطائرات Unabomber” أن تدمير الحضارة التكنولوجية الحديثة سيكون كارثة بالتأكيد، لكنه سيظلّ أقل كارثية من نتائج استمرارها. وبالمثل، فإن أنبياء الهلاك الأوروبيين مثل السياسي اليميني الهولندي خيرت فيلدرز، ينادون الآن علانية بحظر المساجد وقمع الحكومة للمسلمين. والمنطق هو نفسه: يجب أن ننتهك بعض مبادئنا الليبرالية النبيلة الآن لمنع تدميرها المطلق في وقتٍ لاحق.
وفي هذا الصدد، يمكن فهم التشاؤم المتوعّد على أنّه مرآة عاكسة لتفكيرٍ طوباوي، إلا أنّ ما يلمع في الأفق ليس عالمًا مثاليًا، بل كارثةٌ مُضنية. يعد كلا النوعين من التفكير خطرين لنفس السبب، فهما يفترضان ضمنيا حِسبة نفعية حول مستقبل تعتبر فيه الرهانات والمخاطر مرتفعة للغاية. في عام 2018، نشر المؤرخ الألماني فيليب بلوم كتابًا بعنوان “ما الأمور التي على المحك؟ What is at Stake” وهو كتاب قاتم للغاية يتناول الكارثة المناخية الوشيكة. في الجملة الأخيرة من الكتاب، يقدم بلوم إجابته المكونة من كلمة واحدة على السؤال الموجود في العنوان: “ما الأمور التي على المحك؟ كل شيء.”
 من ناحية أخرى، يمكن للمخاطر اللانهائية التي يلمح إليها المتشائمون المتوعّدون أن ينتج عنها بكل سهولة تأثير عكسي للهدف المقصود: الشلل. إذا كان المجتمع في سباق نحو كارثة حقيقية ما لم نتّخذ تدابير فورية وجذرية تعد مستحيلة أو غير مقبولة أخلاقيًا، إذن لربّما علينا أن نستسلم لقدرنا المحتوم. ويردّد عالم الاجتماع الفرنسي برونو لاتور، وهو ناقد علمي سابق لما بعد الحداثة والذي وجد غايته الثانية في التخويف من آثار التغير المناخي climate alarmism، يردّد كثيرا هذه الملاحظة اليائسة في كتابه “إلى الأرض: انتهت الحرب، وقد خسرناها على الأغلب. Down to Earth: The war is over, and we have probably lost it.” إن كان هذا صحيحًا، فلنحرق إذن احتياطاتنا المتبقية من الوقود الأحفوري، ولنستغل وقتنا المتبقي أحسن استغلال. يمكن العثور على مواقف استسلامية وانهزامية مماثلة بين أنبياء أوروبا العربية، إذ يعتقد البعض منهم أن الآفاق الديموغرافية لأوروبا الغربية قاتمة لدرجة أنّ علينا تعليق آمالنا على بلدان الكتلة الشرقية السابقة باعتبارها آخر الحواجز المُتبقية ضد المد الإسلامي المتزايد.
من ناحية أخرى، يمكن للمخاطر اللانهائية التي يلمح إليها المتشائمون المتوعّدون أن ينتج عنها بكل سهولة تأثير عكسي للهدف المقصود: الشلل. إذا كان المجتمع في سباق نحو كارثة حقيقية ما لم نتّخذ تدابير فورية وجذرية تعد مستحيلة أو غير مقبولة أخلاقيًا، إذن لربّما علينا أن نستسلم لقدرنا المحتوم. ويردّد عالم الاجتماع الفرنسي برونو لاتور، وهو ناقد علمي سابق لما بعد الحداثة والذي وجد غايته الثانية في التخويف من آثار التغير المناخي climate alarmism، يردّد كثيرا هذه الملاحظة اليائسة في كتابه “إلى الأرض: انتهت الحرب، وقد خسرناها على الأغلب. Down to Earth: The war is over, and we have probably lost it.” إن كان هذا صحيحًا، فلنحرق إذن احتياطاتنا المتبقية من الوقود الأحفوري، ولنستغل وقتنا المتبقي أحسن استغلال. يمكن العثور على مواقف استسلامية وانهزامية مماثلة بين أنبياء أوروبا العربية، إذ يعتقد البعض منهم أن الآفاق الديموغرافية لأوروبا الغربية قاتمة لدرجة أنّ علينا تعليق آمالنا على بلدان الكتلة الشرقية السابقة باعتبارها آخر الحواجز المُتبقية ضد المد الإسلامي المتزايد.
المتشائم الدَّوري The Cyclical Pessimist
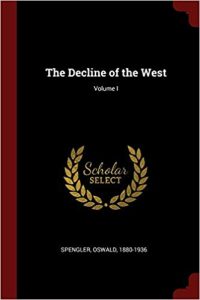 هذا النوع من المتشائمين سيتفق على أنّ الأمور تسير على ما يُرام في الوقت الراهن، لكنه لا يظن أن حظّنا الحالي يعتبر استثنائيا من الناحية التاريخية. لقد مرت البشرية بفترات من الرخاء والسلام النسبيين من قبل، لكنّها جميعا ما تصل إلى نهايتها، عاجلًا أم آجلًا. بالنسبة للمتشائم الدوري فإنّ مجرى التاريخ يأتي ويذهب كالمد والجزر أو كالفصول. فإذا بدا لنا أننا على خير ما يرام في الوقت الحالي، فالأمر مجرد ازدهار مؤقت؛ التدفق الذي يسبق الانحسار. كان النموذج الأوّلي للمتشائم الدوري هو المؤرخ الألماني أوزوالد شبنغلر. وفي كتابه الشهير “تدهور الحضارة الغربية The Decline of the West” الصادر عام 1918، وصف شبنغلر الحضارات بأنها كائنات حيّة تنمو وتصل إلى مرحلة البلوغ والشباب ومن ثمّ تذبل وتتلاشى، مثلها في ذلك مثل الحيوانات والنباتات. ووفقا لسبنغلر، فإنّ عمر الحضارة المتوسطة هو بضعة آلاف من السنين. وفي بداية القرن العشرين، كانت الحضارة الغربية تدخل فصل الشتاء خاصّتها، وهي المرحلة الأخيرة قبل انهيارها الحتمي.
هذا النوع من المتشائمين سيتفق على أنّ الأمور تسير على ما يُرام في الوقت الراهن، لكنه لا يظن أن حظّنا الحالي يعتبر استثنائيا من الناحية التاريخية. لقد مرت البشرية بفترات من الرخاء والسلام النسبيين من قبل، لكنّها جميعا ما تصل إلى نهايتها، عاجلًا أم آجلًا. بالنسبة للمتشائم الدوري فإنّ مجرى التاريخ يأتي ويذهب كالمد والجزر أو كالفصول. فإذا بدا لنا أننا على خير ما يرام في الوقت الحالي، فالأمر مجرد ازدهار مؤقت؛ التدفق الذي يسبق الانحسار. كان النموذج الأوّلي للمتشائم الدوري هو المؤرخ الألماني أوزوالد شبنغلر. وفي كتابه الشهير “تدهور الحضارة الغربية The Decline of the West” الصادر عام 1918، وصف شبنغلر الحضارات بأنها كائنات حيّة تنمو وتصل إلى مرحلة البلوغ والشباب ومن ثمّ تذبل وتتلاشى، مثلها في ذلك مثل الحيوانات والنباتات. ووفقا لسبنغلر، فإنّ عمر الحضارة المتوسطة هو بضعة آلاف من السنين. وفي بداية القرن العشرين، كانت الحضارة الغربية تدخل فصل الشتاء خاصّتها، وهي المرحلة الأخيرة قبل انهيارها الحتمي.
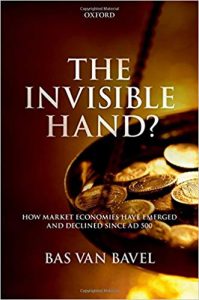 يمكن كذلك العثور على المتشائم الدوري في المجال الاقتصادي. ففي كتابه عام 2016 “اليد الخفية The Invisible Hand?”، يقول المؤرخ باس فان بافيل إن اقتصادات السوق ترتفع وتنخفض وفقًا لقوانين التاريخ الاقتصادي التي لا مفرّ منها. إنّ سرد فان بافل لصعود وسقوط العصور الذهبية المبكرة، من الخلافة العباسية في بغداد إلى العصر الذهبي الهولندي في القرن السابع عشر، يتوقّع بطبيعة الحال مستقبلًا مشؤومًا لنظامنا الاقتصادي الحالي كذلك. فتماما مثل جميع اقتصادات السوق المزدهرة التي كانت موجودة قبلًا، فإن اقتصادنا محكوم عليه بالهلاك بمجرد أن يُنهي مساره. وفي الواقع، ووفقا لفان بافيل، فإنّ أولى علامات الاضمحلال، مثل ارتفاع عدم المساواة وزيادة تركيز الثروة، أصبحت جليّة بالفعل.
يمكن كذلك العثور على المتشائم الدوري في المجال الاقتصادي. ففي كتابه عام 2016 “اليد الخفية The Invisible Hand?”، يقول المؤرخ باس فان بافيل إن اقتصادات السوق ترتفع وتنخفض وفقًا لقوانين التاريخ الاقتصادي التي لا مفرّ منها. إنّ سرد فان بافل لصعود وسقوط العصور الذهبية المبكرة، من الخلافة العباسية في بغداد إلى العصر الذهبي الهولندي في القرن السابع عشر، يتوقّع بطبيعة الحال مستقبلًا مشؤومًا لنظامنا الاقتصادي الحالي كذلك. فتماما مثل جميع اقتصادات السوق المزدهرة التي كانت موجودة قبلًا، فإن اقتصادنا محكوم عليه بالهلاك بمجرد أن يُنهي مساره. وفي الواقع، ووفقا لفان بافيل، فإنّ أولى علامات الاضمحلال، مثل ارتفاع عدم المساواة وزيادة تركيز الثروة، أصبحت جليّة بالفعل.
لكن فيما يتعلق بالازدهار المادّي أو مستويات السلام، فإنّه لا توجد فترة سابقة من فترات التاريخ تقترب حتى من المستويات التي نشهدها اليوم. على أية حال، وبالرغم من أننا لا نضمن استمرار التقدّم إلى الأبد، فإن الخطر الرئيسي للتفكير الدوري هو أنه يمكن أن ينحدر بسرعة إلى التفكير المتشائم الساخر cynical: إذا كان من المقدّر لكل هذه الرسوم البيانية الصّاعدة أن تنهار نحو الأسفل عاجلًا أم آجلًا، فلا جدوى إذن من محاولة تجنّب المحتوم.
متشائم الحلقة المُفرغة The treadmill pessimist
يتقبّل متشائم الحلقة المُفرغة حقيقة بعض المقاييس الموضوعية للتقدّم (ثروةٌ أكثر، وعنفٌ أقل، وحياة أطول وأكثر صحّة) لكنه يؤكد أنّه بالرغم من كل شيء، إلا أنّنا لم نحقق تقدّما فعليا في الجوانب المهمة حقا. فمثل أليس والملكة الحمراء في “أليس في بلاد المرآة”، فإنّنا نعمل جاهدين دون كلل أو ملل، فقط لنكتشف، عندما نتوقف لبرهة وننظر للوراء، أنّنا لا نزال في ذات المكان الذي بدأنا منه. ولعلّ أشهر مثال على تفكير الحلقة المُفرغة هو مفارقة إيسترلين Easterlin paradox التي سميت على اسم الخبير الاقتصادي ريتشارد إيسترلين. خلال السبعينات، وجد إيسترلين أن الناس في الدول الغنية لا يبدون أكثر سعادة من الناس في الدول الفقيرة، في حين ظلّت مستويات السعادة المُبلَّغ عنها في المجتمعات الغربية ثابتة إلى حدٍّ ما لعقودٍ من الزمن. إن صحّ ذلك، فهذا يعني أن كل جهودنا لتحسين الحياة البائسة للغالبية العظمى من البشر كانت بلا جدوى. لكن الحقيقة هي أنّنا نعلم الآن أن إيسترلين كان مخطئا في (معظم) الأمر، إذ أظهرت مجموعة كبيرة من الدراسات اللاحقة التي اُجريت على مجموعات بيانات أكثر ثراءً وباستخدام قياساتٍ أفضل أنّ الأشخاص في البلدان الغنية هم في الحقيقة أسعد من أولئك الذين في البلدان الفقيرة، وأن الناس في الدول الصناعية أصبحوا أكثر سعادة مع مرور الوقت.
هنالك مجال آخر يزخر بتشاؤم الحلقة المفرغة، ألا وهو مجال حركات العدالة الاجتماعية. غالبا ما تُرفض الادّعاءات المتعلّقة بالتقدّم الأخلاقي في الأوساط الناشطة، وذلك باعتبارها انتصارًا سطحيًا يهدف إلى ترسيخ الامتيازات والقمع، وإلى الحفاظ على الوضع الراهن. إنّ ما يساعد على بقاء هذا التشكك الأخلاقي في معظم الأحيان هو التوسّع المُمنهج في تعريف مشكلةٍ مُعيّنة (كالعنصريّة أو التمييز الجندري)، أو الاتفاق مع نوعٍ من “نظرية استبدال” للشر؛ والمتمثلة في الاعتقاد بأنّه إذا اختفى أحد مظاهر الشر، فسوف يُستبدل بمظهرٍ آخر مساوٍ له في الضرر. سوف يقرّون مثلًا أن العنصرية الصريحة والعلنية في تراجعٍ بالفعل، ولكنّها استُبدلت حاليًا بالعنصرية الضّمنية او المُؤسّساتية أو الخفيّة. بل إنّ البعض منهم قد صاغ مصطلح “العنصرية الثقافية”، والذي من المفترض أنه يعبّر عن كراهية الثقافات الأجنبية بدلا من خصائص الشخص التي لا يمكن تغييرها. يؤدي مثل هذا التفكير إلى ما أسمّيه قانون الحفاظ على الغضب: بغضّ النظر عن مقدار التقدّم الذي يحرزه مجتمعنا؛ يبقى مقدار الغضب الأخلاقي كما هو على الدوام.
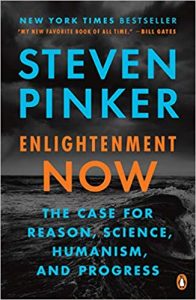 وتمامًا مثل النوع الدوري؛ يمكن أن يؤدي تشاؤم الحلقة المفرغة إلى تقويض دافعنا لخلق عالمٍ أفضل. إذا اقتنعنا أن أحد الشرور (العنصرية، القمع، العنف) سيُستبدل دائمًا بآخر، أو لا مناص من ظهوره على السطح من جديد في هيئةٍ أخرى، فقد نتخلى عن محاولة معالجته. سوف يوحي هذا الأمر، كما ذكر ستيفن بينكر في كتابه “التنوير الآن Enlightenment Now”، أنّ التقدّميّة مضيعةٌ للوقت، كوننا لم نحقّق شيئا بعد عقودٍ من الكفاح.” وتعتبر الانهزاميّة كذلك نتيجة طبيعية ومُلازمة للإيمان بمفارقة إيسترلين: إذا لم تجعلنا كل هذه الثروة أكثر سعادة، فمن غير المنطقي أن ندعم التنمية والنمو الاقتصاديين في البلدان الأكثر فقراً، وأن نخلق عالمًا يستطيع الجميع فيه الاستمتاع بمستوى الرخاء الذي نملكه. فليبقَ الناسُ إذن فقراء و(غير) سعداء بدلًا من أن يكونوا أغنياء و(غير) سعداء (وهو أمر، بالمناسبة، سيكون أفضل بالنسبة لكوكب الأرض أيضا).
وتمامًا مثل النوع الدوري؛ يمكن أن يؤدي تشاؤم الحلقة المفرغة إلى تقويض دافعنا لخلق عالمٍ أفضل. إذا اقتنعنا أن أحد الشرور (العنصرية، القمع، العنف) سيُستبدل دائمًا بآخر، أو لا مناص من ظهوره على السطح من جديد في هيئةٍ أخرى، فقد نتخلى عن محاولة معالجته. سوف يوحي هذا الأمر، كما ذكر ستيفن بينكر في كتابه “التنوير الآن Enlightenment Now”، أنّ التقدّميّة مضيعةٌ للوقت، كوننا لم نحقّق شيئا بعد عقودٍ من الكفاح.” وتعتبر الانهزاميّة كذلك نتيجة طبيعية ومُلازمة للإيمان بمفارقة إيسترلين: إذا لم تجعلنا كل هذه الثروة أكثر سعادة، فمن غير المنطقي أن ندعم التنمية والنمو الاقتصاديين في البلدان الأكثر فقراً، وأن نخلق عالمًا يستطيع الجميع فيه الاستمتاع بمستوى الرخاء الذي نملكه. فليبقَ الناسُ إذن فقراء و(غير) سعداء بدلًا من أن يكونوا أغنياء و(غير) سعداء (وهو أمر، بالمناسبة، سيكون أفضل بالنسبة لكوكب الأرض أيضا).
إنّ مفهوم التقدّم نفسه -أي التحسين المستمرّ للحالة الإنسانية من خلال تطبيق العلم ونشر الحرية- قد أتى نتيجةً للتنوير الأوروبي كما يذكّرنا كيشور محبوباني. كان أولئك المفكّرين من بين أوائل الأشخاص الذين عزّزوا فكرة أن المشاكل الإنسانية قابلة للحل، وأنّنا لسنا مُدانون بالبؤس وسوء الحظ. لم يكن التقدم المذهل الذي أعقب ذلك، أولاً بالنسبة للغرب ثم بعد ذلك للبقية على نحوٍ متزايد، نتيجة ضرورةٍ تاريخيّة، بل كان مجهودًا وكفاحًا إنسانيّين. لا يعتبر التشاؤم خاطئًا من الناحية الواقعية فحسب، بل إنّ أضراره وخيمة كونه يقوّض ثقتنا في قدرتنا على إحراز المزيد من التقدّم. إنّ أفضل بُرهانٍ على إمكانية التقدّم هو أنّه قد تحقّق في الماضي.
نحن لا نعيش في “أفضل العوالم الممكنة” بالطبع كما كانت تعتقد شخصية فولتير “الدكتور بانجلوس”، ولكن قد يكون الأمر أنّنا نعيش في أفضل العوالم المتاحة حتى اللحظة. إذا أردنا إنشاء عالمٍ أفضل، وبالتالي إثبات أن الدكتور بانجلوس مخطئ مرة أخرى، فإن الأساليب العلمية، والأسواق الحرة، والديموقراطية الليبرالية توفر لنا أفضل فرصة وأمل في النجاح. متى سيستعيد الغربيّون إيمانهم بالتقدّم؟
______________
مارتن بودري: هو فيلسوف علمي يتخذ من غنت، بلجيكا، مقرًا له، وقد درس في فيينا وبوسطن ونيويورك. صدر أحدث كتبه بعنوان: “علمٌ مطلق؟ تحدّيات العلمويّة”، والذي شارك في تحريره الفيلسوف ماسيمو بيليوتشي Massimo Pigliucci. نشر بودري حوالي 40 ورقة علمية حول لا منطقيّة الإنسان والعلوم الزائفة والإيمان بخوارق الطبيعة والتطوّر الثقافي. صدر له كذلك 3 كتب شهيرة باللغة الهولندية يتناول أحدثها تشاؤمًا عصريّا. يمكنك متابعة حسابه على تويتر: @mboudry
إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...
رأى الطيار كينيث أرنولد، في 24 يونيو 1947م، تسعة أجسام هلالية الشكل تحلق بالقرب من جبل رينييه في ولاية...
ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...
يدعونا جون بول سارتر في رائعته «الكينونة والعدم» -التي كُتبت خلال الاحتلال النّازيّ لفرنسا- إلى تخيّل مشهدٍ من الحياة اليوميّة:...
«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.