الأملُ ليس تفاؤلًا | ديفيد فيلدمان – بنيامين كورن
ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...
سُلطة المعطف الأبيض .. مدخل قصصي
٦ دقائق ..
كانت ورقة «تاريخ الحالة المرضية» المُعلَّقة على طرف السرير الطبي تقول: «إنها فتاة تبلغ من العمر ٨ سنوات ..»، لكنها في الواقع بَدت أكبر من ذلك. عندما اقتربت منها وسألتها عن اسمها، لم تجبني؛ وعندما طلبت الإذن لفحصها، تجاهلتني تمامًا. حينها شعرت بوجود خطب ما في المريضة الصغيرة، فقد كانت مُستلقية على السرير بسكونٍ يحمل في صمته تمَرُّدًا مُرعِبًا.
إنها ظهيرة يوم الامتحان النهائي لمادة طب الأطفال، وفي تلك اللحظة، عَقَدَت الفتاة العزم على تجاهل كل شيء ومقاومته، لأنها لم تعد ترغب بالمشاركة في مُحاكاة الفحص السريري.
٥ دقائق ..
كان سكون غرفة الامتحان مُوحِشًا ومُربِكًا، لدرجة توَهُّمي سَمَاع دقات عقارب ساعةٍ مُتَخيّلة. أعدت طرح سؤالي بصياغةٍ تشجيعيّة، لكن المريضة الصغيرة أصرَّت على موقفها التمَرُّدي الصامت. التفتُ إلى الاستشاري المسؤول عن تقييم درجاتنا، باحِثًا في ملامح وجهه عن أي إشارةٍ توضح ما يجري مع الفتاة، لكن وجهه كان خاليًا من التعابير، كما لو أنه مجرد آلة بيروقراطية وضعها القسم لرصد أداء الطَلَبة في الامتحان. رفع الاستشاري عينيه عن ورقة التقييم بعدما سَجَّلَ فيها ما سَجّل، ونطق بنبرةٍ مُثَقلةٍ بالضجر: «الوقت يمضي، عليك البدء الآن». عدت بنظري إلى الفتاة مُتفحِّصًا سكونها، قبل اعتراضي على ذلك الموقف الحرج: «أولًا .. »، التفتُ إلى الاستشاري وأكملت: «علي التأكد بأنها على ما يُرام».
لم تكن الدقائق السِت تُشكِّل الوقت الذي يقضيه الطالب في كل غرفة فقط، بل هي أساس حركة وتناقل الطَلَبة بين غرف الامتحان بأكمله. فهناك سبع محطاتٍ للتقييم موزعة على سبع غرفٍ مختلفة على امتداد رواق قسم طب الأطفال. أي إنه من المستحيل الحصول على ثانية إضافية بعد انتهاء الوقت المخصص؛ لأن هذا يعني عرقلة سير الامتحان وتداخل الطَلَبة في الغرف. وبصياغةٍ أخرى، كان مستقبلي الأكاديمي مَرهونًا بما تبقى لي من وقت.
٤ دقائق ..
عندما سمعتنا الطبيبة المسؤولة عن تنظيم حركة الامتحان من الرواق، وَقَفَتْ أمام مدخل الغرفة، وألقتْ نظرة خاطفة على الفتاة، قبل تَدَخُّلِها لمحاولة إصلاح الموقف. أدَّت حركة خطواتها المُتسارِعة باتجاه السرير الطبي إلى تصادم الدبابيس المُلوَّنة التي تزيَّن بها معطفها الأبيض. انحَنَت فوق السرير و وَضَعَت يدها برِقّة على كتف الفتاة ثم خاطبتها بحسٍّ تفاوضي: «لقد أوشكنا على الانتهاء يا حلوة .. لم يتبق الكثير من الطَلَبة». حينها استوعَبْتُ سبب تمَرُّد المريضة الصغيرة؛ نَظَرْتُ إلى طاولة الاستشاري في الطرف الآخر من الغرفة، ووَجَدْتُ أوراق التقييم مُكدَّسَة، فقد سَبَقَني في هذه المحطة ما يُقارب الثلاثين طالبًا، وهناك المزيد!
لم تنطق الفتاة بشيء، لكن لغة جسدها عبَّرَت عن رفضها القاطِع؛ رأيت ذلك في عيني الطبيبة التي شَعَرَت بثِقل المأزق الذي نحن بصدده. استَدَارَت نحو الاستشاري ثم اقترَحَت بصفتها المسؤولة عن تنظيم الحركة والوقت: «أعتقد أنه من الأفضل للجميع .. » لكنه قطع كلامها بنبرةٍ مُفرَّغةٍ من أي تَفهُّمٍ لتعقيدات الموقف: «تنحِ جانبًا من فضلك، على الطبيب بدء الفحص الآن لو أراد اجتياز الامتحان».
٣ دقائق ..
حين ننظر إلى المريض بقصد مُعاينته طبيًا، تلتقط أعيننا كل تفاصيل الجسد لترجمة ما يُحاول قوله أثناء اعتلاله. أتذكر جيدًا تلك التفاصيل على جسد المريضة الصغيرة: الذراعان المتقاطعان في منتصف الصدر، العضلات المشدودة لحد الرجفة، الأنفاس السريعة والعميقة. من منظوري، بَدَا لي ما يقوله ذلك الجسد النحيل واضِحًا؛ فبالرغم من تمَرُّدها وإصرارها على المقاومة، كانت الفتاة مُتخوِّفة من تبعات ما فعلَته، خصوصًا بعدما أظهر الاستشاري انعدام تَفَهُّمِه لموقِفها. أي إنها لم تكن مُتخوِّفة مني، بل مُتخِّوفة مما أمثله.
إنها مريضة في مؤسسة أكاديمية-طبية شَكَّلَت طَلَبتها على أساس تقديس الدرجة أكثر من خصوصيات المرضى. إنها تعلم ذلك، لأنها سبق ورَأت – مثلما رأى الجميع هنا – اللَمَعان في أعين الأطباء الصغار حين يكتشفون العَرَض النادر في جسد المريض، وسَمَعَت نبرة الدهشة حين ينطقون المصطلحات الطبية في أحاديثهم غير المفهومة؛ كل هذا أمام مَرأى و مَسمع مَن يُكابدون المرض ويُصارعون قلقه الوجودي وهم طرحى الفراش. فماذا تتوقع الفتاة من هؤلاء الطَلَبة حين يأمرهم الاستشاري بفحصها لتجاوز الامتحان؟ هذا – في اعتقادي – هو سبب تَخَوُّفها في تلك اللحظة؛ تواجدها وسط نظام بيروقراطي مُهَمِّش للقيمة الإنسانية في طبيعة التواصل بين الطبيب والمريض.
تَصَارَعَتْ الأفكار داخل رأسي حتى تَجَمّدْتُ في مكاني بالقرب من السرير. كان علي اتخاذ قرار عاجل؛ إما الاستجابة لأمر الاستشاري، أو رغبة المريضة؛ إما الخضوع للمنظومة، أو التصادم معها. التفتُ إلى الفتاة مُجددًا على أمل نطقها بأي كلمةٍ توضح لي ما علي فعله، لكن صمتها المطبق وضح لي أمرًا آخر؛ كان صوتها مَسلوبًا في تلك الغرفة، أي إن الامتحان لم يقم بتشييء جسدها ليُصبح أداةً لتقييم الطَلَبة فقط، بل دفعها إلى التماهي مع بقية الأدوات الطبية حتى تحولت إلى جَمادٍ بلا صوت. هذا الاستيعاب الصادم، حثني على التفكير بالموقف من زاويةٍ مختلفة؛ لا يمكننا كأطباء الاعتماد على «الموافقة الضمنية» في مثل هذه المواقف الشائكة؛ لأن دلالات الخوف والتوتر تُلغي صلاحية ما هو ضمني فيما يتعلق بخصوصية الجسد، بحيث تضعنا أمام عدة تأويلات لمعنى الصمت (هل صمت الفتاة هنا يُعبّر عن موافقتها الضمنية أم خوفها من تبعات الرفض؟).
هذه ليست «مُراوغة ثقافية» لمحاولة تبرير موقفي، وإنما هي «ضرورة أخلاقية» تقوم عليها حقوق المرضى ويجب علينا الالتزام بها؛ وعلى هذا الأساس، اتخذتُ قراري؛ تراجعت خطوة إلى الوراء، ثم أخبرت الاستشاري: «لا أستطيع فحص المريضة في هذا الوضع من دون موافقتها الشخصية».
دقيقتان ..
عاد شبح الصمت ليختلس أصواتنا فجأة، مُصَعِّدًا من حِدَّة التوتر المتَجَلِّ في لغة أجسادنا. لم يَتَبَقَّ لي الكثير من الوقت في تلك المحطة المشؤومة، لكني شعَرْت بفتيل المواجهة قد أُشعِلَ حينها.
كَسَرَتْ الطبيبة هيمنة الصمت اللحظيّة أولًا؛ انحَنَتْ فوق السرير، وأكملت مفاوضاتها مع المريضة لمنع تكرار الحادثة مع الطالب التالي؛ في حين أخذ الاستشاري يُفرِّغ غضبه على ورقة التقييم الخاصة بي، قبل رميها بانزعاجٍ فوق بقية الأوراق المكدَّسة على الطاولة. كنت أعي تَبِعات قراري تجاه الانحياز لموقف المريضة، لكن ما عجزت عن استيعابه هو غضب الاستشاري من هذا القرار! فقد كان غضبه مؤشِرًا لاحتمالية حصولي على تقييمٍ غير عادل؛ لأن عين الغضب غالبًا ما يغشاها الضباب، فلا يمكنها رؤية تعقيدات الموقف الاستثنائية.
اقتربتُ من الاستشاري وأخبرته باستعدادي التام لخوض الاختبار شفهيًا، وشرح ما كنت سأقوم به كلمة بكلمة دون الحاجة لمحاكاة ذلك على جسد المريضة، فكل ما أردته هو الحد الأدنى لتجاوز الامتحان لا العلامة الكاملة. لكنه هز رأسه وقال لي كاشِفًا شخصنته للموقف: «عندما أمرتك بفحص المريضة .. لماذا عصيتني؟».
لم أرغب بالمحاججة كي لا استنزف ما تَبَقَّ لي من وقت، فأجبته باختصارٍ لا يخلو من الارتباك: «إنه موقفٌ مُعَقَّد، لأن فحص المريضة أثناء مقاومتها قد يتطلب استخدامًا للقوة .. جَسَديّة أو مَعنويّة؛ لا يمكنني فعل ذلك، لا يمكنني التسبب في إيذاء أحد».
قَطَّبَ الاستشاري حاجبيه واستمر في شخصنته بتحويره لمقصدي: «هل تعتقد بأني أريد إيذاءها؟!».
بذلت قصارى جهدي للحفاظ على هدوء نبرتي: «لا، لم أقل ذلك .. ».
لكنه قَطَعَ كلامي عائِدًا بالحديث ليتمحور حول سُلطته: «ألا تعي بترتيب السُّلطة في هذا المكان؟! أنا أعلى منك رُتبةً هنا، مما يجعل الأمر الذي وجَّهته لك أمرًا قياديًا وجب عليك تنفيذه. أنت لم تحمِ هذه الفتاة، بل عَرَّضتها للخطر؛ لأنه في نهاية المطاف .. أنا أعلم منك بمصلحتها».
اعترضتُ بانزعاجٍ متوارٍ خلف رباطة جأشي: «لكن المريضة .. ».
هنا انفجر الاستشاري قائِلًا: «إنها مجرد طفلة». صَمَتَ للحظة مُرتِبًا أفكاره، ثم أكمل: «لو توقفنا عن العمل كلما اعترض طفل، لما عَالَجْنا أحد! عليك استيعاب هذا الشيء؛ لأنك على وشك أن تصبح طبيبًا. هذا المعطف الذي ترتديه يُحمِّلك مسؤولية اتخاذ قراراتٍ كهذه؛ فالأطفال لا يعرفون مصلحتهم».
دقيقة واحدة ..
كان وَقع هذه الجملة أثرًا بَليغًا تَمَكَّنَ من إيقاف إحساسي بالزمن؛ لم أعد أسمع صوت دقات عقارب الساعة. شعرت كما لو أن الاستشاري كان يتحدث من واقعٍ مختلف غير الذي ننتمي إليه أنا والمريضة الصغيرة. إن انغماسه الكُلّي في سيناريو المحاكاة، مُتَشَرِّبًا المنطق البيروقراطي للتقييم الأكاديمي الصارم، نَزَعَ عنه إمكانية رؤية الواقع من منظور الفتاة: الساعات الطويلة على سرير الفحص في غرفة الامتحان، وأوامر الطَلَبة لها بالنهوض والاستِلقاء، بالشهيق والزفير، بفعل كل ما لم ترغب بفعله ذلك الصباح. كان هذا واقعها الذي عَجَزَ الاستشاري عن رؤيته؛ لأنها بالنسبة له هي مجرد طفلة لا تعرف مصلحتها، حتى في المحاكاة التَخَيُّليّة حيث لا وجود لأيّ من المخاطر التي تحدث عنها!
استمر في كشف الأبعاد الخفيّة للخَلَل المتأصِّل في منظومة العمل الطبي: «والأمر لا ينحصر على الأطفال فقط، فالمرضى النفسيون لا يعرفون مصلحتهم كذلك؛ هل ستسأل المكتئبة التي تهدد بإيذاء أبنائها إن كانت تود قضاء ليلة في جناح الصحة النفسية؟ وتدعها تغادر إن رفضت التنويم! علينا حماية هؤلاء المرضى من أنفسهم، هذا هو عملنا، والذي يبدو لي أنك لم تستوعب طبيعته بعد. لذا، عليك تحمل تبعات قراراتك إلى ذلك الحين». ثم رفع سبابته وأكمل بنبرةٍ مُتعالية: «وعليك أن تحمد الله بأني لم أكتب عن محاولتك للتهرب من الامتحان مُتَعَذِّرًا برفض المريضة».
تساقطتْ لَبنات واجهة هدوئي، واحدة تلو الأخرى، مُظهِرةً شعوري الحقيقي تجاه مهزلة هذا الموقف. فالاستشاري لم يكتفِ بتجاهل حالة الفتاة وتعقيدات وضعي في الامتحان، بل تجاوز ذلك ليضع نفسه في موقعٍ مُتعالٍ ويخاطبني بأسلوب مَن تَفَضَّلَ علي بطيبه وكرمه؛ إنه مشهد ساخر للبيروقراطية تحت تأثير المنشطات! فقد تَيَقَّنتُ حينها من خسارتي هذه اللعبة الاعتِباطيّة التي كانت تطالبني بتجاوز حق المريضة من أجل تقييماتٍ مُسجَّلة على ورق. لكن كان هناك مُتسع من الوقت لمواجهة أخيرة، لمحاولة قلب الطاولة واختبار قوة المنطق الذي يحكم الموقف.
اكتست نبرة صوتي حِدّةً اندِفاعيّة نطقت بها: «كيف حكمت بأني أحاول التهرب من الامتحان وقد أخبرتك باستعدادي لخوضه بأي طريقةٍ كانت؟».
قال بلا مبالاة: «هناك طريقة واحدة لخوض هذا الامتحان».
فسألته بتحدٍ: «بالنظر إلى حال المريضة، كيف كانت ستجري الأمور بتلك الطريقة؟».
أجاب بحَنقٍ مُتجاهِلًا لب السؤال: «نحن أطباء، ما نفعله لا يؤذي المرضى! لهذا السبب كان عليك اتباع الأمر الذي وجهته لك، لكنك قررت التهرب منه».
نظرتُ إلى الاستشاري ونطقت بالكلمات التي غيرت مسار حياتي للأبد، أخبرته بثقةٍ مُستَمَدَّة من صميم كل ما أؤمن به: «لم أتبع الأمر الذي وجهته لي .. لأنه كان غير أخلاقي».
اللحظات الأخيرة ..
ما حصل بعد ذلك كان غريبًا وصادمًا للغاية، علي التأكيد هنا بأنه حقيقي وغير مُتخيَّل.
خَرَجَ الاستشاري من غرفة الامتحان غاضبًا وهو يصرخ في الرواق مُطالبًا بحضور رئيس القسم؛ كان يصرخ بأعلى صوته لأن هناك «طالبًا يحاول التهرب» وعليهم تأديبه! وبسرعةٍ قياسية، عاد إلى الغرفة مع مجموعة من مُنظميّ الامتحان، ثم أخذ يحكي لهم روايته لما حدث. كطالبٍ تحت التقييم، لم تكن لدي أي سُلطة لإقناع أحد بحقيقة الموقف؛ والفتاة لم تكن في وضعٍ أفضل مني، لأنها -كما سبق وقلنا – هي مجرد طفلة بالنسبة لهم. فمَن سيُصدقنا؟
كان أملنا الوحيد يقع على عاتق الطبيبة المتواجدة في الغرفة معظم الوقت، والتي رأيتها في نفس موقع الحيرة التي اجتاحتني قبل دقائقٍ معدودة؛ هل ستخضع للمنظومة وتتجاهل الموقف كما لو أنها لم ترَ شيئًا؟ أم ستتصادم معها وتقول الحقيقة المنافية لرواية الاستشاري؟
سَحَبَت الطبيبة هاتفها من جيب معطفها، لتفتحه على مؤقت الدقائق السِت الذي أخذ يقترب أكثر فأكثر إلى الصفر؛ إن مسؤوليتها التنظيمية تحتم عليها الخروج من الغرفة كي تعلن للطَلَبة انتهاء الوقت وتطالبهم بالانتقال إلى المحطة التالية. لا أستطيع التكهن بما كان يدور في رأسها تلك اللحظة، لكن ترددها تَجَلّى لنا في جمودها بالقرب من المريضة. ومع دخولنا مرحلة العد التنازلي، اتخذتْ قرارها النهائي بالتوجه إلى باب الغرفة بنفس السرعة التي دخلت بها، ثم وقفت في منتصف الرواق مُحَدِّقةً في تناقص الثواني الأخيرة على الشاشة، قبل إعلانها للجميع ..
«انتهى الوقت»
ومن بين صمت المريضة على السرير، واختفاء الطبيبة في الرواق، وجدتُ نفسي وحيدًا تحت أنظار منظومة مؤسساتية حَكَمَت علي بتهمةٍ لم ارتكبها.
كيف يمكننا فهم هذه الحادثة وتحليلها من منظور مهني-أخلاقي؟ وهل سيُساعدنا هذا الفهم في تقديم رعاية أفضل للفئات المستضعفة في المجتمع؟
لننطلق في رحلة تقصّي إجابات هذه الأسئلة بمحاولة تفكيك الصورة الذهنية للأطباء باعتبارهم «ملائكة الرحمة»؛ لأنها العقبة الأولى التي تعيق إمكانية استيعاب واقع الممارسات الطبية ومحاولات إصلاحها.
الضرورة الأخلاقية لأنسنة الأطباء
بالرغم من بداهة ما نحاول قوله هنا (الأطباء هم بشر غير مُنزّهين عن الخطأ)، إلا إنه يمكننا استشعار المخاطرة في فعل ذلك. والسبب يعود بشكلٍ أساسي في كون محاولة إنزال الطبيب من مقامه الملائكي، قد يفهمها بعض الناس على أنها شيطنة غير مباشرة؛ وهذا غير صحيح! لا وجود للملائكة أو الشياطين في أروقة المستشفيات، هناك فقط أشخاص يعملون بلا توقف لساعاتٍ وساعات؛ منهم مَن يُحسن للمرضى، ومنهم مَن يُسيء لهم؛ منهم مَن يُخطئ ويعتذر، ومنهم مَن يُخطئ ويكابر. هذه الحقيقة، على مرارتها، تفتح لنا باب النقد الأخلاقي لمحاولة الحد من الأسباب المؤدية إلى تجاوزات الممارسة الطبية.
فماذا يعني كون الطبيب إنسانًا؟ يعني أحقيته بامتِلاك مصالحٍ خاصة، وطموحاتٍ يسعى لتحقيقها، دون أن يعيبه ذلك. يعني استيقاظه كل صباح، مُذكِّرًا نفسه بهدف حصوله على جائزة «طبيب العام»، دون أن يعيبه ذلك أيضًا. هذا لأنه في عالمٍ أكثر عدالة من عالمنا، حيث يُعامَل المريض كإنسانٍ مساوٍ لطبيبه (مُستحِقًّا لوقته وتركيزه واهتمامه)، تكون علاقتهم مُتناغمة وغايتهم واحدة. لن تجد تعارُضًا بين رغبة الطبيب بالإنجاز المهني، وحاجة المريض إلى التشافي؛ لأنهما يصبان في المصلحة ذاتها. في هذا العالم المُتخيَّل، يكفي الطبيب أن يكون إنسانًا ليتشارك أولوياته مع مرضاه.
لكن في عالمنا الواقعي، حيث يُعامَل المريض كمجرد رقم في قاعة الانتظار، ومجرد حالة على قائمة المرضى، يُصبح التناغم مُستحيلًا، وتشارك الأولويات غير ممكن! فقد نجحت المنظومة البيروقراطية في خلق بيئة قادرة على توليد تعارض معقد بين مصالح أطراف العلاقة الطبية (المريض والطبيب والإداري).
فكيف أصبحت مساعي هؤلاء الأشخاص تخدم مصالح مختلفة قد تكون مُتضادة في بعض الأحيان؟
البيروقراطية وصناعة الطبيب الآلي
إنّ العقلية التنظيمية للفكر البيروقراطي وُجِدَت لخدمة المؤسسة أولًا، لا المستفيدين من خدماتها؛ بمعنى، إن هذه المنظومة البيروقراطية التي هي محور حديثنا في المقالة، هدفها الأساسي هو رفع كفاءة أداء المستشفى حَسَبَ معاييرٍ متنوعة (ليست محصورة بالطبية فقط). أي إن «جودة الخدمة» هي ليست المعيار الوحيد الذي سيُحدد مَن الفائز بجائزة «طبيب العام».
فهل سبق لك زيارة طبيب قضى معظم وقته يُحدق في شاشة جهازه، ثم وصف لك دواءً دون شرح وافي لما تعاني منه أو تفاصيل الخطة العلاجية؟ أكاد أجزم بأنها حصلت لمعظمنا. لنُقيِّم خدمة هذا الطبيب اعتِباطًا بأنها «متواضعة»؛ قد نتساءل الآن، كيف يمكن له الطموح بجائزة «طبيب العام» مع هذه الخدمة؟ لكن بمجرد خروجنا من العيادة، ورؤيتنا لعدد المرضى في غرفة الانتظار، سنستوعب أن خدمته المتواضعة والمقتضبة، هي الطريقة الوحيدة التي تُمَكِّنه من مقابلة هذا الكم الهائل من الناس في مناوبته التي تجاوزت ٢٤ ساعة!
بل إنه من منظور المؤسسة (ذلك الكيان الإداري الذي يخشى هدر المال والوقت أكثر من تبلد مشاعر العاملين فيه)، يُعتبر هذا عملًا إعجازيًا يستحق كل الاحتفاء بالطبيب الذي يحرق نفسه بصمت. يمكننا القول إذن، إن طبيعة العمل في المنظومة البيروقراطية تنخر في الجانب الإنساني لممارسة الطب؛ إنها تدفع الأطباء ليتحولوا إلى أجهزةٍ آلية تتعامل مع معاناة المريض كـ«مجموعة أعراض» مُفرَّغة من القيمة أو المعنى.
كل هذا يحصل تحت الغطاء الأكاديمي لما يُعرف بـ «الطب المبني على البراهين» وأسلوب تدريسه في الكليات الطبية. فلا تخفى على أحد أهمية نتائج الدراسات للوصول إلى التشخيص السليم وتحديد الخطة العلاجية المناسبة؛ لكن ما نخشاه في هذا الصدد هو التسليم المُطلق لمنهجيتها النازعة إلى اختزال المرض في قِيَمه الملموسة فقط. فماذا عن مشاعرنا ومخاوفنا وتمنياتنا؟ قد لا تكون لمثل هذه الأمور ذات أهمية على المستوى التشخيصي والعلاجي، لكنها في غاية الأهمية على المستوى الإنساني. إن المنهجية الأكاديمية وَرَّثَت الأطباء جُمودها ولغتها ونظرتها الاختزالية، حتى أصبحوا يُقدِّمون ما تقوله الشاشة على ما يقوله الإنسان (١).
هنا علينا أن نسأل: كيف ستؤثر هذه الممارسة الآلية على علاقة الأطباء بالمرضى؟
الحرب الباردة على جبهة الملفات الطبية
عندما نتحدث عن نجاح الخطة العلاجية، يجب علينا ألا نغفل عن أهمية الجانب التواصلي؛ فمن الضروري أن يعي المريض طبيعة عِلته، فيُجيبه الطبيب عن تساؤلاته، ويُزيل شكوكه، ويُخبره عن تفاصيل دوائه، ليعرف أجوبة «متى؟» و «كيف؟» و«ماذا لو؟». هذا الجانب التواصلي المتأصل في علاقاتنا الإنسانية، سيتضرر من تأثيرات العمل البيروقراطي لا محالة.
فماذا نتوقع من المريض الذي خرج من عيادة طبيبه بنفس التساؤلات التي دخل بها؟ وفي حال فشل خطتهم العلاجية، مَن المسؤول عن فشلها؟ عند محاولة الإجابة على هذه الأسئلة، سنجد المنظومة تلعب دورًا أساسيًا في تعميق الانشقاق بين الأطباء والمرضى، بحيث تدفع أصحاب المعاطف البيضاء إلى التوجس من المسؤولية، واستخدام سُلطتهم للتخلُّص منها. هذه ليست مؤامرة تحدث في الخفاء، بل هي واقع الممارسة اليومية للطب، فقد شهدتها بنفسي عشرات المرات أثناء عملي في مختلف المستشفيات.
«عليك حماية نفسك أولًا .. »، هكذا بدأ أحد الاستشاريين نصيحته لي بعد خروج مريضه من العيادة، «حين لا يلتزم المريض بالخطة العلاجية، عليك توثيق ذلك في ملفه»، ثم أشار إلى الملف الطبي وأكمل: «لأن ما تكتبه هنا هو دليل قيامك بعملك. فما قد يحدث مُستقبلًا، ليس مسؤوليتك بعد الآن». للوهلة الأولى، ستبدو لنا النصيحة منطقية، لكن بمجرد ما نضعها في سياق الزيارة كما شهدتها، ستتكشف لنا بشاعتها الحقيقية. لقد كان الاستشاري أجنبيًا لا يُجيد العربية، والمريض مُسِنّ لا يتحدث الإنجليزية، كما أن مُرافِقه لم يكن على معرفةٍ بتفاصيل ما يُعاني منه والده. في تلك الزيارة التي بالكاد تجاوزت العشر دقائق، كان التواصل كارثيًا، ومستوى الخدمة مُخجِلًا، لكن الاستشاري لم يكترث بذلك، فقد كانت أولويته حماية نفسه قبل المريض.
الآن، تبدو الصورة التي أمامنا كالتالي: هناك منظومة بيروقراطية تدفع الأطباء لتقديم مصالحهم على مصالح المرضى، وذلك بجعل النجاح المهني يعتمد على معاييرٍ مؤسساتية تستوجب انضباطًا صارمًا لا يقبل مرونة التعامل الإنساني؛ إنها تأخذ «الطبيب-الإنسان» وتحوله إلى «الطبيب-الآلة» كي يسهل توظيفه واستخدامه. فعندما نَتَمَعَّن في بنية هرم السُّلطة للمنظومة الطبية، سنجد مَن هم في أسفله (كالأطباء المتدربين) يميلون إلى العمل الآلي المُنفِّذ للأوامر، فهم يأخذون القرارات الآتية من رأس الهرم (الاستشاري أو الإداري) ثم يقومون بتنفيذها دون تردد. وهذا لأن تكلفة الاعتراض على القرارات الاعتِباطيّة والمجحفة بحق المرضى، قد تكون باهظة الثمن، فتُكلِّف الطبيب مستقبله المهني. لا أحد في أسفل الهرم يقوى – بسبب موقعه وضعف سُلطته – على مواجهة المنظومة، مما يدفعهم إلى تخدير ضمائرهم بطمأنينةٍ كاذبة «أنا لست مسؤولًا عن هذا القرار، أنا قمت بتنفيذه فقط».
هذه الصورة تفتح لنا باب الحديث عن أخلاقيات استخدام السُّلطة الطبية وكيفية ضبطها؛ فكل ما ذكرناه حتى هذه اللحظة، يُعيدنا إلى حادثة الامتحان مجددًا، لنطرح سؤالنا الأهم في المقالة: متى يكون الانحياز للمرضى واجبًا أخلاقيًا على الطبيب؟
خطيئة الحياد
بعد انتهاء الامتحان ظهيرة ذلك اليوم، ذهبت برفقة أحد الأصدقاء إلى مطعمٍ قريبٍ من المستشفى. لم تكن لدي الشهيّة لتناول أي شيء، لكني فضّلت الذهاب على الاعتذار والغرق في التفكير لوحدي. أخبرت صديقي بتفاصيل الحادثة، ثم سألته عن رأيه.
أخذ وقته ليُفكر قبل إجابته: «لقد كانت نيتك سليمة بلا شك، لكن .. ».
سألته: «لكن؟».
أجاب بحذر: «لا أعلم، هناك شيء بخصوص الانحياز .. لا يبدو لي صحيحًا».
ابتسمت وسألته مجددًا: «أترى الانحياز للمريضة أمام منظومة مؤسساتية .. موقف غير عادل؟».
ابتسم بالمقابل وقال: «لا أريد إفساد شهيتك».
«فَسَدَت حين سمعت ما قاله الاستشاري عن المرضى النفسيين».
«سأكون صريحًا معك .. أتفهم ما قاله تمامًا».
«ما الذي تفهمته حين قال: “هل ستسأل المكتئبة التي تهدد بإيذاء أبنائها إن كانت تود قضاء ليلة في جناح الصحة النفسية؟”».
«حسنًا إذن، لنأخذ مثال هذه المريضة النفسية لإيضاح وجهة نظره، ما رأيك؟».
«لا مانع لدي».
بَدَأ كلامه: «أعتقد أنه لا يصح لنا التعامل مع المسائل الأخلاقية بعقلية إما و أو» ثم رفع قبضتيه وعلقهما في الهواء كما لو أنه يستعرض شيئين مختلفين: «إما هذا أو ذاك .. إما الأبيض أو الأسود .. إما المريضة أو المؤسسة».

بَاعَدَ بين قبضتيه ليرسم خطًا تَخَيُّليًا وأكمل: «هناك طيف ممتد بين المريضة والمؤسسة، تتنوع فيه المواقف الأخلاقية حَسَبَ أمورٍ كثيرة».
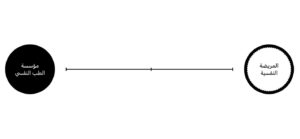
قام بعدها برفع سبابة يده اليمنى وأدارها حول المنطقة الوسطى في طيفه: «نحن كأطباء، علينا موازنة مصالح جميع الأطراف، والعمل في منطقة الحياد الأخلاقي دون الانحياز لأحد».

توقف قليلًا ليأخذ رشفة من الماء ثم أكمل: «إن الانحياز للمريضة النفسية التي تُشكِّل خَطَرًا على نفسها أو الآخرين، يتساوى في لا-أخلاقيته مع الانحياز للمؤسسة، لأنك بذلك تكون قد هددت أمن المجتمع واستقراره بوقوفك مع .. » توقف فجأة كما لم لو أنه سحب الكلمة قبل نطقها.
سألته ساخرًا: «الجنون؟ .. الهستريا؟ .. الفوضى أم الدمار؟».
أجابني: «أفهم من سخريتك أنك لم تقتنع».
«يا صديقي لقد أثبت صحة وجهة نظري بكلامك هذا».
«كيف ذلك؟».
فضيلة الانحياز
تكمن إشكالية هذا التحليل لممارسات الطب النفسي في إغفالها الدور الأساسي الذي تلعبه «علاقة السُّلطة» في رسم حدود الفعل الأخلاقي واللا-أخلاقي. فالصورة التي رسمها صديقي كانت تفتقد واقعية وضع ميزان القوى بين المريضة والمؤسسة، مما جعل طيف المواقف الأخلاقية يمتد كما لو أنه بين طرفين متكافئين! هذا ما دفعه إلى الاستنتاج بأن الانحياز للمريضة يتساوى في لا-أخلاقيته مع الانحياز للمؤسسة. ببساطة، أنه مُخطئ.
لكي نثبت ذلك، علينا أولًا استيعاب ديناميكية العلاقة الطبية وما تتأثر به من عواملٍ مُتعددة. فـ«القوالب النمطيّة» مثلًا، تلعب دورًا مركزيًا في تشكيل التصورات المُضلِّلة التي غالبًا ما تجد طريقها إلى الممارسة اليومية للطب؛ حيث يكون القالب النمطيّ السلبيّ المرتبط بالاضطرابات النفسية كـ«العنف أو الخداع أو انعدام الكفاءة أو البحث عن الاهتمام .. إلخ»، سَببًا مُؤديًا إلى اضطهاد المرضى داخل المؤسسة الطبية (٢).
فما يحصل هنا على المستوى المجهري، هو التصاق الوصمة بـ«إمكانية المعرفة» عند المريضة وتلويثها جوهريًا، حتى يُصبح الطبيب هو صاحب السُّلطة المعرفية العليا في علاقته معها؛ نحن لا نتكلم عن المعرفة الإكلينيكية المتراكمة بالتعلم والخبرة، بل عن أفضلية الطبيب المزعومة بمعرفة حقيقة مُعاناتها وطريق خَلَاصِها. هذا يعني بالضرورة، تهميش دور المريضة في رحلتها العلاجية! مما يقودنا للحديث عن أنواع «الإجحاف المعرفي Epistemic Injustice» الذي يُمارسه الطبيب النفسي بلا وعيٍ منه طوال هذه الرحلة (٣):
لا حاجة للذهاب بعيدًا لرؤية ذلك في الواقع، فكل ما علينا فعله هو تذكر الاستشاري في تلك الظهيرة، حين قال عن المرضى النفسيين أنهم «لا يعرفون مصلحتهم»، وأن علينا «حمايتهم من أنفسهم». هذا الاعتراف الصريح والمباشر بقدرة الطبيب النفسي على ممارسة سُلطته المعرفية بشكلٍ قسري («أنا أعلم منكِ بمصلحتك وأرى أنكِ بحاجة إلى علاجٍ إلزامي»)، تكشف لنا حقيقة انعدام تكافؤ ميزان القوى في هذه الممارسات؛ وبالتالي، تُضاعف من أهمية مُساءلتها أخلاقيًا.
فالخطوة الأولى في تحليلنا هي إعادة رسم صورة واقعية لعلاقة السُّلطة غير المتكافئة بين المريضة والمؤسسة، بعد الأخذ في الحسبان كل العوامل النمطيّة لـ«الجندر والطبقة والتعليم .. إلخ»، والعوامل المؤسساتية لـ«البيروقراطية وسياسات المجتمع .. إلخ» المؤثرة على ديناميكيتها.

ثم الكشف عن طيف المواقف الأخلاقية في حالته منعدمة التوازن؛ وفيه يكون الطبيب النفسي مُمَكَّنًا من استخدام سُلطته بأبعادها التنظيمية – كـقدرته على تحديد مَن هو السوي، ومَن هو المريض؛ مَن يحق له التمتع بالحرية، ومَن تشكل حريته خطرًا على المجتمع – تحت غطاء مؤسسي يكفل له شرعية قراراته.
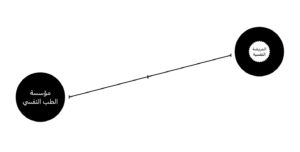
لنصل في النهاية إلى النموذج الأخلاقي لممارسات الطب النفسي كما يفرضه علينا واقع العلاقة؛ فهذه المريضة ليست مجرد «امرأة مُضطربة نفسيًا»، بل هي «امرأة» وهي «مُضطربة نفسيًا»، مما يجعلها مُهمَّشة أكثر في تعاملها مع المؤسسة، لسبب جندري أولًا، ولسبب مَرَضي ثانيًا (٤).

فماذا نقصد بـ«الانحياز الأخلاقي» هنا؟ إنه الانحياز لمُوازنة الكفة، لا قلبها. إنه الانحياز بإشراك المريضة في رحلة العلاج، لا تهميشها. إنه حق الإنصات لما يبدو لنا عصيًّا على الفهم، وحق البحث عن المعنى فيما يبدو لنا غرائبيًا. هو التضامن مع مَن يُعاني بصمت لاستعادة صوته، ومع مَن وُصِموا بالعار ليقولوا: «عارٌ عليكم لتجاهل فظائع هذا العالم».
وعلى الرغم من أهمية مفهوم «الانحياز الأخلاقي» في كشف آليات الاضطهاد الممارسة ضد الفئات المستضعفة، هناك مَن يرى بضرورة التستر على عيوب المؤسسة الطبية أمام عامة الناس! فهم يعتقدون أن هذا الكشف الصريح لممارسات الطب النفسي يُبطل عمل سنوات طويلة من مقاومة الوصمة المرتبطة بالطب النفسي، مما يعيدنا إلى نقطة الصفر .. فهل هذا التفكير سليم؟
ربما عليك الانصات جيدًا كي لا يتأذى أحد
إن طبيعة ممارسة الطب النفسي التي تتعاطى مع ما هو إنساني، تستلزم مقاومة المنظومة البيروقراطية وآلياتها التي تدفعنا إلى أتمتة الطبيب واختزال المرضى. لكي نقاوم، علينا أن نعرف؛ ولكي نعرف، علينا أن نكشف العيوب المستترة؛ لا بقصد إثارة الجدل، بل إثارة المطالب بما هو حق أصيل لكل أطراف العلاقة الطبية. فمن حق المريضة المشاركة في رحلة علاجها، لتتكلم فيُنْصَت لها. ومن حق الطبيب العمل في بيئة تحترم إنسانيته، فلا يجد نفسه مُخيَّرًا بين مصلحته ومصلحة مرضاه.
نقول أخيرًا، إن ما سعت له المقالة، هو إعادة تناغم العلاقة الطبية بتمكين أطرافها مَعرِفيًّا، ليُصبحوا على دراية بالتلاعُبات الخفيّة للمنظومة وهي تشق الأرض المشتركة بينهما. ففي تلك الظهيرة، قبل عدة أعوام، كان للفتاة المُتَمَرِّدة على سرير الفحص الطبي حق رفض المشاركة في الاختبار، لكن المنظومة لم تسمعها، ليس بسبب صمت الفتاة، بل لأن الممارسات الآلية عجزت عن استيعاب معنى هذا الصمت.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
المراجع والهوامش
(١) انظر: https://mana.net/16937
(٢) بوتر، نانسي نيكويست. «الصوت، الإسكات، الاستماع الجيد». موسوعة بلومزبري في الفلسفة الطب النفسي، تحرير شريفة تكين و روبين بلوم.
(٣) Carel, Havi. Phenomenology of Illness. P 180.
(٤) Radden, Jennifer. & Sadler, John Z. The Virtuous Psychiatrist. P 85.
ترجمة: محمد كزوّ - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري حتَّى عندما تعلَم أنّ الآفاق قاتمة، فالأمل يستطيع مساعدتك؛ إنَّه ليس مجرَّد...
«لقد أثبتت السينما بأنّ لها قُدرة فائقة على التأثير. واليوم من خلال هذا المهرجان؛ نتعاون جميعًا لتعزيز اسم الخليج العربي...
لا عجبَ ألا يملك الأسقف بيركلي وقتًا للحسّ المشترك، فهو الرّجل الذي أنكر وجود المادّة. لقد اشتكى في كتابه «مبادئ...
إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...
«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.