لوحات من الفلسفة الوجودية: إضاءة على أبرز مفاهيم ومقولات الوجود | أوس حسن
إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...
يبدو القول بأنّ الحقائق أقلّ أهمّية من المشاعر في تشكيل معتقداتنا حول الأمور التجريبية أمرًا جديدًا؛ على الأقلّ في السياسات الأمريكية. لقد واجهنا في الماضي تحدّياتٍ جسيمة -حتى لمصطلح الحقيقة ذاته- لكن لم يسبق قط وأن جرى تبنّي مثل هذه التحديات علانية باعتبارها استراتيجيّةَ إخضاع السياسي للواقع، وهو ما يمثّل تعريف مصطلح: «ما بعد الحقيقة» بالنسبة لي. ما نقصده بـ «ما بعد» هنا ليس الإشارة إلى مفهوم «تجاوزنا» للحقيقة بالمعنى الزمني، (كما في مصطلح: «ما بعد الحرب»)، بقدر ما هو إشارة إلى طغيان أمورٍ أقلّ أهمية -كالأيديولوجيا- على الحقيقة.
واحدٌ من أعمق جذور «ما بعد الحقيقة» الذي بقي مصاحبًا لنا فترة زمنية طويلة -إذْ هو متأصّلٌ في أدمغتنا عبر تاريخ التطوّر البشري- هو الانحياز الإدراكي (cognitive bias). لقد أجرى علماء النفس منذ عقود تجارب تظهر أننا لسنا عقلانيين تمامًا كما نعتقد، وتتعلّق بعض هذه الأبحاث بشكلٍ مباشر بردود أفعالنا حين نواجه حقائقًا غير متوقعة أو مُزعجة.
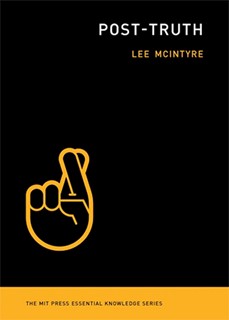
هذا المقال مقتبس من كتاب لي ماكنتاير «Post-Truth»
من المفاهيم المحورية في علم النفس البشري هو أنَّنا نسعى جاهدين لتجنب الانزعاج النفسي؛ إذْ ليس أمرًا سارًا أن ينظر المرء إلى نفسِه نظرةَ سوء. يسمي بعض علماء النفس هذا الأمر «دفاع الأنا» (على اسم نظرية فرويد)، لكن المفهوم واضح، سواءً أوضعناه في إطار نظرية فرويد أم لا؛ فنحن نشعر بأنه من الأفضل لنا الاعتقاد بأننا أشخاصٌ أذكياء ومستنيرون ومؤهّلون بدلًا من الاعتقاد بأننا لسنا كذلك. ماذا يحدث عندما نُواجَه بمعلوماتٍ توحي بأنّ إحدى معتقداتنا خاطئة؟ يخلق ذلك توتّرًا نفسيًا؛ فنقول لأنفسنا: أيعقل أنني ذكي ومع ذلك أعتقد بشيء باطل؟ لا يصمد طويلًا أمام هجومٍ مدمّر من النقد الذاتي إلا الأنا المتضخمة؛ كهذا النقد: «كم كنتُ أحمقًا! لقد كانت الإجابة أمام عينيّ طوال هذا الوقت، لكنّني لم أكلّف نفسي عناء النظر. لا بد من أننّي شخصٌ أحمق». وهكذا، تجري تسوية هذا التوتر في معظم الأحيان بتغيير أحد المعتقدات.
ولكن أيّ معتقدات نغيّر؟ هذا أمر بالغ الأهمية. يود المرء الاعتقاد بأن هذا التغيير يطال دائمًا الاعتقاد الذي ثبت بطلانه؛ فإذا كنا مخطئين بشأن مسألةٍ من الواقع المبني على التجربة -ونقضت الأدلة معتقدنا أخيرًا- فسيبدو من الأسهل إعادة الانسجام إلى معتقداتنا بواسطة تغيير تلك التي بات لدينا الآن سبب وجيه للتشكيك فيها. لكن هذا ليس ما يحدث دائمًا. هناك طرق عديدة لتعديل مجموعة المعتقدات التي يؤمن بها المرء، بعضها عقلاني والبعض الآخر ليس كذلك.
ثلاث نتائج كلاسيكية من علم النفس الاجتماعي
في عام 1957، نشر ليون فيستينجر كتابه الرائد «نظرية في التنافر الإدراكي»، والذي قدّم فيه فكرة أننا نسعى إلى تحقيق الانسجام بين معتقداتنا ومواقفنا وسلوكنا؛ وأننا نشعر بالانزعاج النفسي حين يختل توازنها. إننا، في بحثنا عن تسوية، نجعل هدفنا الأسمى الحفاظ على إحساسنا بالقيمة الذّاتية.
كلّف فيستينجر -في واحدة من تجاربه النموذجية- المشاركين بمُهمّة مُملةٍ للغاية. عيّن فيستينجر مكافأة -لمن يشارك في التجربة- دولارًا واحدًا لمجموعة من المشاركين، في حين يدفع لمجموعة أخرى عشرين دولارًا. وبعد إتمام المهمة، طُلب منهم إخبار من سيؤدون المُهمّة بعدهم بأن التجربة مُمتعة. وجد فيستينجر أنّ الأشخاص الذين تلقوا دولارًا واحدًا ذكروا بأنّ المهمة مُمتعة بشكلٍ كبير، على نحو يفوق ما ذكره أولئك الذين تلقوا عشرين دولارًا. لماذا؟ لأن أناهم كانت على المحك؛ فمن سيؤدّي مهمةً عديمة المعنى وغير مجدية مقابل دولار واحد إلا إذا كانت ممتعة حقًا؟ وهكذا، فمن أجل تقليل التنافر الإدراكي (Cognitive dissonance)؛ غيّروا معتقداتهم إزاء المهمة وإزاء كونها مملة (في المقابل، لم يعشْ الذين تلقّوا 20 دولارًا في وهم [؛فهم يدركون أنه لو لم تكن المهمة مملة؛ لما تلقّوا هذا المبلغ الكبير]). وفي تجربة أخرى، جعل فيستينجر بعض الأشخاص يحملون لافتاتٍ احتجاجية من أجل قضايا لا تمثّل في حقيقة الأمر ما يؤمنون به. والمفاجأة؟ بدأ الأشخاص يشعرون، بعد قيامهم بذلك، أن تلك القضايا تمثّل في حقيقة الأمر قيمةً أكبر عمّا كانوا يعتقدونه في البداية.

لقطة من إحدى تجارب ليون فيستنجر الكلاسيكية حول التنافر الإدراكي
جميعنا نعاني، بدرجةٍ أو بأخرى، من التنافر الإدراكي
لكن ما الذي يحدث عندما يكون ما استثمرناه يفوق بكثير مجرد أداء مُهمّةٍ مُملة أو حمل لافتة؟ ماذا لو اتخذنا موقفًا علنيًا بشأن شيء ما، أو حتى كرّسنا حياتنا له، لنكتشف لاحقًا أننا تعرضنا للخداع؟ حلّل فيستينجر هذه الظاهرة تحديدًا في كتابه «طائفة يوم القيامة The Doomsday Cult» الذي تحدث فيه عن أنشطة مجموعة تسمى ذا سيكرز The Seekers، حيث كانوا يعتقدون بأن زعيمتهم دوروثي مارتن قادرة على تدوين رسائل من كائنات فضائية قادمة لإنقاذهم قبل أن ينتهي العالم في تاريخ 21 ديسمبر من عام 1954. وبعد أن باعوا جميع ممتلكاتهم، انتظروا على قمة جبل، حيث لم يظهر الفضائيون قط، (وبالطبع، لم ينته العالم). لا بد من أنّ التنافر الإدراكي لديهم كان هائلًا. لكن كيف توصلوا إلى تسوية بشأنه؟ سرعان ما استقبلتهم دوروثي مارتن برسالة جديدة: كانت دعواتهم وصلواتهم قوية للغاية لدرجة أن الفضائيين ألغوا خططهم. لقد أنقذ ذا سيكرز العالم!
يسهل علينا من منظور خارجي استبعاد هذه المعتقدات باعتبارها تخصّ بعض الحمقى السُّذّج، لكن ظهر من خلال الأبحاث التجريبية التي قام بها فيستينجر وآخرون أننا نعاني جميعًا -بدرجة أو بأخرى- من التنافر الإدراكي. عندما ننضم إلى نادٍ صحي يقع بعيد جدًا عنا، فقد نبرّر الاشتراك بالقول لأصدقائنا إنّ التدريبات مُكثّفة للغاية ولا يتطلب أداؤها إلا مرّة واحدة في الأسبوع؛ وعندما نفشل في الحصول على الدرجة التي نرغب بها في الكيمياء العضوية، نقول لأنفسنا أننا لم نرغب حقًا في الالتحاق بكلية الطب على أيّ حال. بيد أنّ هناك جانبًا آخر من التنافر الإدراكي لا ينبغي لنا التقليل من شأنه، ألا وهو أنّ مثل هذه الميول «غير العقلانية» تميل إلى أن تتعزّز في وجود آخرين محيطين بنا يؤمنون بما نفعله. فلو كان هناك شخص واحد فقط يؤمن بـ «طائفة يوم القيامة»، فلربما انتحر أو اختبأ. لكن عندما يتشارك الآخرون في الإيمان باعتقاد خاطئ، يصبح في الإمكان في بعض الأحيان تبرير أكثر الأمور التي يصعب تصديقها.
في بحثه الرائد عام 1955، بعنوان: «الآراء والضغط الاجتماعي»، أوضح سولومون آش أن هناك جانبًا اجتماعيًا فيما يخص المعتقدات، من ذلك أننا قد نستبعد حتى الدلائل الحسية الشخصية إذا اعتقدنا أن معتقداتنا لا تنسجم مع معتقدات أولئك المحيطين بنا. باختصار، ضغط الأقران أثره واضح جلي. فمثلما نسعى لتحقيق الانسجام بين معتقداتنا، فإننا نسعى أيضًا إلى الانسجام مع معتقدات من حولنا.
في تجربته، عمل آش على جمع سبعة إلى تسعة أشخاص، جميعهم -ما عدا شخص واحد- كانوا من «الحلفاء» (أيّ أنهم كانوا متواطئين مع آش في التجربة). كان الشخص الذي لم يكن متواطئًا معه هو الوحيد الخاضع للتجربة، والذي كان يُحدّد مكانه دائمًا في آخر مقعد على الطاولة. تضمنت التجربة عرض بطاقة تحتوي على خط واحد على الأشخاص المشاركين في التجربة، ثم بطاقة أخرى بها ثلاثة خطوط، وكان أحد هذه الخطوط مطابقًا في الطول للخط الموجود على البطاقة الأولى. كان الخطّان الآخران في البطاقة الثانية «مختلفين اختلافًا جوهريًا» في الطول. ثم دار المُختَبِر حول المجموعة وطلب من كل شخص أن يقول بصوتٍ عال أي الخطوط الثلاثة في البطاقة الثانية متساوية في الطول مع الخط الموجود على البطاقة الأولى. في الأدوار الأولى من التجربة، أبلغ الحلفاء عن المعلومات بدقة، واتفق معهم بالطّبع الشخص الخاضع للتجربة. ولكن بعد ذلك أصبحت الأمور مثيرة للاهتمام. أجمع الحلفاء على أن أحد الخيارات الخاطئة على نحوٍ واضح كان مساويًا لطول السطر على البطاقة الأولى. بحلول الوقت الذي جاء فيه دور السؤال إلى الشخص الخاضع للتجربة، كان هناك توتر نفسي واضح. وكما يصفه آش:
«لقد وُضِع في موقفٍ وجدَ فيه نفسه بأنه إنْ جاوب بالجواب الصحيح فسيكون أقلية مكونة من شخص واحد أمام معارضة قد أجمعت إجماعًا اعتباطيًا فيما يتعلّق بحقيقةٍ واضحة وبسيطة. لقد جعلناه يواجه قوّتين مُتعارضتين تمارسان الضغط عليه: دليل حواسّه الذاتية وإجماع الرأي لدى مجموعةٍ من أقرانه».
قبل إعلانهم عن الإجابات، بدا تقريبًا جميع الخاضعين للتجربة -الذين أخضعوا للتنافر الإدراكي- مندهشين للغاية، بل وحتى متشكّكين. ثم حدث شيء غريب: خضع 37% منهم لرأي الأغلبية. لقد استبعدوا ما يرونه أمامهم رأي العين في سبيل البقاء منسجمين مع المجموعة.
من الأبحاث التجريبية الرئيسية الأخرى التي تناولت اللاعقلانية البشرية كان ما قام به بيتر كاثكارت واسون في عام 1960. ففي ورقته البحثية: «حول الفشل في استبعاد الفرضيات في المهام المفاهيمية»، اتخذ واسون الخطوة الأولى ضمن عدد من الخطوات لتحديد الأخطاء المنطقية والمفاهيمية الأخرى التي يرتكبها البشر على نحوٍ روتيني في التفكير. في هذه الورقة الأولى، قدّم واسون فكرة (وقد سُميت بالاسم الذي عُرفت به فيما بعد) سمع بها تقريبًا كل شخص في فضاء نقاشات «ما بعد الحقيقة»، ألا وهي: الانحياز التأكيدي (confirmation bias).
كان تصميم واسون التجريبي أنيقًا. لقد كلّف 29 طالبًا جامعيًا بمهمة إدراكية، حيث طُلب منهم «اكتشاف قاعدة»، بناءً على أدلة تجريبية. قدّم واسون للمشاركين سلسلة من ثلاثة أرقام مثل 2، 4، 6، وأخبرهم بأنّ مهمتهم هي اكتشاف القاعدة المُستخدمة في توليدها. طُلب من المشاركين كتابة ثلاثة أرقام، وبعدها سيقول صاحب التجربة ما إذا كانت أرقامهم تتوافق مع القاعدة أم لا. يحقّ للمشاركين تكرار هذه المهمة [=كتابة الأرقام الثلاثة وعرضها على الباحث] بقدر ما يشاءون، لكن تم توجيههم لمحاولة اكتشاف القاعدة في أقلّ عدد ممكن من المحاولات، ولم توضع قيود على أنواع الأرقام التي يمكن اقتراحها. وحالما يشعر الخاضعون للتجربة بأنهم مُستعدون، يمكنهم حينها اقتراح القاعدة.
كانت النتائج صادمة. من التسعة والعشرين مشاركًا في التجربة ممن يعتبرون في غاية الذكاء، توصل ستة منهم فقط للقاعدة الصحيحة دون أيّ تخمينات سابقة غير صحيحة. كما قدّم ثلاثة عشر شخصًا قاعدة واحدة غير صحيحة، وقدّم تسعة آخرون قاعدتين أو أكثر من القواعد غير الصحيحة، ومشارك واحد لم يستطع أن يقدم ولا قاعدة واحدة. ما الذي حدث؟
كما يخبرنا واسون، بدا أن المشاركين الذين فشلوا في المهمة [في المحاولة الأولى] كانوا غير مستعدين لتقديم أيّ مجموعة من الأرقام تضع قاعدتهم المفترضة موضع اختبار، وقدّموا بدلاً من ذلك أرقامًا تؤكد القاعدة فحسب. على سبيل المثال، بالنظر إلى السلسلة 2، 4، 6، كتب العديد من الأشخاص أولاً 8، 10، 12، وقيل لهم: «نعم، هذا يتبع القاعدة». لكن بعد ذلك، استمرّ البعض في تقديم أرقام زوجية بترتيب تصاعدي بمقدار اثنين؛ إذْ بدلاً من انتهاز فرصتهم لمعرفة ما إذا كانت قاعدتهم المفترضة «الزيادة بمقدار اثنين» غير صحيحة، استمروا وحسب في اقتراح حالات تؤكد هذه القاعدة. عندما أعلن هؤلاء الأشخاص عن قاعدتهم، صُدموا حين قيل لهم إنها غير صحيحة، على الرغم من أنهم لم يضعوا هذه القاعدة موضع اختبار مطلقًا بتقديم أمثلة قد تدحض صحتها.
بعد ذلك، شرع 13 مشاركًا في اختبار فرضياتهم، وتوصلوا في النهاية إلى الإجابة الصحيحة، وهي: «أيّ ثلاثة أرقام بترتيبٍ تصاعدي». فبمجرد خروجهم من عقليتهم «المؤكِّدة»، كانوا على استعداد لأن يأخذوا بعين الاعتبار فكرة وجود أكثر من طريقة للحصول على سلسلة الأرقام الأصلية. غير أن هذا لا يفسّر تصرف المشاركين التسعة الذين قدموا قاعدتين أو أكثر من القواعد غير الصحيحة، حيث مُنِحوا الأدلة الكافية على أن اقتراحهم كان خاطئًا، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على الإجابة الصحيحة. لماذا لم يخمنوا الأرقام 9، 7،5 مثلًا؟ هنا يتكهن واسون بأنهم «ربما لم يعرفوا كيف تُدحض القاعدة، أو ربما كانوا على علم بذلك، لكنهم ما زالوا يجدون أنّ من الأسهل أو الأكثر تيقّنا الحصول على إجابة مباشرة من القائم على التجربة». بعبارةٍ أخرى، كانوا واقعين تحت قبضة الانحياز الإدراكي المُحكمة، وكل ما كان بوسعهم فعله هو التلويح تلويحًا مهتاجًا تجاه الإجابة الصحيحة.
من الواضح أنّ جميع هذه النتائج التجريبية الثلاثة -(1) التنافر الإدراكي، (2) الامتثال الاجتماعي، (3) الانحياز التأكيدي- ذات صلة بما بعد الحقيقة، إذ يبدو لنا أن الكثير من الناس يميلون إلى تشكيل معتقداتهم بما لا يتوافق مع مبادئ العقل والمعايير الوجيهة للأدلة، في سبيل التوفيق بين حدسهم وحدس أقرانهم.
غير أنّ «ما بعد الحقيقة»، لم تظهر إلا في الخمسينات أو الستينات من القرن الماضي. لقد انتظرت العاصفة المثالية التي تألفت من بعض العوامل الأخرى، مثل التحيّز الحزبي المتطرف، و«صوامع» وسائل التواصل الاجتماعي التي بزغت في أوائل القرن الحادي والعشرين. في غضون ذلك، استمر ظهور المزيد من الأدلة المذهلة على الانحياز الإدراكي؛ لا سيما «تأثير النتائج العكسية backfire effect»، و«تأثير دانينغ-كروجر Dunning-Kruger»، وكلاهما متجذر في فكرة أن ما نأمل بأن يكون حقيقيًا قد يشوّه إدراكنا لما هو حقيقيّ بالفعل.
الآثار المترتبة على ثقافة ما بعد الحقيقة
لعلَّ تحيزاتنا الإدراكية كانت عرضة للتصويب في الماضي بواسطة تفاعلاتنا مع الآخرين. من المفارقات الاعتقاد أننا -وفي وسط طوفان وسائل الإعلام المحيط بنا اليوم- قد نكون أكثر انعزالًا عن الرأي المخالف مما كان عليه الحال عندما اُضطرَ أسلافنا، لكي يحصلوا على المعلومات، على العيش بين أعضاء آخرين لا ينتمون إلى قبيلتهم أو قريتهم أو مجتمعهم؛ والعمل معهم، والتفاعل مع بعضهم بعضًا. عندما نتحدّث فيما بيننا، فلا يسعنا إلا أن نتعرّض لتنوّعٍ في وجهات النظر. بل إن هناك أبحاثًا تجريبية تظهر الفائدة التي قد يضيفها فعل ذلك إلى تفكيرنا.
ناقش كاس سنشتاين في كتابه «Infotopia» فكرة أنه عندما يتفاعل الأفراد مع بعضهم بعضًا، فقد يصلون في بعض الأحيان إلى نتيجةٍ كانت لتفوتهم لو أن كلّ واحد منهم تصرّف بمفرده. سمِّه إن شئت تأثير «قيمة الكلي تفوق مجموع أجزائه». يطلق عليه سنشتاين: «تأثير المجموعة التفاعلية».
وفي إحدى دراساته الأخرى، جمع واسون وزملاؤه مجموعة من المشاركين لحلِّ لغزٍ منطقي. كان لغزًا صعبًا، ولم يستطع حلّه دون مساعدة إلا أفراد قلة. لكن عندما نقل اللغز في وقتٍ لاحق إلى مجموعة من المشاركين لحلّه، حدث أمرٌ مثيرٌ للاهتمام: بدأ الأفراد في التشكيك في منطقهم، والتفكير في أمور كانت خاطئة في فرضيّاتهم، لدرجة بدا أن هذا التشكيك غير ممكن التحقق لو اعتمدوا على أفكارهم دون مساعدة من أحد. وكنتيجةٍ لذلك، وجد الباحثون أنه في عدد كبير من الحالات، تستطيع المجموعة حلّ اللغز حتى وإنْ لم يستطع أيٌّ من أعضائها حلّ ذلك اللغز بمفرده (جديرٌ بالاهتمام ملاحظة أن هذا الأمر لم يكن ناتجًا عن ظاهرة: «أذكى شخصٍ بالغرفة»؛ حيث يكتشفُ شخصٌ واحد الإجابة ويخبر بها البقيّة. لم يكن الأمر أيضًا مجرد تأثيرٍ لـ «حكمة الجمهور»، حيث يُعتمد فيه على رأي الغالبية السلبي. لم يوجد التأثير إلا عندما يتفاعل أعضاء المجموعة مع بعضهم البعض فقط).
وهذا أمرٌ مفتاحي بالنسبة لسنشتاين: جهود المجموعات يتفوق على جهود الأفراد، وتتفوق المجموعات التي تتفاعل وتتشاور مع بعضها البعض على المجموعات التي لا تفعل ذلك. عندما نضع أفكارنا على طاولة التمحيص الجماعي؛ فإن ذلك يوفر لنا أفضل فرصة للعثور على الإجابة الصحيحة. وعندما نبحث عن الحقيقة، فإن التفكير النقدي والتشكيك وإخضاع أفكارنا للتدقيق والتمحيص على يد الآخرين يقدم نتائج تفوق أي وسيلة أخرى.
غير أننا نملك في هذه الأيام ذلك رفاهية اختيار مع من نتفاعل. يمكننا، بغض النظر عن قناعاتنا السياسية، العيش في «صومعة من الأخبار» إن كنا نود ذلك. إذا لم تعجبنا تعليقات شخص ما، فيمكننا إلغاء صداقته أو إخفائه من على فيسبوك. إذا أردنا الانغماس في نظريات المؤامرة، فستكون هناك على الأرجح محطة إذاعية لنا. إن بوسعنا -في هذه الأيام بالذات وعلى نحو يفوق أيّ وقت آخر- إحاطة أنفسنا بأشخاصٍ يتفقون معنا مسبقًا. لكن ألن نكون -بمجرد فعلنا لذلك- في مواجهة ضغط تشذيب آراءنا لتناسب المجموعة؟
لقد أظهر عمل سولومون آش بالفعل أن هذا ممكن. ربما نشعر، في حال كنا ليبراليين [في أمريكا]، بشيء من عدم الارتياح إنْ اتفقنا مع معظم أصدقائنا بشأن الهجرة وزواج المثليين والضرائب، ولكن تخامرنا الشكوك في مسألة ضبط حيازة الأسلحة (gun control). إذا كان الأمر كذلك، فربما ندفع ثمنًا اجتماعيًا يدفعنا لتغيير آرائنا[1]. إلى الحد الذي يصبح فيه حدوث هذا الأمر نتيجة لرغبتنا في عدم الإساءة لأصدقائنا، لا نتيجة التفاعل النقدي، وهذا على الأغلب ليس بالأمر الجيّد. سمِّه إن شئت الجانب المظلم لتأثير المجموعة التفاعلي، والذي بوسع أيّ واحدٍ كان عضوًا في هيئة الملحفين أن يصفه: نشعر براحة أكبر عندما تتماشى وجهات نظرنا مع وجهات نظر مواطنينا. لكن ماذا يحدث عندما يكون مواطنونا على خطأ؟ سواءً كنت ليبراليًا أم محافظًا؛ فلا أحد يحتكر الحقيقة.
لستُ أقترح هنا تبنّي التكافؤ الخاطئ، أو أنّ الحقيقة قد تكون قابعة في مكان ما بين الأيديولوجيات السياسية. إذ إن نقطة المنتصف بين الحقيقة والخطأ ما تزال خطأ. لكنني أقترح أن جميع الأيديولوجيات، وعلى مستوى ما، عدوةً للعملية التي تُكتشف من خلالها الحقائق. ربما يكون الباحثون مُحقّين في مسألة أن لدى الليبراليين «حاجة التحقّق من المسائل» تفوق ما لدى المحافظين، لكن هذا لا يعني أن يكون الليبراليون متعجرفين أو يعتقدون بأن حدوسهم السياسية بمثابة وكيل عن الحقائق الواقعيّة.
يمكننا أن نرى في أعمال فيستينجر وآش وآخرون مخاطر التوافق الأيديولوجي، فالنتيجة هي أن لدينا جميعًا تحيزًا إدراكيًا داخليًا للاتفاق مع ما يعتقده الآخرون من حولنا، حتى وإن كان الدليل الموجود أمام أعيننا يخبرنا بخلاف ذلك. إننا نثمّن جميعنا -عند مستوى ما- تقبّل المجموعة لنا، حتى وإن أتى ذلك في بعض الأحيان على حساب الواقع نفسه، لكن علينا محاربة ذلك إن كنا نهتم بالحقائق. لماذا؟ لأنّ التحيزات الإدراكية تعتبر المُقدّمة المثالية لثقافة ما بعد الحقيقة.
إذا كان لدينا بالفعل الرغبة في تصديق أشياء معينة؛ فلن يتطلب الأمر جهدًا كبيرًا لإقناعنا بتصديقها، وخاصة إذا كان الآخرون الذين نهتم لأمرهم يصدّقونها. تجعلنا تحيّزاتنا الإدراكية المتأصّلة مهيئين للخضوع للتلاعب والاستغلال من قبل أولئك الذين لديهم أجندة يسعون لتحقيقها، وبالأخص إذا كان بمقدورهم تشويه سُمعة جميع مصادر المعلومات الأخرى. ومثلما أنه لا مفرّ من الانحياز الإدراكي، فإن صومعة الأخبار لا تحمينا من ثقافة ما بعد الحقيقة، وذلك لأن الخطر يكمن في أنهما متصلان عند مستوى معيّن. إنَّنا ممتنون جميعًا لمصادر معلوماتنا، لكننا معرضون للخطر على نحوٍ خاصّ عندما تخبرنا هذه المصادر بما نودّ سماعه بالتحديد.
لي ماكنتاير: باحث في مركز فلسفة وتاريخ العلوم بجامعة بوسطن. مؤلف للعديد من الكتب، بما في ذلك كتاب «العصور المظلمة: حجة لعلم السلوك البشري» (Dark Ages: The Case for a Science of Human Behavior)، وكتاب «الموقف العلمي: الدفاع عن العلم ضد الإنكار والاحتيال والعلم الزائف» (The Scientific Attitude: Defending Science from Denial, Fraud, and Pseudoscience)، وكتاب «ما بعد الحقيقة» ( Post-Truth).
[1] يقصد الكاتب أنّ الليبرالي سيتفق مع أصدقائه الليبراليين في جميع المسائل ما عدا مسألة واحدة؛ ألا وهي ضبط حيازة الأسلحة، وإنْ كان محيطه في مواقع التواصل جميعه من الليبراليين؛ فقد يؤدي ذلك إلى تغيير رأيه في هذه المسألة بحيث يوافق رأيهم (المُراجع).
المصدر (ضمن اتفاقية ترجمة خاصّة بمنصة معنى).
إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...
رأى الطيار كينيث أرنولد، في 24 يونيو 1947م، تسعة أجسام هلالية الشكل تحلق بالقرب من جبل رينييه في ولاية...
ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...
يدعونا جون بول سارتر في رائعته «الكينونة والعدم» -التي كُتبت خلال الاحتلال النّازيّ لفرنسا- إلى تخيّل مشهدٍ من الحياة اليوميّة:...
«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.