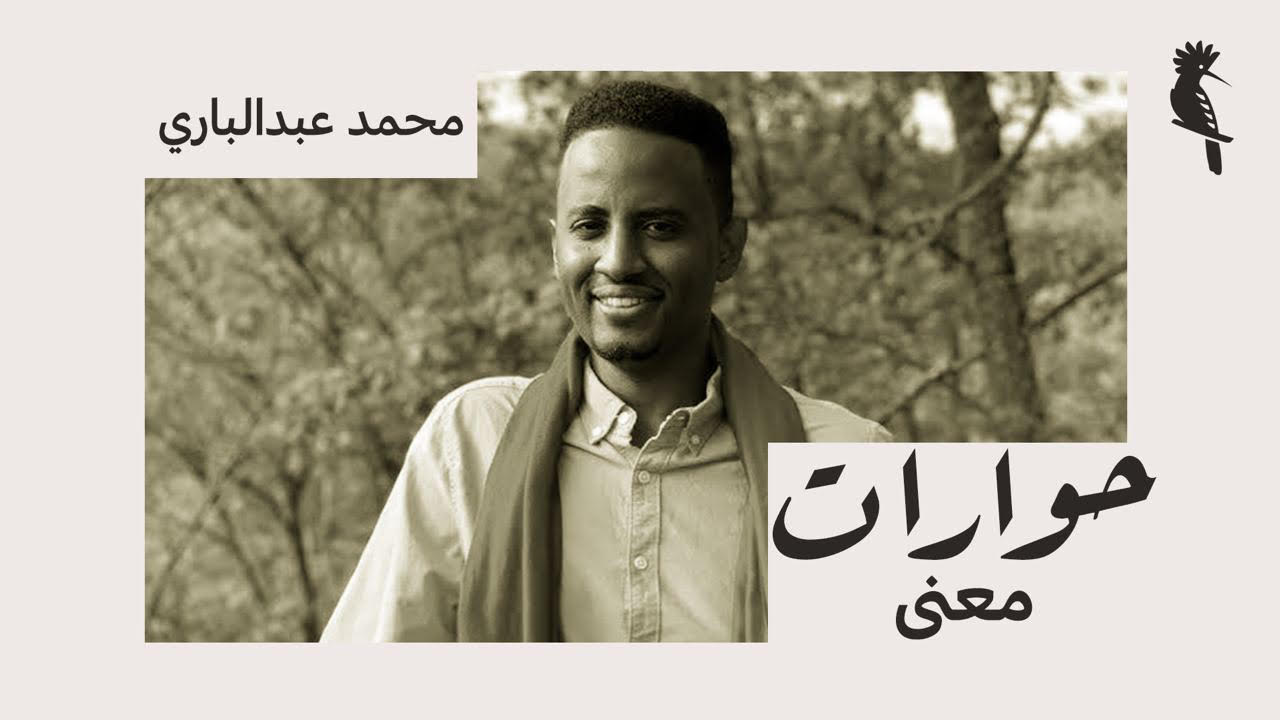(لم يعد أزرقا) شظايا متناثرة جراء سقوط مرآة واحدة،
والفلسفة العربيّة غائبة.
– أولاً: نبارك لك صدور ديوانك الجديد (لم يعد أزرقا). ونوّد لو حدّثتنا عن مناخاته قليلًا وعما يميّز هذا العمل عن أعمالك الثلاثة السابقة.
في هذا الديوان حاولت أن أكون وفيًّا أكثر لفكرة التجربة الذاتيّة، فالعمل في مجمله كان تتبّعًا شعوريًّا لكل الانعكاسات التي خلفتها فيّ تجربة بعينها. كُتب الديوان بنَفَس متصل، ولذا دارات نصوصُه -على اختلاف موضوعاتها- حول جوهر موحّد إلى حد ما، الأمر كان أشبه بلملمة كل الشظايا المتناثرة جرّاء سقوط مرآة واحدة. أعتقد أن هذا الطابع الواحد المتشعّب هو أكثر ما يميز هذا الديوان عن الدواوين السابقة التي لم تشذّ عن الوظيفة المعتادة لديوان الشعر من حيث هو مكان تصطف فيه نصوص مختلفة جنبًا إلى جنب بعد أن تتكاثر.
– كتُب الديوان بالكامل أثناء إقامتك في نيويورك، فهل كان لتجربتك في لنيويورك – أو في أمريكا بشكل عام- أية تأثيرات مباشرة في هذا العمل؟
لا، ليس هناك أي حضور لنيويورك في هذا العمل، نيويورك منحتني فقط مساحة التفرغ التام لاستدعاء كل أصداء وظلال تجربةٍ شخصيّة كانت في أصلها سابقةً على وصولي لأمريكا. من جهة أخرى، لا أعتقد أنه كان من الممكن لتأثيرات المناخ الجديد فيّ أن تجد طريقها لما أكتب بهذه السرعة. ثمة فاصل زمنيّ ضروريّ تحتاجه رائحة الوردة لتنتقل من الحديقة إلى القصيدة. التخمر والتخمر وحده هو من يسمح للفكرة المجردّة أن تصبح فكرة شعريّة، بالنسبة لي، لم أشعر بتخمّر فكرة أمريكا فيّ إلا بعد انتهائي من كتابة (لم يعد أزرقا)، لذا أعتقد أن هذه التأثيرات ربما تتضح معالمُها في القادم من النصوص.
– أود أن تلقي بعض الضوء على علاقتك بالشعر المكتوب بالإنجليزيّة وعن فكرة الترجمة الشعريّة.
بعد طول تقلّب بين الشعراء الذين يكتبون بالإنجليزيّة، أجدني دائمًا ما أعود إلى قراءة: والت ويتمان وروبرت فروست وييتس وويستن هيو أودن. أحب في ويتمان روحه الهائلة الكليّة التي تفيض بما يوحّد المتناقضات ويلخص تاريخ البحر كله في قطرة واحدة. أحب في فروست أنه أكثر من غنّى للطبيعة ذكاءً وأكثر من رفع هذا الغناء إلى مرتبة الحكمة الخالصة. أما ييتس فأحب الاندفاعة الجامحة للحياة في قصائده، ويلفتُني كيف أن هذا الجموح المتدفق من دمه الأيرلندي الحار لم يفرّط أبداً في شرطه الجماليّ. وأحب في أودن مهارته التي سمحت له وبكل خفة أن يختص لنفسه أسلوبًا مضفورًا من ألف أسلوب، وهذه السعة الأسلوبيّة هيأته ليتسع في موضوعاته سعة جديرة بالملاحظة. هناك بالطبع قصائد كثيرة أحبها لطيف أوسع بكثير من شعراء الإنجليزيّة، ولكن إن تحدثنا عن الشعراء لا عن القصائد، فهؤلاء الأربعة أكثر من شعرت بتماهٍ ما مع تجاربهم بكل ما فيها من لغة خاصة وفكرة عميقة وإيقاع يشّف ويتكثّف بحسب إيحاءاته وحمولاته.
فيما يتعلق بالترجمة الشعريّة، أعتقد أنها -وبالرغم من النقص الطبيعيّ المتجذر في بنيتها- شديدة الأهمية نظرًا لما تقوم به من عمليات تدوير الهواء بين التقاليد الشعريّة المختلفة. بالطبع أتفق مع كل الآراء الدارجة حول الخيانة المضاعفة التي تنطوي عليها الترجمة الشعريّة، وهي آراء متواطئة كثيرة أوجزها ببراعة فروست في قوله الذائع “الشعر هو ما يضيع في الترجمة”، لكنني أعتقد أن من جهة أخرى هذا التصور ناقص ومخل، لأن الترجمة كما أنها قد تطمس الشعر، فهي في أحايين كثيرة تكشف عنه. في الأساس، كل شعر حقيقيّ إنما هو مكّون من بنية ثابتة قوامها أولاً: معرفة تجاه العالم (معرفة غامضة وحدسيّة إلى حد ما)، وثانياً: أسلوب تتوسل به هذه المعرفة. نحن متفقون على أن الأسلوب يضيع في الترجمة، ولكن علينا أن ننتبه إلى المعرفة – بمعناها الشعريّ- تبقى. قد أذهب إلى أبعد من هذا وأقول إن الترجمة تقدم لنا أحد أهم الاختبارات التي نفاضل بها بين الشعراء حين تربكُنا السطوح المتشابهة لأساليبهم، فلو أردنا مثلاً أن نميّز في لغتنا نحن بين الشاعر الصادر عن موقف في الوجود ورؤية عن العالم والشاعر المجانيّ الذي يداري خواءه بألاعيب الأسلوب، كل مع علينا فعله هو أن نترجمهما، سنلحظ أن الأسلوب في الحالتين سيتعرض للضرر، ولكن المعرفة في الغالب الأعم ستكون أكثر قدرة على النجاة، وحينها ستكون المسافة بين الشاعرين أكثر وضوحًا. الترجمة أيضاً تسهم في تجديد طرافة المقروء وإزالة حجاب الألفة عنه، العارف بالمتنبيّ سيلحظ أنّ أجزاءً من المتنبي تتجدّد بين يديه حين يقرأ -مثلاً- ترجمة آربري البارعة له.
بالطبع، هذه الإجابة العامة تتناول الترجمة الشعريَة بوصفها مبدأً أو فكرة ولا تقصد الحديث عن واقع الترجمة الذي تتباين فيه المحاولات فشلًا ونجاحًا.
– من خلال معرفتي بك، لاحظت اهتمامك الكبير بموضوع الكوميديا. بالإضافة إلى الحضور الدائم لحس الفكاهة عندك، أنت أيضا معنيّ به بوصفه فنًّا، وقد تسنى لي في مرات عديدة أن أصحبك إلى أندية الكوميديا في نيويورك. لم تولي كل هذا الاهتمام بالضحك؟
لا موهبة تعدل عندي خفة الدم، وهي موهبة جادّة على عكس ما يوحي به ظاهرُها، ففي كل نكتة ثمة موقف وجوديّ مهم يعترض على أخذ هذا العالم على محمل الجد. ومن جهة أخرى، لو شرّحنا بنية النكتة سنلحظ انطواءها على مزيج معقّد من المواهب، مزيج من الذكاء اللغوي ومن دقة الملاحظة وبراعة التحليل والربط. بالإضافة إلى هذا، أنا ترعرعت في حارة شعبيّة من حواري الرياض كان الضحك جزءًا من مزاجها العام إلى حد أننا كنا نقيم في طفولتنا منافسات في السخرية (أو الحشّ كما كنا نسميه آنذاك)، وربما كان هذا ما قادني مبكرًا إلى التوغل في ميراث الضحك الهائل في ثقافتنا العربيّة، هذا الميراث الذي ينتظم الهجائيّات والأجوبة المسكتة والنوادر التي لم تقتصر فقط على أخبار الحمقى والمغفلين والمجانين، وإنما تجاوزتها لأخبار طبقات أخرى من الصفوة.
في أمريكا، اكتسب الضحك عندي أهميّة إضافيّة، ليس فقط لأنّ أمريكا قارة الضحك بكل ما تحمله الكلمة من دلالات بريئة ومغرضة، ولا لأن الضحك هنا صناعة قائمة بذاتها (ونيويورك بالمناسبة في القلب من هذه الصناعة) ولكن لأن الضحك بات الملجأ الأخير للحقيقة في ضوء هيمنة الغمامة الثقيلة للصوابيّة السياسية على الأجواء. وأظنك تتذكر كيف أننا كنا نذهب معاً لأندية لعروض الكوميديا من أجل هدفين: الضحك ومعرفة الوجه الحقيقيّ لأمريكا، وفي العادة كنا نعود بهما معًا آخر الليل.
– لك اهتمام بمجالات معرفيّة متعددة ولكن الفلسفة تقع في القلب من هذا الاهتمام حيث تستأثر بنصيب الأسد من قراءاتك بالإضافة إلى كونك تستعد الآن لمشوار نيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة. متى وكيف بدأت هذه العلاقة مع الفلسفة ولماذا ما تزال تستأثر – دون غيرها من التخصصات- بالجزء الأكبر من قراءاتك؟
لا أتذكر على وجه الدقة متى بدأت علاقتي بالفلسفة، ما أتذكره أنني ومنذ سنّ مبكرّة تشعّبت بي القراءات الأساسيّة في علوم اللغة وفي علوم الدين وقادتني -بما تنطوي عليه من حوافٍ متصلة بالتفلسف- إلى قراءات فلسفيّة محضة، هذه القراءات تدرجت بي من الأسهل إلى الأكثر تعقيداً ومن القديم إلى المعاصر. هناك أيضا مسألة الطبع، فمنذ أوائل صباي، آنست من نفسي نزوعًا للتجريد واستعدادًا فطريًّا للتعاطي مع كليّات المسائل لا مع جزئياتها، وهذان المنزعان كما تعرف هما بابا التفلسف الكبيران.
الفلسفة ما زالت تستأثر بوقتي ليس فقط لأنها تقع في صلب تخصصي الأكاديميّ، ولكن لأنها ما زالت – بوصفها نشاطًا خلّاقًا أصادفه في الفكر وفي الأدب وفي التصوف وفي العلوم الطبيعيّة أيضاً- أكثر المعارف التي تمنحني هذه الطاقة العجائبيّة، طاقة الإضاءة القصوى للعقل وللروح معًا.
– الفلسفة أيضاً تشتمل على تخصصات واتجاهات متنوعة، أي اتجاه من هذه الاتجاهات يستهويك ويستولي على اهتمامك؟ وما هي المسألة الفلسفيّة التي تشغلك وهل سنرى لك قريباً إسهامًا مكتوبًا فيها؟
من ناحية المبدأ، ليس هناك اتجاه أو فرع يستهويني دون غيره، فبالنسبة لي، واستصحابًا للطبيعة الخاصة للتفلسف من حيث هو نظر كليّ في الأشياء، أجد الفصل بين فروع الفلسفة متعذرًا. بالطبع، أفهم العلل الوسائليّة والتعليمية لفكرة الحدود بين النشاطات الفلسفيّة ولكنني علينا ألا نعترف لها بحقيقة خارجة عن هذه الطبيعة التعليميّة أو التنظيميّة. كل بحث معمّق في الابستمولوجيا -مثلاُ- قد ينتهي بصاحبه إلى مواجهة أشق أسئلة الميتافيزيقيا والعكس أيضًا صحيح (مثالاً لا حصراً، يمكن التدليل على هذا التداخل بين مجالات المعرفة والوجود وما وراء الطبيعة بكتاب الحروف للفارابيّ الذي لا يمكن بحال إدراجه تحت أحد هذه الفروع دون الآخر).
أما من الناحية العمليّة، منذ سنوات وأنا أُولي اهتمامًا خاصًا لنظرية المعرفة (الإبستمولوجيا)، لأنني منشغل بتتبع فكرة قد تكشف عن آليّة إدراكيّة موحدّة اعتمدها العقل العربي لينتج ما أنتجه في كافة حقوله الفلسفيّة والدينيّة واللغويّة وحتى العلميّة الطبيعيّة، وهذا الآلية يمكن أن تسهم في الإجابة عن السؤال الإنسانيّ المشترك: كيف نعرف أو كيف ندرك. إذا جرت الأمور كما أخطط لها، فسيكون هذا أول إسهام فلسفي مكتوب أقوم به. الخطاطة الأوليّة للمشروع ضخمة وتحتاج إلى تجزئة ومراحل متدرجة في الإنجاز، لذلك حرصت -بالإضافة إلى تكثيف القراءات حول الأمر في تاريخ الفلسفة الطويل قديمًا وحديثًا- أن يذهب مساري الأكاديميّ في الاتجاه ذاته، فقد أنجزت رسالة الماجستير في موضوع ذي صلة، كما أعمل الآن على تناول جانب آخر من المسألة في رسالة الدكتوراة. ستشكل القراءات المطولة داخل التقليد الفلسفيّ -بما فيها خلاصات عملي في مرحلتيّ الماجستير والدكتوراة- النواة الأساسيّة للمشروع، ولكنها لن تقتصر على هذه القراءات ولا على معالجة السؤال في دائرة المعارف التراثية من علم كلام وأصول فقه وبلاغة ونقد، فلا بد من التماس مع علوم الإدراك المعاصرة لأن الموضوع ينطوي على تشعبات وامتدادات تصله بعلم النفس وعلم الأعصاب وعلم التشريح…إلى آخره. هذه هي المسألة التي تشغلني فلسفيًّا الآن، وهي المسألة التي آمل ألا تخون فيها الهمة وألا ينصرف الهم.
– كيف تنظر إلى التراث الفلسفيّ في الحضارة العربيّة الإسلاميّة وكيف تقيّم إسهامات هذا التراث بالنظر إلى تاريخ الفلسفة بشكل عام؟
أنظر إلى هذا التراث بعينين، الأولى: تتعلق بالجزء الثاني من سؤالك، ومفادها أن منجزات هذا التراث بالنظر إلى تاريخ الفلسفة كما نعرفه اليوم، ما تزال غير مكتشفة بعد. التراث الفلسفيّ العربيّ الإسلاميّ مبتلى أكثر من غيره بأن لا يُقرأ وإنما في أحسن الأحوال يُقرأ عنه. وهذه الهوة بين المنجز وبين المكتشف من هذا المنجز تؤكدها الموجات المعاصرة المتعاقبة التي ما تزال تكتشف من هذا التراث ما هو جدير بأن يحتل مكانه اللائق في التاريخ العام للفلسفة، ومن المؤسف أن هذه الموجات في السياق الغربيّ أنشط وأكثر تفوقا من نظيراتها في السياق العربيّ.
عيني الثانية الناظرة إلى هذا التراث تقيس ما أٌنجز منه بما كان يمكن أن يُنجز، وهذا النظر ينتهي إلى القول بأن هذا التراث – بالرغم من كل إنجازاته عبر مسيرته الطويلة – لم يحقق ذاته بعد. لتتضح الصورة، لنلق نظرة على التقليد الفلسفي الغربيّ في مرحلتيه: ما قبل الميلاد (ذات المصادر الوثنيّة والأسطوريّة) وما بعد الميلاد (ذات المصادر الإبراهيميّة)، في المرحلتين شكلت عوامل مثل اللغة والدين والطقوس والمناخات الاجتماعية والسياسية المادة الخام التي عملت عليها العقول الفلسفيّة تكريرًا واشتقاقًا (وهذه الصلة بين المحيط والتفكير هي ما جعلت هايدغر في حواره الأخير مع مجلة دير شبيغل يشدد على استحالة نشأة تفكير أصيل إلا إذا اتصل بمحيطه). إذا تابعنا استخدام الاستعارة ذاتها، يمكن القول إن المادة الخام الهائلة في السياق العربي الإسلامي -لغويّة كانت أو دينيّة أو سياسيّة أو اجتماعيّة- لم تقابلها وفرة في التكرير والاشتقاق، إلى الحد الذي يمكننا معه القول إن اللغة والدين والخصوصيّات الزمانيّة والمكانيّة أهدرت فلسفيًّا في تراثنا. ثمة استثناءات طبعًا، ويمكن أن نضرب هنا مثالاً بابن سينا الذي أعده بحق أهم حدث فلسفيّ في تراثنا. ابن سينا هو أكثر من تحققت فيه شروط ثلاثة – شديدة الترابط فيما بينها- نجدها في كل الفلاسفة الاستثنائيّين وهي: القدرة الهائلة على التجريد، الوعي بموضوع الفلسفة وتاريخها، والاستقلال. ربما يشترك فلاسفة آخرون معه في الشرطين الأولين، ولكنّه يختص أكثر من غيره بانطباق الشرط الثالث عليه. استقلال ابن سينا تدرّج به من مرحلة التصرف في المادة الأرسطيّة إلى مرحلة الانقلاب عليها، على أن وفاته المبكرّة لم تسمح لهذا الانقلاب أن يكتمل وإن كان قد وضع خطوطه العريضة في المانفيستو الذي صدّر به كتابه (منطق المشرقييّن). هذا الاستقلال السينويّ هو ما استفز روح التلمذة الكامنة في ابن رشد، لذا لم يدخر النقد الرشديّ جهدًا في تبيان مخالفة ابن سينا لأرسطو. لم ينتبه ابن رشد إلى أن هذه المخالفة هي عينها ما مكّن ابن سينا أن يسم اجتهاده الفلسفي الهائل بأصالة لا مثيل لها، وهذه الأصالة بدورها مكنته من أن يصبح الفيلسوف الأكثر تأثيرًا فيمن جاء بعده من الفلاسفة والأكثر إبداعًا في إنتاج مفاهيم وحلول ومقترحات مستقاة من بيئتها العربية الإسلاميّة. أراد ابن رشد من ابن سينا أن يقول ما قاله أرسطو، وأراد ابن سينا لنفسه أن يفعل ما فعل أرسطو الذي إنما امتاز عن غيره بكونه خالقاً لموضوعه ولمادته مستقلاً عن أسلافه وأساتذته.
إذن، لا تفلسف بلا مصادر ذاتيّة للتفلسف، وإهمال هذه المصادر الخاصة هو ما أخّر تراثنا الفلسفيّ عن استثمار إمكاناته. على أنه من المهم جدًا هنا الإشارة إلى أنّ استثمار هذه المصادر الخاصة للتفلسف لا يعني التحرك بمفاهيمها يمنةً ويسرةً على طريقة (مع أو ضد)، وإنما يعني التحرك بمفاهيمها إلى الأعلى من خلال تحويلها إلى أفق للتفكير، ومسألة أفق التكفير هذه هي من دفعت بول ريكور لاعتبار نيتشة -في لفتة ذكيّة- فيلسوفًا مسيحيًّا بالرغم من عدائه الشهير للمسيحيّة.
– ما هو تقييمك لواقع التفلسف في العالم العربيّ اليوم؟ وكيف تعلّق على الاتجاهات المتنامية مؤخرًا حول ضرورة تدريس الفلسفة في مدارسنا؟
التفلسف -بوصفه إضافةً لا اجترارًا- لا واقع له في العالم العربي اليوم. هذا الغياب الذي لا تفلت منه إلا استثناءات محدودة ليس سرًا، وهو يكاد يكون أوضح من أن يُشار إليه.
وبالنسبة لتدريس الفلسفة، فأنا مع كل المطالبات الساعية إلى إدراجها في المقررات المدرسيّة وأعتقد أن هذا الإدراج ستكون له فوائد لا حصر لها، في مقدمتها نزع هالة القداسة التي يحيط بها البعض الفلسفة بوصفها صندوق المفاتيح السحريّة لكل استعصاءات الواقع وانسداداته، فهذه الهالة هي في حد ذاتها نتيجة جانبيّة من نتائج غياب الفلسفة عن المقررات الدراسيّة.
– ماذا تقرأ هذه الأيام؟ وما هي أهم الكتب التي قرأتها مؤخرا؟
بين يديّ هذه الأيام كتاب عنوانه (السبت) لأبراهام جوشوا هيشيل، وهو كتاب توخّى صاحبه أن يقدّم معالجة معاصرة لمعنى الوقت من وجهة نظر التقليد اليهوديّ.
العالق في ذاكراتي من آخر القراءات هي هذه الكتب: الشعر: بالحديث عن شيفا لأربعة رهبان هنود من القرن العاشر. اللغة: لسان العرب لابن منظور، موسوعة أصول الكلمات والتعبيرات الإنجليزية لروبرت هاندريكسن. الفيزياء: الكون الأنيق براين غرين، سبعة دروس موجزة في الفيزياء لكارلو روفيلي. الفلسفة: الكتابات الفلسفيّة لايبنتز، في الزمان والكينونة هايدغر. السير: السيرة الذاتية لداروين، ذكريات وأحلام وتأملات لكارل يونغ، النظريّة: الماركسيّة والأدب ريموند وليامز، الأدب: شرح الخطيب التبريزيّ على أبي تمّام، محاورات غوتة لإيكرمان.