لوحات من الفلسفة الوجودية: إضاءة على أبرز مفاهيم ومقولات الوجود | أوس حسن
إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...
في عام 1847، توصل إجناز سيميلويس، الذي كان آنذاك مساعد طبيب بسيط في أكبر عيادة توليد في العالم، إلى اكتشاف كان من شأنه إنقاذ حياة عدد لا يحصى من النساء؛ فعندما أصيب أحد زملاء سيميلويس بجرح وخزي أثناء تشريح جثة امرأة ماتت بحمى النفاس، وهي الحمى التي تسببها العدوى بعد الولادة، ثم توفي بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض ذاته، خطرت له فكرة ملهمة، حيث أدرك سيميلويس أن طلاب الطب الذين كانوا يأتون مباشرة إلى جناح الولادة بعد عملهم في تشريح الجثث كانوا على الأرجح ينقلون «مادة من الجثث» إلى النساء الحوامل. وكان هذا قبل أن تظهر ممارسات التطهير والتعقيم واكتشاف نظرية جرثومية المرض، وقبل تبني إجراءات الغسل الروتيني لليدين وتعقيم الأدوات الطبية. وعلى سبيل الاختبار أمر سيميلويس الطلاب بغسل أيديهم بالماء المعالج بالكلور قبل إجراء عمليات التسليم، فانخفض معدل وفيات النساء
وإذا عدنا إلى حالة الطب في زمن سيميلويس، أي في «العصور المظلمة» قبل العلمية في القرن التاسع عشر، فإننا نجد تشابهًا لافتًا للنظر بينها وبين حالة العلوم الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين (ونعني بها الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ والعلوم السياسية)، فقد كانت المعارف والإجراءات الطبية تستند إلى الحكمة الشعبية والحدس والعادات، كما كانت التجارب قليلة. وعندما كانت تظهر إحدى النظريات، كان يكفي النظر فيما إذا كانت «منطقية» أم لا حتى يتم تبنيها، حتى إذا لم تكن هناك أدلة تجريبية تدعمها. بل كانت أي محاولة لجمع الأدلة بغرض اختبار صحة النظرية تتعارض مع الاعتقاد بأن الممارسين الطبيين يعرفون مسبقًا أسباب معظم الأمراض. وعلى الرغم من الجهل المروِّع والممارسات المتخلفة في الطب على مدار جُل تاريخه، كانت هناك دائمًا وفرة من النظريات، ونادرًا ما توضع على محك الاختبار أو يعترض عليها.
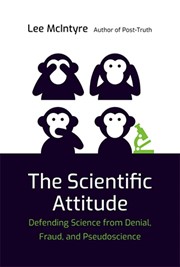
هذا المقال مقتبس من كتاب لي ماكنتاير «الموقف العلمي: الدفاع عن العلم ضد الإنكار والاحتيال والعلم الزائف»
وما يزال قدر كبير من الأبحاث الاجتماعية في يومنا هذا يفتقر إلى كثير من الدقة، والأمر هنا لا يقتصر على فقر المناهج أحيانًا، بل الأسوأ من ذلك هو العقلية غير التجريبية المبنية عليها؛ فالعديد من الدراسات العلمية المزعومة حول الهجرة والأسلحة وعقوبة الإعدام وغيرها من الموضوعات الاجتماعية المهمة تتأثر بالآراء السياسية أو الأيديولوجية للباحثين فيها، ولذلك فإنه من المتوقع جدًا أن يتوصل بعض الباحثين إلى نتائج تتفق تمامًا مع المعتقدات السياسية الليبرالية، بينما يتوصل آخرون إلى نتائج محافظة تتعارض بشكل مباشر مع تلك النتائج الأولى. وخير مثال على هذا هو السؤال عما إذا كان المهاجرون «يتحملون أعباء حياتهم بأنفسهم» أم أنهم يُشكلون «عبئًا خالصًا» على الاقتصاد الأمريكي؛ فإذا كان الباحثون يتناولون سؤالًا كهذا بمنهجية تجريبية حقيقية، لماذا إذن تتباين نتائج الدراسات؟ من المفترض أن هذه دراسات اجتماعية علمية دقيقة يُجريها باحثون مرموقون، بيد أن النتائج التي يتوصلون إليها بشأن مسائل واقعية تتناقض تناقضًا تامًا مع بعضها بعضًا. ولكن هذا الأمر غير مقبول في الفيزياء مثلًا، فلماذا يتم قبوله في علم الاجتماع؟
ولكن مثل هذه الأسئلة قابلة للدراسة التجريبية ويمكن أن تدرسها العلوم الاجتماعية على نَحْو عِلْمي، إذ ثمة إجابات صحيحة وخاطئة لأسئلتنا حول السلوك البشري؛ فهل يعاني البشر من «تأثير النتائج العكسية» عندما يجدون أدلة تتعارض مع رأيهم في سؤال تجريبي (وليس سؤالًا معياريًا) من قبيل «ما إذا كانت العراق تملك أسلحة دمار شامل» أو «ما إذا كان الرئيس جورج دبليو بوش قد فرض حظرًا كاملًا على أبحاث الخلايا الجذعية»؟ وهل يوجد شيء اسمه التحيز الضمني؟ وإذا كان هذا التحيز موجودًا، فكيف يمكن قياسه؟ إن هذه الأسئلة قابلة للدراسة بطريقة علمية، بل وقد درست كذلك. وعلى الرغم من أن الباحثين في العلوم الاجتماعية قد يواصلون اختلافهم (وهذا في الواقع علامة صحية في البحوث الجارية)، فإنه ينبغي لاختلافاتهم أن تدور حول تحديد أفضل الطرق لبحث هذه الأسئلة، وليس فيما لو كانت الإجابات الناتجة عن البحث مقبولة سياسيًا؛ ذلك لأن تبني الموقف العلمي تجاه الأدلة – أي الرغبة في تغيير النظريات على أساس النتائج الجديدة – هو أمر ضروري تمامًا في دراسة السلوك البشري كما هو الحال في دراسة موضوعات الطبيعة.
وعندما يفشل تكرار العديد من الدراسات، أو عندما تتباين استنتاجات تلك الدراسات استنادًا إلى نفس مجموعة الوقائع، فإن ذلك لا يعزز الثقة في العلوم الاجتماعية. وسواء كان هذا بسبب قصور في المنهجية أو بسبب عدوى أيديولوجية أو لمشاكل أخرى، ستكون النتيجة هي أنه حتى لو كانت هناك إجابات صحيحة وخاطئة للعديد من أسئلتنا حول الفعل البشري فإن معظم الباحثين في العلوم الاجتماعية ليسوا بعد في وضع يؤهلهم للعثور على تلك الإجابات. ولا يعني ذلك أنه لا يوجد في العلوم الاجتماعية أعمالًا دقيقة كما ينبغي، بل يعني أنه عندما لا يكون صانعو السياسات البحثية (وحتى غيرهم من الباحثين أحيانًا) متأكدين من ماهية النتائج التي يمكن الوثوق بها، فإن ذلك يؤدي إلى الحط من مكانة المجال بأكمله. فإذا كان الطب قد استطاع أن يطوي صفحة ماضيه البدائي، فلماذا لا يكون المسار نفسه متاحًا أمام العلوم الاجتماعية؟
لقد ظل الكثير من المتخصصين في العلوم الاجتماعية يدعون لسنوات طويلة أنهم إذا تمكنوا من محاكاة «الطريقة العلمية» المتبعة في العلوم الطبيعية، فستزداد علمية العلوم الاجتماعية. بيد أن هذه الوصفة البسيطة تواجه العديد من المشاكل، ومن بين تلك المشاكل التي تعاني منها البحوث المعاصرة في العلوم الاجتماعية:
كيف إذن يبدو المثال الذي يحتذى به في البحث العلمي في العلوم الاجتماعية؛ أي العمل الذي يرتكز بقوة على الموقف العلمي، ويستخدم الأدلة التجريبية لاختبار فرضية نظرية بديهية، ويستخدم طرقًا تجريبية لقياس الدافع البشري مباشرة من خلال الفعل البشري؟ إذا أردنا مثالًا على ذلك لن نجد أفضل من البحث الذي قامت به شـينا إينغـار حول مفارقة الاختيار، ففي هذه الحالة نجد أمامنا معضلة علمية اجتماعية تقليدية، وهي: كيف يمكن قياس شيء غير محدد المعالم مثل «الدافع البشري» استنادًا إلى أدلة تجريبية؟ ترى المدرسة الكلاسيكية الجديدة في الاقتصاد أننا نقيس رغبة المستهلك مباشرةً من خلال سلوك السوق، حيث يشتري الناس ما يريدونه ويكون السعر هو انعكاس لقيمة السلعة؛ غير أنه لكي تتم الحسابات الرياضية بشكل سليم فإنه يلزم وجود بضع «افتراضات تبسيطية».
ويمكن عرض تلك الافتراضات كما يلي: أولًا، نحن نفترض أن تفضيلاتنا منطقية؛ فإذا كنت أحب فطيرة الكرز أكثر من فطيرة التفاح، وأحب التفاح أكثر من التوت الأزرق، فمن المفترض أنني أحب الكرز أكثر من التوت الأزرق. (للمزيد حول الافتراضات التقليدية التي وضعها الاقتصاديون وغيرهم حول العقلانية البشرية، وكيف تنهار تلك الافتراضات في مواجهة الأدلة التجريبية، راجع كتاب دانيال كانيمان «التفكير السريع والبطيء»). ثانيًا، نحن نفترض أن المستهلكين لديهم معلومات كاملة حول الأسعار، وعلى الرغم من أنه من المعروف جدًا أن هذا الافتراض لا ينطبق في الحالات الفردية، إلا أنه افتراض أساسي في المدرسة الكلاسيكية الجديدة في الاقتصاد كونه ضروري في شرح كيفية أداء السوق ككل لتلك المهمة السحرية المتمثلة في ترتيب تفضيلات المستهلك من خلال الأسعار. وعلى الرغم من الاعتراف بأن المستهلكين الفعليين قد يرتكبون «أخطاء» عندما قيامهم بالتسوق (لأن المستهلك مثلًا لم يكن يعرف أن هناك تخفيض على فطيرة الكرز في سوق آخر قريب)، فإن صلاحية النموذج تظل قائمة لأن المستهلك لو كان يعرف بشأن ذلك التخفيض لغيَّر سلوكه. وأخيرًا، يفترض نموذج الاقتصاد الكلاسيكي الجديد أن «المزيد أفضل»، وهذا لا يعني أنه لا يوجد ما يسمى تناقص المنفعة الحدية – ومثال ذلك أن مذاق اللقمة الأخيرة من فطيرة الكرز على الأرجح لن يكون بجودة مذاق اللقمةِ الأولى – بل يعني أن الأفضل بالنسبة للمستهلكين أن يتوافر أمامهم المزيد من الخيارات في السوق، لأن هذه هي الطريقة التي يمكن بها زيادة تفضيلات الشخص إلى أقصى حد.

الباحثة في العلوم الاجتماعية شيينا إينغـار تقول «إننا نختار ألا نختار حتى عندما يتعارض ذلك مع مصالحنا الشخصية».
لقد أرادت شـيينا إينغـار في دراستها أن تختبر هذا الافتراض الأخير مباشرةً من خلال التجربة. وما هو على المحك هنا أمر جلل، لأنها لو تمكنت من إثبات خطأ هذا الافتراض التبسيطي فسوف تُعرِّض نموذج الاقتصاد الكلاسيكي الجديد ذاته للخطر، إذا ما وضعنا في الحسبان أيضًا ما توصلت إليه أبحاث عالم الاقتصاد هربرت سيمون الذي قوض افتراض «المعلومات الكاملة». ولهذا الغرض، أجرت إينغـار وزميلها مارك ليبر تجربة مضبوطة لمراقبة اختيار المستهلك في محل بقالة؛ حيث أتيحت للمتسوقين فرصة تذوق أنواع مختلفة من المربى. وفي الحالة الضابطة، أتاحت للمتسوقين فرصة تذوق أربعة وعشرين خيارًا مختلفًا. وفي الحالة التجريبية، تم تقليل الخيارات إلى ستة خيارات فقط. ولضمان وجود متسوقين مختلفين في الحالتين، كانا يقومان بتدوير المعروضات كل ساعتين كما كانا يضعان ضوابط علمية أخرى. ولقد كان إينغـار وليبر يريدان قياس شيئين: (1) عدد نكهات المربى المختلفة التي اختار المتسوقون تذوقها، و(2) مقدار المربى الإجمالي الذي اشتراه المتسوقون بالفعل قبل الخروج من المتجر. ولقياس الأمر الثاني، تم منح كل من توقف للتذوق قسيمة مشفرة، بحيث يمكن للقائمين بالتجربة تتبع ما إذا كان عدد المربات في رف العرض قد أثر على السلوك الشرائي لاحقًا أم لا، وهو ما لم يحدث فعلًا؛ فعلى الرغم من أن العرض الأولي لأربعة وعشرين مربى قد اجتذب اهتمام عدد من الزبائن أكبر قليلًا، إلا أن سلوكهم الشرائي اللاحق كان منخفضًا جدًا عند مقارنته بالسلوك الشرائي لأولئك الذين زاروا العرض الذي قدم 6 مربات فقط. وعلى الرغم من أن العرضين قد اجتذبا عددين متساويين من متذوقي المربى (وهو ما يستبعد أن يكون التذوق متغير سببي لتفسير التباين)، فقد استخدم المتسوقون الذين زاروا العرض الأول (24 نوع من المربى) الكوبونات الخاصة بهم في ثلاثة بالمائة فقط من الحالات، في حين أن أولئك الذين زاروا العرض الآخر (6 أنواع من المربى) قد استخدموا الكوبونات الخاصة بهم في ثلاثين بالمائة من الحالات.
بمَ قد نفسر هذا السلوك؟ ذهب الباحثان في تحليلهما إلى أن عدد المربات في الحالة الأولى ربما يكون قد أربك المتسوقين، فحتى عندما كان المتسوق يتذوق عدد قليل من المربات، كان يرى أن هذه نسبة صغيرة من إجمالي المربات الموجودة في العرض بحيث لا يمكنه التأكد من اختياره للمربى الأفضل، ومن ثم يختار ألا يشتري أي منها على الإطلاق. ولكن في الحالة الثانية ربما يكون المتسوق أكثر قدرة ورشادة في الاختيار بناءً على تذوق عينة أكبر نسبيًا. وهكذا يتضح أن الناس يريدون الاختيار من بين خيارات أقل، إذ كشف سلوك المتسوقين حقيقة مفاجئة حول الدوافع البشرية، وإن لم يكونوا يدركون ذلك.
وعلى الرغم من أن هذه التجربة قد تبدو بسيطة، إلا أن لها آثارًا بعيدة المدى؛ فقد كان أحد أهم التطبيقات المباشرة للاستنتاج الذي توصل إليه إينغار وليبر هو حل لمشكلة نقص التوفير في خطط التقاعد المسماة 401k (وهي خطة يضعها صاحب العمل في الولايات المتحدة تمكّن الموظف المؤهل من المساهمة بمبلغ معين من راتبه أو من حساب التقاعد الخاص به قبل خصم الضريبة)، حيث يحتار الموظفون الجدد عادةً أمام الخيارات الكثيرة المتاحة أمامهم لاستثمار أموالهم، وبالتالي يختارون تأجيل القرار، وهو ما يعني فعليًا اختيار عدم استثمار أي أموال على الإطلاق. إذن تلك التجربة لم تكن مثالًا للعلم الاجتماعي الجيد فحسب، بل كان تأثيرها الإيجابي على حياة الإنسان كان كبيرًا.
والشاهد من ذلك هنا هو أنه حتى في المواقف المألوفة لنا – وهو في هذا الحالة الرغبة والتفضيل البشريين – فإننا يمكن أن نخطئ بشأن ما يؤثر على سلوكنا؛ فلو أنك سألت الناس عما إذا كانوا يريدون الاختيار بين خيارات أكثر أو أقل، سيقول معظمهم إنهم يريدون خيارات أكثر، ولكن سلوكهم الفعلي يُكذِّب ذلك. وهكذا يمكن أن نتفاجأ بنتائج الأدلة التجريبية عند دراسة الفعل البشري، ذلك لأنه حتى المفاهيم التي تبدو نوعية (qualitative) -مثل الرغبة والدافع والاختيار البشري- يمكن قياسها بالتجريب وليس بمجرد الحدس أو النظرية أو التقرير الشفهي.
وهنا نتذكر سيميلويس مرة أخرى، فكيف لنا أن نعرف ما هو الصحيح قبل أن نجري تجربة؟ ربما يبدو حدسنا راسخًا محكمًا، لكن التجربة السابقة تثبت أن الحدس يمكن أن يخذلنا. وينطبق هذا في العلوم الاجتماعية كما ينطبق في الطب، إذ يمكن أن يكون الوصول إلى حقائق حول السلوك البشري مفيدًا في وضع السياسات العامة كما هو الحال في تشخيص الأمراض البشرية وعلاجها. وبالتالي، تجب التوصية بتبني الموقف العلمي في العلوم الاجتماعية بالضبط مثلما يتم تبنيه في دراسة أي موضوع تجريبي. وإذا كنا نهتم بالأدلة ونرغب في أن نغير رأينا حول نظرية ما بناء على الدليل، فهل نجد أمامنا مثالًا أفضل من نجاح تجربة إينغـار وليبر؟ وإذا كان لويس باستير قد تمكن عبر نموذجه التجريبي الدقيق من تفنيد فكرة التوالد الذاتي (spontaneous generation) التي عفا عليها الزمن، فهل يمكن للاقتصاد الآن المضي قدمًا بعد أن أدرك تأثير التحيز الإدراكي واللاعقلانية على الاختيار البشري؟
لقد كانت سمعة الطب متدنية في زمن ما ولكنه خرج من «عصوره المظلمة» قبل العلمية بفضل فتوح علمية فردية أصبحت معيارًا للممارسة الطبية الجماعية مقترنةً بوضع معايير لما يمكن اعتباره أدلة. وفي المقابل، لم تستكمل العلوم الاجتماعية بعدُ ثورتها لتعتمد على الأدلة اعتمادًا كاملًا؛ إذ إنه يمكننا العثور اليوم على بعض الأمثلة على الموقف العلمي في الأبحاث الاجتماعية التي حققت بعض النجاح – فدراسة إينغـار ليست الوحيدة في هذا السياق – ولكن لم يكن هناك قبول عام على مستوى العلوم الاجتماعية للفكرة التي ترى ضرورة دراسة السلوك البشري في ضوء نظريات وتفسيرات يتم اختبارها باستمرار في ضوء ما تثبته التجربة والملاحظة، إذ يعتمد قدر كبير من العلوم الاجتماعية اليوم على الأيديولوجيا والحدس والتخمين كما كان الحال في الطب في المرحلة قبل العلمية.
ويتشابه الطب في موضوعه مع العلوم الاجتماعية من نواحِ عدة، إذ لدينا في الطب قيم ثابتة توجه بحثنا بالضرورة، فنحن نفضل الحياة على الموت ونفضل الصحة على المرض ولا يمكننا أن نتبنى موقف «اللامبالاة» الذي يتبناه العالِم الذي لا يهتم في بحثه سوي بإيجاد الإجابات الصحيحة. بل يصبو علماء الطب بشدة إلى نجاح بعض النظريات لأن حياة البشر ذاتها هي التي تكون على المحك. ولكن كيف يتعاملون مع هذا الأمر؟ إنهم لا يكتفون برفع أيديهم والاعتراف بالهزيمة، بل يعتمدون على الممارسات العلمية الوجيهة مثل التجارب السريرية العشوائية مزدوجة التعمية، ومراجعة الأقران، والإفصاح عن تضارب المصالح؛ فعلى سبيل المثال، نعرف أن تأثير الدواء الوهمي حقيقي لكل من المرضى وأطبائهم على حد سواء؛ فإذا أراد الطبيب أن ينجح الدواء، ربما يستخدم مهارته للتأثير على المريض ليعتقد بأنه دواء فعال. ولكن ما الفائدة من هذا؟ إن الباحثين الطبيين يدركون عند تعاملهم مع الأمور الواقعية أن تأثير توقعاتهم على نتائج أبحاثهم لا يقل سوءًا عن التلاعب بهذه النتائج، لذلك يحتاطون من غرور الظن بأنهم يعرفون الإجابة بالفعل بأن يضعوا ضمانات منهجية لبحثهم، وهكذا يحمون العلم الذي يهمهم من خطر التحيز.
إن مجرد حضور القيم أو اهتمام المرء بماهية ما يدرسه لا ينال من إمكانية بناء العلم، إذ يظل بإمكاننا التعلم من التجربة حتى لو كنا نأمل أملًا كاملًا في فعالية دواء ما أو صدق نظرية ما، طالما أننا لا ندع هذا الأمل يُعيق الممارسات العلمية الوجيهة، ويظل بإمكاننا تبني الموقف العلمي، حتى في ظل حضور قيم أخرى قد توجد بجانبه. بل أنه تحديدًا لما أدرك الباحثون الطبيون والأطباء أنهم قد يتحيزون، فقد سنوا أنواعًا من الممارسات الطبية التي تتوافق مع الموقف العلمي، وهم بذلك لا يرغبون في التوقف عن الاهتمام بحياة البشر بل يريدون فحسب أن ينتجوا علمًا أفضل حتى يتمكنوا من تعزيز الصحة والتغلب على المرض. وفي الواقع، إذا كنا مهتمين حقًا بنتائج العلوم الاجتماعية في حياة البشر، فمن الأفضل لنا أن نتعلم من التجربة كما ثبت لنا بوضوح من تاريخ الطب، إذ لن يمكننا أن ننتج علمًا أفضل إلا عندما نتخذ خطوات للحفاظ على موضوعيتنا بدلًا من التظاهر بأن ذلك ليس أمرًا ضروريًا أو أنه مستحيل.
والعلوم الاجتماعية هي علوم ذاتية شأنها شأن الطب، ولكنها أيضًا علوم معيارية، فنحن نهتم بمعرفة الكيفية التي تسير بها الأمور، ولكننا نهتم أيضًا باستخدام هذه المعرفة لتسيير الأمور بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليها في رأينا؛ فنحن مثلًا ندرس السلوك الانتخابي بغرض الحفاظ على القيم الديمقراطية، وندرس العلاقة بين التضخم والبطالة بغرض التخفيف من آثار الركود القادم. ومع ذلك، وعلى عكس الطب، لم يُثبت علماء الاجتماع حتى الآن فعالية كبيرة في إيجاد طريقة لعزل البحث البناء عن التوقعات المعيارية، مما يُسبب مشكلة أخرى وهي أننا قد ننزلق إلى الانحياز التأكيدي والتفكير بالتمني بدلًا من أن نكتسب المعرفة الموضوعية. وهذا هو العائق الحقيقي أمام تحسين حال العلوم الاجتماعية. إن الأمر هنا لا يتعلق بعدم فعالية الأدوات أو بكون الموضوعات عصية على البحث، بل هو أننا لا نحترم جهلنا كما ينبغي للحفاظ على الأمانة العلمية عبر المقارنة المستمرة بين أفكارنا، والبيانات التي نتوصل إليها. وهكذا يكون التحدي في العلوم الاجتماعية هو إيجاد طريقة للحفاظ على قيمنا دون أن نسمح لها بالتدخل في البحث التجريبي؛ فلكي نغير العالم يلزمنا أولًا أن نفهمه.
صورة العرض: إجناز فيليب سيميلويس. صورة لإفريز موجود في متحف الصحة الاجتماعية في بودابست. المصدر: Wellcome Library
لي ماكنتاير: باحث في مركز فلسفة وتاريخ العلوم بجامعة بوسطن. مؤلف للعديد من الكتب، بما في ذلك كتاب «العصور المظلمة: حجة لعلم السلوك البشري» (Dark Ages: The Case for a Science of Human Behavior)، وكتاب «الموقف العلمي: الدفاع عن العلم ضد الإنكار والاحتيال والعلم الزائف» (The Scientific Attitude: Defending Science from Denial, Fraud, and Pseudoscience) وكتاب «ما بعد الحقيقة» ( Post-Truth).
المصدر (ضمن اتفاقية ترجمة خاصة بمنصة معنى)
إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...
رأى الطيار كينيث أرنولد، في 24 يونيو 1947م، تسعة أجسام هلالية الشكل تحلق بالقرب من جبل رينييه في ولاية...
ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...
يدعونا جون بول سارتر في رائعته «الكينونة والعدم» -التي كُتبت خلال الاحتلال النّازيّ لفرنسا- إلى تخيّل مشهدٍ من الحياة اليوميّة:...
«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.