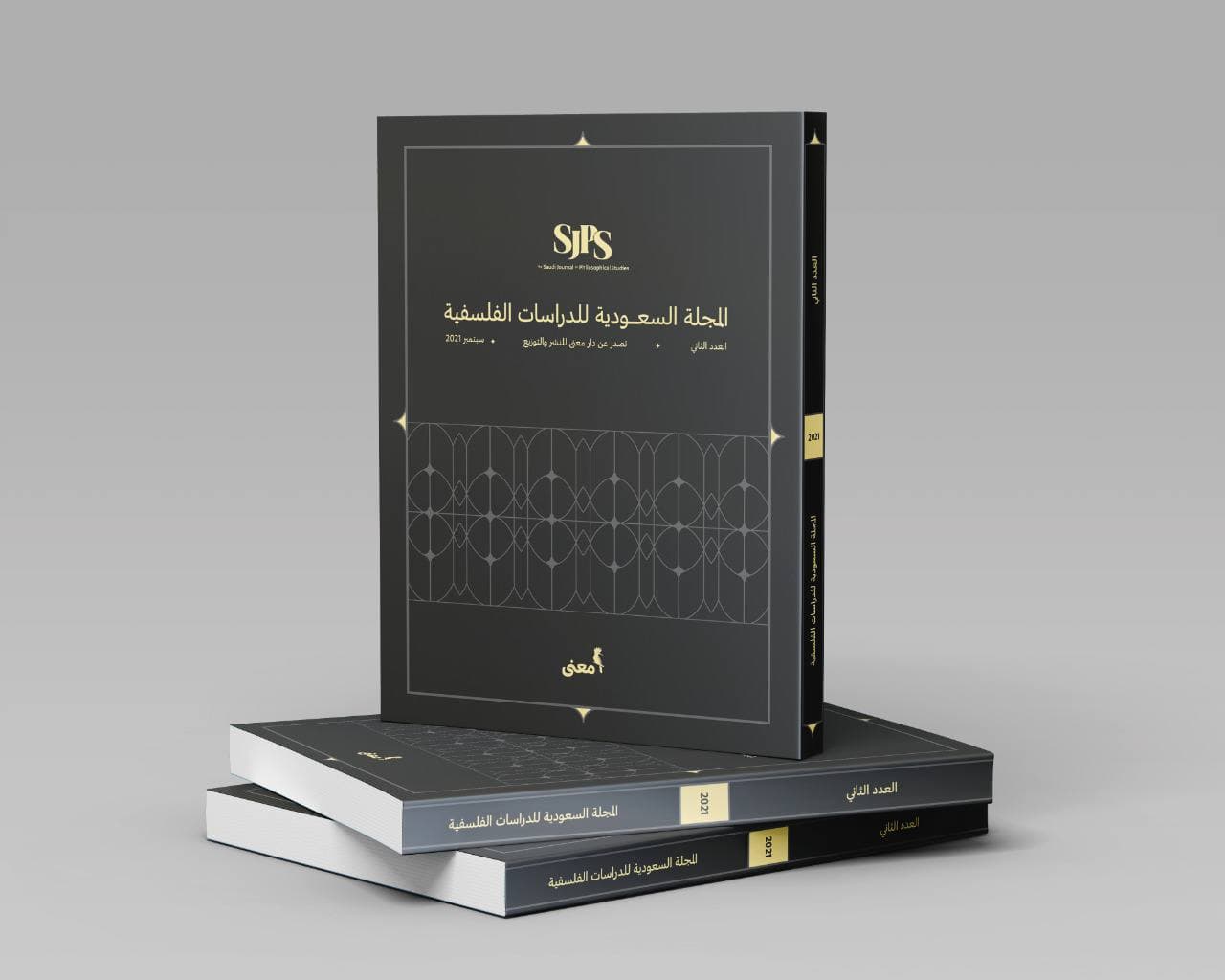يسرّ منصة معنى أن تعلن عن صدور العدد الثاني من المجلة السعودية للدراسات الفلسفية SJPS.
المجلة السعودية للدراسات الفلسفية
العدد الثاني – سبتمبر 2021
عدد الصفحات: 223
المحتويات
افتتاحية العدد | سارة الراجحي (رئيس التحرير)
ص 13 – 14
دراسات
المعرفة والفكر والوعي: دراسة في فلسفة الثقافة | عبد الرحمن طعمة
ص 17 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]
شَكّلَت الدراسات اللسانية والفلسفية الخاصة ببحث العَلاقة المُعقدة بين الفكر واللغة والوعي والثقافة كَمًّا يفوق الحصر من المعرفة المتراكمة على مرّ القرون. والباحث الفاحص يستطيع أنْ يرصد -بقَدر الاستطاعة- أهمّ الملامح العامة التي يمكن من خلالها إيجاد أبرز المُرتكزات التي تتأسّسُ عليها فلسفة الثقافة للإنسان المعاصر. وهذه الدراسة تمتاح من اتجاهات علمية وفلسفية مختلفة، لأجل تحصيل الأفكار ذات البُعد البينيّ فيما يتعلّق بهذه المسألة. أعني العلاقة المتداخلة والشائكة بين المعرفة والفكر والوعي، ودورها في تشييد البنية العامة للتفكير في عصر إنسان الثقافة، وقرن الوعي الكونيّ بامتياز.
وانقسمت الدراسة إلى مقدمة وأربعة مطالب أو مباحث، حاولنا من خلالها تقديم رؤية واضحة حول أبرز مراحل التطور الإبستمولوجيّ للفكر الإنسانيّ، وصولًا إلى المرحلة الثقافية الراهنة. وانتهينا بمجموعة من النتائج والملاحظات، التي يمكن من خلالها استكمال البحث في هذه الأطروحة المهمة.
[/bg_collapse]
«تهافت التهافت» في ضوء «علم ما بعد الطبيعة»: في ميلاد الأنطولوجيا | يوسف بن عدي
ص 35 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]سأحاول في هذا البحث تحليل فكرة الأنطولوجيا من خلال أفقين متشابكين هما: «تهافت التهافت» و«تفسير ما بعد الطبيعة» لأبي الوليد بن رشد. ويتمثل الهدف الفلسفي هنا في اقتفاء الرابط الوثيق بين البرهان والأنطولوجيا؛ يعني كيف أنَّ التفكير في مبادئ العقل والعلم أدَّى إلى تأسيس مفهوم الوجود والواحد. لكننا نجد أنفسنا أمام خطاب لاهوتي-ثيولوجي داخل البنية الأنطولوجية ما يجعل الأمر صعبًا في عملية القراءة والتفسير. تنقسم هذه الورقة إلى ثلاثة أجزاء رئيسة. يتناول الجزء الأول مبادئ الأنطولوجيا في ضوء «التهافت»، أما الجزء الثاني فيتناول كتاب «الياء»، أما الجزء الثالث فيتناول كتاب «اللام» لتفسير طبيعة إدراك الذات الإلهية والطبيعية. فهذه جميعها مؤشرات واضحة على ميلاد الأنطولوجيا.[/bg_collapse]
تحوُّلات النَّماذج الأخلاقية: من التَّسامح إلى التّعارف | عبد الرزاق بلعقروز
ص 51 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]تهدف هذه الدراسة إلى فحص بعض النَّماذج المفاهيمية، مثل (التَّسامح، التَّواصل، الاعتراف، التَّعارف) التي تمَّ بناؤها واختيارها، لأجل تشخيص أمراض الحضارة الاجتماعية، والتَّحقيق في قوتها راهنًا، أي وزن قيمة هذه المقولات من حيث قدرتها على رسم معالم للإنسانية المعاصرة بالبيان والتَّحليل والنّقد. والبراديم الذي نعتمده لأجل ذلك هو بناء الإشكال التالي: إذا كانت أمراض الحضارة السَّائدة قد بسطت نفسها على ثقافة الإنسان؛ فكيف السَّبيل إلى دَفعها؟ هل يكفي إحياء قيمة التّسامح أو نشر أخلاقيات التّواصل أو بثّ أخلاق الاعتراف؟ أم أنَّ الأفق يتطلّب رؤية أخرى تستوعب أمراض الحضارة السَّائدة، وتُكاشف جُذورها الفلسفية والنَّفسية والأخلاقية، وتقترح ترياقًا أفضلَ لمجتمعات باتت مُتصادمة من حيث نواتها داخليًّا ومتصادمة من حيث أواصرها خارجيًّا كذلك؟[/bg_collapse]
تكوُّن المشروع السياسي في فكر نعوم تشومسكي | فريدة كافي
ص 65 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]
يُعدُّ نعوم تشومسكي من بين أهم المفكرين المعاصرين. نالَ شهرةً واسعةً مُنذُ بدايةِ أعماله في حقل اللسانيات، ووضعِه لنظرية النحو التوليدي التحويلي التي غيّرت مجرى الدرس اللغوي، لكن تشومسكي لم يمنعه اهتمامه باللغة من تكريس نشاطه الفكري لأهم القضايا السياسية الراهنة خاصة التي تتعلق بالتعليم والديمقراطية والحرية الإنسانية.
ومن الملاحَظ أن عمل تشومسكي اللغوي قد بدأ بنقده للاتجاهات اللسانية التي كانت سائدة قبله خاصة التجريبية، ليطور مفاهيم جديدة تتعلق بالبنى الفطرية الموروثة التي فسّر على أساسها العملية اللغوية، ليس هذا فحسب، بل يعتقد أن تلك البنى الفطرية مسؤولة عن النشاط الفكري والاجتماعي للإنسان، الأمر الذي جعله يدافع وبشدة عن الحُريّة الإنسانية كمُعطى طبيعي لا يقتضي وجود سلطة تُقيّده.
[/bg_collapse]
الزمانُ الموسيقيّ: دراسة مقارنة بين الزمان الموسيقيّ والزمان الطبيعي | كريم الصياد
ص 77 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]تناقش هذه الورقة عَلاقةَ الموسيقى بالزمان من منطلق فينومينولوجي-أنطولوجي. وأحاول هنا بلورة مفهوم «الزمان الموسيقيّ»، بناءً على فرضية، يتم اختبارها في البحث، أن الموسيقى مُنتِجَة لزمان مختلف عن الزمان الطبيعي، هو الزمان الطولي، في مقابل الزمان الدوري، الذي تحصيه حركات الأجرام السماوية. وتتعرض الورقة لمسار عَلاقة الزمان بالمكان من خلال استعراض أهم محطات فلسفة الزمان من أرسطو إلى آينشتاين ومنكاوسْكي؛ وذلك لِفَهم التبايُن بين الزمان الطبيعي، والزمان الموسيقيّ، مما يساعد على تطوير المفهوم الأخير. وتُختم الورقة بأهم النتائج النظرية، والتطبيقية، وأهمها «الموسيقى بما هي أنماط للصيرورة الخالصة» بما هي محاولة للوقوف على ماهية الموسيقى من خلال فلسفة الزمان.[/bg_collapse]
الفجوة الجيلية: مقاربة فلسفية اجتماعية | أسماء فؤاد
ص 101 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]في ضوء الاهتمام العالمي بدراسة الأجيال الناشئة «جيل Z»، ومع الإقرار المسبق بعدم معرفتنا بحجم التحوُّل الذي أحدثته الثورة التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة من تسارع التطور الجيلي وتأثيره على مسيرة التقدم المجتمعي والإنساني، تسعي الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل أساسي، يتمثل في: كيف دُرست الفروق بين الأجيال أو الفجوة الجيلية في الأدبيات الفلسفية الاجتماعية؟ تلك الفروق التي راجت في ستينيات القرن العشرين، وارتبطت بالاضطرابات الكبرى في أوروبا وأمريكا، وتصاعدت مع تمرد الشباب والحركات الشبابية وتغيرات الواقع آنذاك، ما ساهم في اعتماد المدخل المقارن الذي يأخذ في الاعتبار التأثير المتبادَل بين العوامل الديموغرافية والتاريخية وآثار المرحلة في فهم الخبرة المتميزة للجيل. اعتمدت الدراسة بصورة منهجية أدوات البحث الكيفي في مراجعة التراث البحثي المرتبط بدارسة الفجوة بين الأجيال Generational Gap. وقد جاء اختيار تلك الدراسات مستندًا إلى معيارين، هما: الانطلاق من الإسهامات الكلاسيكية في صياغة محددات للفروق بين الأجيال عند الفلاسفة والمفكرين القدماء. والثاني، يتمثل في الاهتمام بالتطورات المتلاحقة في الدراسات الجيلية كما جاءت في أطروحة الوحدة الجيلية للمفكر الألماني كارل مانهايم. ثمَّ الاهتمام بالفروق بين الأجيال في مرحلة الستينيات، إلى أن أخذت دراسة الفروق بين الأجيال وتيرة متسارعة في سياق التحولات الديموغرافية الراهنة والفجوة التكنولوجية الرقمية (مجتمع المعلومات الكوني). وجاءت القراءة النقدية لتلك الإسهامات في إطار ثلاثة مستويات للتحليل، تبدأ باستعراض الإسهامات الكلاسيكية، والدراسات المبكرة للفلاسفة والمفكرين القدماء، ويتمثل ذلك في إسهامات المدرسة الوضعية والرومانسية. ثم المستوى الثاني من التحليل يُلقي الضوء على التطورات المتلاحقة في الدراسات الجيلية. أما المستوى الثالث فقد تركّز التحليل فيه على فهم الفروق بين الأجيال في مجتمع المعلومات العالمي.[/bg_collapse]
روث باركان ماركوس وتأسيس النظرية الإشارية المعاصرة | عمرو أحمد السيد
ص 119 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]تُعدُّ النظرية الإشارية المعاصرة نقلة نوعية في تاريخ الفلسفة التحليلية؛ ونتيجة لارتباطها الوثيق بنظريتي المعنى والصدق أصبحت من أهم النظريات الرئيسة في المنطق وفلسفة اللغة على السواء، وقد نشأ سوء فهمٍ واسع بين المناطقة المعاصرين حول معرفة الأصول التاريخية لهذه النظرية. فبينما يعتقد كثيرٌ منهم أن «كريبكي Kripke» هو مؤسسها، يذهب آخرون إلى أن «ماركوس Marcus» هي أول مَن وضع الأفكار الرئيسة لهذه النظرية قبل «كريبكي» وغيره بعدة أعوام. ونحاول في هذه الدراسة بحث المسألة فنبدأ بعرض مفهوم الإشارة وأهم نظرياتها التقليدية، ثم الأفكار الدّالة التي سبقت بها «ماركوس» في تأسيس هذه النظرية.[/bg_collapse]
نصوص تأسيسية
دفاعٌ عن الحصرانيّة الدّينيّة | ألفين بلانتِنغا – ترجمة: جوزف بو شرعه
ص 139 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]عندما كنت خرّيجًا في جامعة ييل كان قسم الفلسفة فيها يفاخر بكونه قسمًا متنوّعًا، والحقّ أنّه كان فعلًا قسمًا متنوّعًا. إذ تجد فيه المثاليّينَ، والبراغماتيّينَ، والظّاهراتيّينَ، والوجوديّينَ، والوايتهيديّينَ، ومؤرّخي الفلسفة، والوضعيّينَ، كما تجد فيه ما يمكن وصفهم بأنّهم مراقبو السّاحة الفكريّة. لقد كان هذا الأمر في بعض نواحيه مدعاةً للفخر، حيث يستطيع الطّالب أنْ يعثر على تمثيلاتٍ حيّةٍ وحقيقيّةٍ للعديد من التّقاليد الفلسفيّة الأساسيّة. إنّما يملك هذا الأمر أثرًا جانبيًّا مؤسفًا وغير مقصودٍ: إذا طرح أحدهم سؤالًا فلسفيًّا داخل الصّف أو خارجه خصوصًا، فسيكون الجواب النّموذجيّ بعرض قائمةٍ ببعض الأجوبة المختلفة التي شهدها العالم، أي ثمّة الإجابة الأرسطية، والإجابة الوجوديّة، والإجابة الديكارتيّة، والإجابة الهايدغريّة. ولعلّك ستجد الإجابة البوذيّة، وهكذا دواليك. ولكنْ غالبًا ما قوبل سؤال «ما صحّة هذا الأمر؟» برفضٍ بوصفه سؤالًا ساذجًا. وهكذا لديك هذه الأجوبة المختلفة كلّها التي ناصرها أشخاصٌ ذوو مقدرةٍ فكريّةٍ عظيمةٍ وتفانٍ كبيرٍ للفلسفة؛ إذ تجد أمام كلّ حجّةٍ تدعم كلَّ موقفٍ من هذه المواقف حجّةً أخرى ضدّها. لذا أليس الافتراض القائل أنّ كون أحد هذه المواقف صحيحًا فيما يكون الآخر باطلًا هو افتراضٌ مفرطةٌ سذاجته أو لعلّه افتراضٌ اعتباطيٌّ؟ وحتّى لو كان ثمّة صحّةٌ في هذا الأمر، وهو ما سيشير إلى وجود موقفٍ فلسفيٍّ واحدٍ صحيحٍ فيما تكون المواقف الفلسفيّة الأخرى باطلةً، ألن يكون اعتناق موقفٍ واحدٍ بوصفه صحيحًا وإلحاق البطلان بالمواقف الأخرى هو مجرّد ضربٍ من الاعتباطيّة أمام هذه الوفرة من الخيارات المتاحة؟ كيف بإمكانك أنْ تعرف أيَّ موقفٍ منها هو الموقف الصّحيح؟[/bg_collapse]
الكُليَّات | فرانك رامزي- ترجمة ياسر بن عبدالرحمن البطي
ص 153 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]تهدِف هذه الورقة لمناقشة إمكانيةِ تقسيمِ الأشياء إلى صنفين رئيسَيْنِ: جزئيات وكليات. وهي قضية ناقشها برتراند راسل في ورقته المنشورة في منشورات مؤتمر الجمعية الأرسطية عام ١٩١١، وخلُص فيها إلى ضرورة هذا التقسيم بناء على حجتين شهيرتين دائمًا ما تُشهرَان ضد طريقتينِ معروفتينِ تنافيان هذا التقسيم. تقول الأولى بأن الكليات هي مجموعة من الجزئيات، وتقول الأخرى بأن الجزئيات هي مجموعة من الخصائص. ويبدو لي بأن هاتين الحجتين لا تجيبان بصورة كاملة على السؤال، فالحجة الأولى، المذكورة في كتاب «مشكلات الفلسفة»، رُفعت ضد المدرسة الاسمية [وهي مدرسة تنكر الكليّات وترجعها إلى مجرد أسماء وصور وإشارات ليست قارة في العقل ولا متحققة خارجه]، ذلك أن جملة مثل «هذا المحسوس أبيض» تتطلب وجودَ شيءٍ واحد يُمكن وصفه بالبياض أو المُشاكلة ولا يكون من نفس الصنف المنطقي له. أما الحجة الثانية التي قدمها بإيجاز ماكتيغارت في كتابه «طبيعة الوجود» فهي تُثبت بأن الإنسان لا يعرَّفُ بمجموع خصاله وصفاته. ومع أن الإنسان لا يُمكن أن يكون إحدى خصاله، لا يوجد سبب يمنع أن يكون الإنسان خصلةً لشيء آخر، وهذا عين ما ذهب إليه وايتهيد في وصفه للأشياء المادية بـ«الصفات الأرسطية الخالصة» [والصفة هنا يقصد بها الصفة اللغوية والوظيفة النحوية، كالاسم والفعل]. ولهذا فلا يُمكننا أن نعتبر هاتين الحجتين مانعتين لأي نقدٍ يُوجَّه لتقسيم الجزئيات والكليات.[/bg_collapse]
مقال تعريفي
فلسفة الدين «التحليلية» | جراهام أوبي – ترجمة: محمد حسين
Analytic’ Philosophy of Religion | Graham Oppy’
ص 163 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]أبدأ بنظرةٍ تاريخية سريعة حول فلسفة الدين «التحليلية»، ثم أنتقلُ إلى فحصٍ مُوجَزٍ لأنماط الأسئلة التي يطرحها فلاسفة الدين «التحليليون» فيما يتعلق باللغة الدينية، وميتافيزيقا الدين، وإبستمولوجيا الدين، وأكسيولوجيا الدين، وسياسات الدين، وتعريف «الدين». وأختم هذه الورقةَ بمناقشةٍ موجزةٍ للغاية للخصائص المحتملة لفلسفة الدين «التحليلية». وفي النهاية، هناك ملحقٌ مختصرٌ حولَ تناوُلِ فلسفة الدين «التحليلية» للإسلام والفلسفة العربية.[/bg_collapse]
مشروع بحثي
نظريات المفارقة في علم منطق القرن الرابع عشر: تحقيق النصوص المفتاحية وترجمتها | إعداد: ستيفن ريد – باربرا بارتوتشي – ترجمة: إبراهيم الكلثم
Theories of Paradox in Fourteenth-Century Logic: Edition and Translation of Key Texts | Stephen Read, Barbara Bartocci
ص 180 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]أدت المفارقات المنطقية دورًا محوريًا في تقدّم الأفكار الفلسفية على امتداد القرنين العشرين والحادي والعشرين، لا على نطاق فلسفات المنطق فحسب، بل حتى في فلسفة اللغة، والأبستمولوجيا، والميتافيزيقا، وكذلك الأخلاق، والفلسفة السياسية. إذْ لم يخب تأثيرها في هذين القرنين عما كان عليه في فلسفة أواخر العصور الوسطى، حيث كانت موضوع جانب عظيم من النقاشات، وقدحت شرار العديد من الأفكار الأصيلة، التي يحتمل أنها قد وصلت ذروتها في القرن الرابع عشر. وقد عرفنا جانبًا كبيرًا من نقاشات العصور الوسطى في الخمسين سنة الماضية من الأبحاث في كتابات جان بورديان، وتوماس برادواردن، وغيرهما. ومع ذلك، توجد رسائل أخرى لافتة للنظر لم تُحَقق بعد، لا يوجد كثير منها إلا في صورة مخطوطات معاصرة، كرسالة پول البُندقيّانيّ في القرن الرابع عشر عن المتعذرات، التي لخص فيها نظريات من سبقه، وبنى عليها حلولًا جمعها في رسالته الأخيرة التي وسمها بـ«لوجيكا ماغنا» (المنطق الكبير). وقد حُقِقَ من هذا السِفر الضخم سبع رسائل، ترجمت إلى الإنجليزية ما بين عامي 1978 و1991، ولكن رسالته في المتعذرات لم تكن بينها. يروم هذا المشروع البحثي تحقيق هذه الرسالة وترجمتها، وهي تشمل خمس عشرة نظرية أخرى يعارضها، ومن ثم يسهب في عرض نظريته، هذا بالإضافة إلى شرح لها، كما يروم المشروع تحقيق رسالتين غيرها وترجمتهما، وهاتان النظريتان لوالتر سيغريڤ، وجون دمبليتون، وقد دُوِّنتا في أكسفورد في الربع الثاني من القرن الرابع عشر. أشار إليهما پول وما تزالان غير محققتين مع أنهما تحتويان أفكارًا خصبة لحلول بديلة؛ إذْ قدّم الأول حلًا تقييديًا (restrictio)، بينما قدّم الثاني حلًا إبطاليًا (cassatio). سيمنحنا نشر هذه النصوص رؤيةً أعم عن حل المفارقات في القرن الرابع عشر، كما أنه سيضيء جانبًا من طبيعة المفارقات وحلولها المحتملة.[/bg_collapse]
مراجعات كتب
جيرالد كوهين «نظرية كارل ماركس في التاريخ: دفاع» (1978، 2000) | جورج توملينسون – ترجمة: مروان الرشيد
Review of G. A. Cohen, Karl Marx’s Theory of History: A Defence (1978, 2000)- George Tomlinson
ص 202 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]كتاب جيرالد كوهين «نظرية كارل ماركس في التاريخ: دفاع» (سندعوه من الآن فصاعدًا: «الكتاب») يجب أن يُضمَّن في أيِّ قائمة مختصرة للكتب العمدة في المادية التاريخية، بل في أيِّ قائمة للكتب العمدة في ماركس والماركسية عمومًا. الكتاب، الذي نُشِر في عام 1978، مشهورٌ لسببين أساسيين: الأول، أنه يشكِّل أول مواجهة وأهمها (حتى اليوم) بين الفلسفة التحليلية الأنجلو-أمريكية وماركس (وهو يمثِّل النص الأساس في الماركسية التحليلية). والثاني أنه يقدِّم ماديةً تاريخيةً «تقليدية» غير مُساوِمة، «حيث التاريخ -أساسًا- ينمو من القدرة الإنتاجية البشرية، وأنماط المجتمعات تنهض وتنهار وَفقًا لتمكينها أو تعويقها لهذا النمو». وكما يعرف كل قارئ للكتاب، تركيز كوهين مُنصبّ على التفريق بين قوى وعلاقات الإنتاج، ومِن ثَمَّ بين خصائص المجتمع المادية والاجتماعية (عند كوهين، المادية والاجتماعية من «المتضادات»). وما يهمّه، على الخصوص، هو غلبة قوى الإنتاج على علاقات الإنتاج، التي بموجبها القوى (الأسس المادية -لا سيَّما التقنية– للمجتمع) تحدِّد وظيفيًّا العلاقات (البنية الاقتصادية للمجتمع). وبإيجاز، هذه الديناميكية (وليس الديالكتيك، وهو أمر تتحاشاه الماركسية التحليلية) بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج تعطي التاريخ توجهه التقدُّمي وحركيته. هكذا نجدنا أمام نظريةٍ في التاريخ تستلهم مقدمة الكتاب الصادر في 1859 «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي»، لا كتاب «الأيديولوجيا الألمانية» ولا «البيان الشيوعي»، ونجد أنَّ نموذجها هو «القاعدة-البنية العلوية» وليس «الحاجة» أو «الصراع الطبقي».[/bg_collapse]
أشيل مبيمبي «الوحشية» | مصطفى عبد الظاهر
ص 212 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]في كتابهما «جدل التنوير» ذهب ثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر إلى أن مستقبل الحضارة الأوروبية التنويرية ينطوي على ارتداد ناحية البربرية. ومنذ ذلك الحين، طُرحت هذه الفكرة في الأوساط الفلسفية والسياسية والاجتماعية الغربية مرارًا وتكرارًا، بأشكال مختلفة، وبدرجات متفاوتة من الشدة. إن غالبية الأعمال الفلسفية النقدية الأوروبية التي صدرت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قد اتسمت بنوع من أنواع التشاؤم واليأس من الوعد بالتقدم، وانهالت ناقدة على التراث التنويري والحداثي، محملة إياهما ذنوب ملايين القتلى والدمار المعمم الذي خلّفته الحروب العالمية التي انطلقت من أوروبا. لكن قليلًا من هذه الأعمال، وربما يكون أقلها شهرة، هو الذي أرجع تشاؤمه ويأسه من المستقبل الأوروبي إلى الماضي الاستعماري والإمبريالي الغربي. لن تكون العدمية ههنا نتيجة للحرب الأوروبية -الأوروبية، بل نتيجة للعنف الإمبريالي الأوروبي تجاه المستعمرات الإفريقية والآسيوية واللاتينية. لقد ذهب هذا التيار، وعلى رأسه حنا أرنت وإرنست يونجر وجورج موس، إلى أن الخبرات التي اكتسبتها السياسات الأوروبية في القهر والقتل والتشريد والتعذيب والمراقبة والضبط، والتي اكتسبتها من تجربتها في إدارة المستعمرات، سترتد إلى الداخل الأوروبي، ولن تنتهي بانتهاء التجربة الإمبريالية العسكرية، بل ستتمدد هذه “الوحشية” إلى ضحايا جدد، وهذه المرة، ستكون الضحية أوروبا نفسها.[/bg_collapse]
In other languages
La valeur de la liberté | Manouby Ghabach
ص 214 | [bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”إظهار الملخص” collapse_text=”إخفاء الملخص” ]Le concept de liberté a fait l’objet de beaucoup de débats. Certes, on ne s’accorde point sur ni sa signification, ni sur sa portée, ni sur les limites de son application. Mais au niveau de la pensée morale et politique, elle est hautement estimée. La liberté constitue le point d’ancrage de différentes théories morales et politiques modernes. La modernité politique est considérée comme l’expression de l’émergence de la liberté universelle. Dès lors, mettre en question la priorité de la liberté peut apparaître une tâche inutile, une entreprise oisive. On entend par priorité de la liberté l’idée que la liberté est une valeur fondamentale qui n’est pas conditionnée par d’autres valeurs. Une telle idée peut être conçue dans le cadre d’un certain essentialisme moral. Mais on peut convenir que la liberté renvoie à un système de libertés propre à une communauté politique.[/bg_collapse]