الجذور الفلسفية للعلاج المعرفي السلوكي تعيننا على تفسير حدوده | من «سايكي»
لا تصنف كل المشاكل النفسية على أنها مشاكل في التفكير. إن محاولة علاجها بالوسيلة المعرفية فقط، عن طريق العلاج المعرفي...
توطئة
يتّكئ الشاعر ويعتزّ وينطلق من جاهليةٍ مثلت عبر القول، عبر القصيدة، حضارةً تتجذّر في تجربة الشاعر إلى حضارةٍ هي كل الجاهلية ضدّ الإنسان ، ضدّ الهويّة كما يحاول الشاعر كشفها ، فيدوّن خرائطه في هذا الديوان منذ:
«أنا طفلُ الخيول رضعتُ صوتًا
وما زال الضجيج الحُرّ وعدي».
إلى أن يُفصح عن نفسه علانيةً طوال رحلةٍ كان فيها الشاهد والمشهد:
«أأعيدُ تصهال الخيول أم الهنود
الحُمر يوجعها المجاز الأخطرُ؟!».
في محاولة استعادةٍ جامحة وجريئة لذاكرةٍ نراها عبر أسماء وأماكن تستحضر هويةً وروحًا تخشى وتتطلّع في آن.
على العتبات
من عنوان الديوان يرفع الشاعر راية الكلمات / اللغة / القول في مواجهة العالم، فهو الجاهليّ الجديد وهذه خطبته / كلماته. هذا الجاهلي الجديد طفلُ الخيول كما يسمّي نفسه في بداية رحلة الديوان، هذا الطفل الذي لا يملك سوى ما لا يقول، وهنا مفارقة هائلة يُعبّر عنها الشاعر في أكثر من موضع في الديوان، تشعر وأنت تقرأ الديوان أنّ ما يملكه الشاعر هو ما لم يقله؛ ما لم يقله، بصرف النظر عن الأسباب، يحاول الشاعر أن يحتفظ بهذه الملكية التي تجعل لوجوده معنى، إذْ يقول:
«ولم أفضحكَ يا قلبي ولكن
لأجلك أنتَ لم أبلُغ أشدّي».
يريد أن يقول، ويمتنع. لا يثق إلّا بالقصيدة؛ فيقول:
«أنا الرأي لكنّ القصيدة صعبةٌ
وقد نعتوني بالغويّ المجدّفِ».
والقصيدة دائمًا تجد لنفسها طريقةً في القول، لذا لا يخشى على ما يملك داخلها وبها ومعها، وإن كان تأويل مقصد الشاعر لا يؤمن، فيقول:
«بألسنةِ النَّار الفصيحة قال لي:
سيفضحني قَصدي وليس قصائدي».
القولُ حياة، الكلمةُ حياة، لكن هذه الحياة لا تسلَم من مجازفةٍ ما، إذْ يقول:
«يا لقومي سرقوا حتى فمي .. فبماذا يا ترى أعترفُ ؟!».
إلى قوله:
«ممكناتُ القول في بالِ الفتى .. لغةٌ تُوحَى ولا تكتشفُ».
يُعزّز هذا الشعور بأهمية أن تقول ولا تخشى شيئًا، لأنكَ في القول تحقّق معنى انتمائك وهويتك، يعزّز كلّ ذلك تلك الاقتباسات في بداية الديوان، منها على سبيل المثال:
«ولكنها نفسٌ كما شئت حُرّةً». وغيرها في نفس معناها.
هذا الجاهليّ الجديد/طفلُ الخيول، يريد أن يترك هنا – ومن خلال القصائد التي يثق بها أكثر من نفسه – معنىً يدلّ عليه ويستعيد به روحه التي أوشكت أن تضيع في الزحام.
أولًا: من حيث المعنى
فإذا حاولنا قراءة فهرس الديوان سنجد أن هذا الجاهليّ الجديد يقسّم الديوان إلى ثلاثة أقسام، تمثّل دوافع الشاعر وهجسه الجاهليّ، وهي كالتالي:
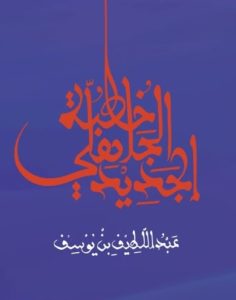
الأول: استهلالٌ خارج الطلَل
استهلالٌ ليس على الطلَل أو أمامه بل خارجه، لا طلَل إذن بل استعادة لما قبل الطلَل واحتفاء به. يحتوي على 50 صفحة من الديوان وهو أكبر أقسام الديوان، محوره الرئيس الذي يدور حوله هو: «الفخر». إنّ الشاعر في هذا القسم الاستهلالي يحاول أن يعرّف بنفسه، ويصنع شخصيته التي كادت أن تتشظى في مرايا لا نهائية؛ حيث يقول:
«إلى ما لا نهايات المرايا
إلى ما كان من قبلي وبعدي».
ويقول مؤكدًا:
«في الوحدةِ مرآةٌ تكثر منّي
وأنا لا أتكاثر إلّا في الوحدة».
إذن، «الفخر» هو الذي يحاول القسم الأول من الديوان إبرازه. وتحيل إليه كل نصوص هذا القسم بشكلٍ أو بآخر ومن زوايا نظرٍ مختلفة. بتتبعٍ بسيط ستجد الأنا طاغية في كثير من المواضع، إذْ يقول:
«فلستُ أنا من بادلَ النجم منزلًا»، و«أنا من رعى الأيام ..»، و«فهل أنا سوى الغول والعنقاء …»، و«أنا لستُ من أبناء يحيى بن خالد ..»، و«أنا كلّ من كانوا ومن قدرت لهم …»، و«جذبتُ أناي المستحيلة ..»، و«معلِّلتي بالهجر منذ أنا أنا …»، و«أنا ابن مفازات الغياب ..»، و«فهذا أنا وجه الغريب …»، و«إنّي أنا السّيل الذي بلغ الزُبى ..»، و«أنا لا أدوّن ما أراه …»، و«فأنا أفكر في القصيدة كلّما ….»، و«فأنا أنا من قال: ليس الوقت …»، و«وأنا كاللعنة المنتصفُ»، و«ضفتا نهر أنا وافترقا …»، و«أنا الهدنة عندي طلقة…».
احتشاد الأنا في هذا القسم لم يقتصر على الإفصاح المباشر بالأنا، بل تعدّاه إلى الإعلان عن الاسم؛ اسم الشاعر، أو استدعاء الجدّ أو القبيلة في أكثر من موضع ترسيخًا لتجذّرٍ ما في ظلّ التحجّر الذي سيهجوه لاحقًا؛ حيث يقول:
«فإن لم أقشّر جلدة الأرض راجلًا
فلستُ أنا عبد اللطيف بن يوسفِ».
ويقول:
«أبي جدي سلالاتي وشيء
خرافيّ يشد أبي وجديّ».
ويقول:
«ولكنَّني والحمد لله سيّد
وتدري تميم أنَّني سيف خندفِ».
ويقول:
«ككل تميميّ مواهبه طغت
ومن ألف عامٍ ليس تفنى مواهبه».
ويقول:
«منذ النهاية قال جدي: خذ يدي
واطعن بها واحطب بها أضلاعي».
ويكمل:
«أعلن هنا النَّار القديمة لا تخف
أو فاحترق كالسيف كالقعقاعِ.
وخذ الكتاب بقوةٍ لا بارك
الله الفتى إن لم يكن بشجاعِ».
هذه كلها ضمن وصايا النار القديمة / وصايا الجدّ.
ثمّ نجد منحى آخر، يحاول الشاعر من خلال تأكيد ذاته عبر احتفائه بتفرّده وحُرّيته وإيمانه بالقول / الشِّعر، كقوله:
«توزّعَ حتى سالَ في كلّ موقف»، و«ويمنعنا عن شكر مسعاه حاجبه»، و«يموت الشِّعر حين نحاسبه»، و«من ارتضى هامشًا يحيى بتهميشِ»، وغيرها في ذات المعنى كُثر.
الثاني: استدلال على ليلِ الجديلة
في هذا القسم من الديوان الذي يتجاوز 20 صفحة بقليل، يلمس القارئ أقصى تناقضٍ ممكن بين ما يُقال وما يضمر. وكان بالإمكان حمل هذا القسم على موضوع الغزل بناءً على ما سبقه من فخر، وما سيتلوه من هجاء، ولكنّ القارئ سيجد ما يمنعه من تأكيد ذلك، وإن كانت بعض المفردات توهم بذلك.
في اعتقادي أنّ هذا القسم تختلط فيه الرؤية بين القصيدة / وليلى «المحبوب المطلق»؛ حيث نلحظ طغيان اسم ليلى على هذا القسم، وبما أن الديوان مبنيّ على فكرة القول / الشِّعر، سنجد خلطًا هنا بين ليلى والقصيدة، وهذا ربما ما يفسّر أن الشاعر يضع نفسه تحت تصرّف ليلى، ثم يفخر بنفسه بين الطاعة والعصيان؛ هذا فعل الشِّعر، وربما فعل الحبّ أيضًا؛ إذْ يقول:
«خذيني ليرتاح التناقض بيننا
إذا ما تلاقى موحشٌ وجميلُ
خذيني لأمشي فوق ماء حقيقتي
خفيفًا ولكن المجاز ثقيلُ
وقولي عسى عبد اللطيف يمرّ بي
لينبت تحت الخطوتين نخيلُ».
فلا تدري هنا لمن الغلبة، ولا مَن الذي سيضيف الآخر!
في مواضع عديدة يتعمّد الشاعر إحداث لبسٍ ما بين ليلاه التي لم يكن قيسها المجنون، وبين المعنى والنصّ والتأويل، فيقول:
«يا اشتهائي القديم
يا ابنة معنىً غاب عنّي
وعاد لي عبقريًّا».
يأخذ الشاعر على عاتقه المعنى والنصّ والتأويل لهذا الشِّعرالقليل الذي يعيش به ويراهن عليه، فيقول:
«فلم يبقَ في الشِّعر القليل بقيةٌ
سوى أن يُقال الشِّعر فيك قليلُ».
الثالث: استرسال الوجوه والأقنعة
هذا القسم هو «هجاءٌ» بالغ لكل هذا الاسترسال المستمرّ، لكل ما يُسمّى بحضارات وأفكار متعددة وربما متنافرة، لكنّها كلّها أخفقت في كل وعودها الحضارية، وقدّم الشاعر عبر مشاهد منفصلة متصلة: (نيويوركر – الذكوري الأخير – إنسانُ التشظّي – بابو – طواعين)، كلّ هذه النصوص كشواهد على أخطاءٍ كارثية ورهانات خاسرة على هذه الحضارة المفتعلة.
ومن البديهيّ أن يبدأ هذا الهجاء من القسم الأول «استهلالُ خارج الطلَل» ليكون الفخر أكثر إقناعًا ببدائل هذا الطرح الذي جاء به الجاهليّ الجديد، وسوف نلاحظ كيف أنّ الهجاء في القسم الأول، كان عبارة عن مقابلة بين ما يهجوه وما يفخر به في البيت الواحد أحيانًا، ظاهرًا أو مضمرًا ، فيقول مثلًا:
«حداثةُ أوهامٍ ووهمُ حداثةٍ
ونجدٌ هنا قلبُ الحنين وقالبه».
يهجو الحداثة وأوهامها ويفخر ويكرّس صورة المكان (نجد) بوصفها مكانَ الجاهليّ الجديد، ويقول في موضعٍ آخر:
«الحربُ أهليةٌ والثَّورة اكتَشفت بأنَّها حمَلت في جينها الضدّا
شكرًا لكلّ إساءاتٍ قد اجتَرحت لمع المعانيَ حتى يتقن الردّا
كلّ العوالم لا تغويه فهو يرى أنّ الورى دخلوا في وهمهم جدّا».
ثمّ يأتي بعد كل هذا السرد للوضع الذي آلت إليه الأمور ليفخر ويعتدّ، فيقول:
«هذا هو الآن معتدٌّ بما كسبَت يمينهُ وله حقٌ إذا اعتدّا».
الهجاء هنا حجّةٌ لفخرٍ مستحق يفخر به الجاهليّ الجديد ويُفصح عنه.
أما في القسم الثالث فالهجاء للهجاء: انحياز للإنسان ضد حضاراته الواهمة، كما يراها الجاهليّ الجديد، وهو هنا لا يستثني أحدًا في نصوصٍ منفصلة متصلة، وعبر شخصياتٍ يخترعها أو يتقاطع معها، وتتجلى أفكار الشاعر من خلالها؛ فهذا الجاهليّ الجديد يتحقّق عبر القول، عبر الشِّعر، كما تحقّق الجاهليّ القديم عبر الشِّعر.
يقول:
«وتوحّدت فيّ الولايات التي
شاخت حداثتها وظلّت تنكرُ».
ويقول في هجاء اللاهُوية:
«بهويةِ الأرقام تبلعني المدينة
واسمي العربي قد يتبخّرُ».
واستلهم من شخصية المهرّج هذا الزيف الذي يصبغ هذه الحضارات، فيقول:
«يبدو على المكياج لون الكِذبة».
وما هذه الحياة إلّا سيرك تُمارس فيه كل الألعاب والألاعيب، إذْ يقول:
«في السيرك تختصر الحياة وربما
كلّ الحياة هناك تحت القُبّة».
ويقول:
«حُمّى تؤجّج كلّ أسباب التشاؤم
بالحداثةٍ لن أقول تفاءلوا».
ويمضي في هذا الهجاء:
«قال اقتصاد السوق ..»، و«لستُ اشتراكيًا ولكن ..»، و«يا وجه أوروبا الحزين بداخلي ..»، لكن الشاعر يترك الباب مواربًا دائمًا للأمل، إذْ يقول:
«الآن بحرٌ كلّه بحرٌ فهل
من بعد هذا البحر ثمّة ساحلْ؟».
ثانيًا: من حيث المبنى
يأتي هذا الجاهليّ الجديد «بقاموسه» ليقول في عصرٍ جديد له « قاموسه »، وبين القاموسين إرثٌ شعريّ وتاريخيّ لا يمكن إلا العبور خلاله واختزاله والتعبير عنه بمفرداتٍ تنبئ عنه وتجلّيه. لذا تنطلق مفردات الشاعر عبر هذه الخطبة الجاهلية التي تحاول «محاكمة» الحضارة القائمة وتبعاتها من مفردات شكلت نفسها وفق مجموعة المفردات التالية:
المجموعة الأولى:
مفردات جاهلية صِرفة تناسب الشخصية التي يقترحها الشاعر لمعالجة موضوعه، وسوف نتتبع الكثير من المفردات الجاهلية، ومنها:
«صعاليك عداؤون مرّوا على النوى
خفافًا وأهدوني سنان المثقّفِ».
ويقول:
«رأيتُ برؤياي امرأ القيس دونما
حصانٍ وملقى تحت سيلِ الجلامدِ».
ويقول:
«ولكنني والحمد لله سيّد
وتدري تميم أنَّني سيف خندفِ».
وغيرها في مواضع مختلفة.
المجموعة الثانية:
إذا كانت تلك مفردات مستلّة من لغةٍ جاهلية إذا صحّ التعبير؛ فأين لغة الشاعر؟ هذا الجاهليّ الجديد، لغته التي تميّزه كونه جديدًا على الأقل. وهنا سنجد أن الشاعر يبتكر لغته الجديدة الفاعلة، ومنها:
«أربّي فيّ كارثةً وأنجو
فسبحانِ الذي أسرى بعبدِ».
ويقول:
«موتي هو البدء فالميلاد ليس لنا
يا موريات اقدحي بل في دمي عيشي».
ويقول:
«مال كلٌّ نحو موتٍ مُشتهى
وأنا اللعنة في المنتصفِ
وقفةٌ لكن لها حكمتها
إنما العاجز من لا يقفُ».
ويقول:
«يا لقومي سرقوا حتى فمي
فبماذا يا ترى اعترفُ؟!».
ويقول:
«وتبسّمي لليل ثمّة حاجةٌ
للنّور في هذا الظلام الحالكْ».
ويقول:
«لولا التلوّن فيه لولا أنّه
أوحى إلى حطبِ الضلوع وشبّهْ».
وغيرها كثير.
المجموعة الثالثة:
استخدم الشاعر بعض التراكيب ذات القوالب الجاهزة التي تتناصّ مع نصوص في التراث العربي، ربما ليؤكد انتماء ما لهذا التراث الذي ينبني على القول وهو الثيمة الأساسية في الديوان، والأمثلة على ذلك جلية، منها:
«أنا الرجلُ الطفلُ الذي تعرفونه
طروبٌ وقلبي يا ابنة الحيّ قائدي».
ويقول:
«ألا طال يا نفس احتضاري فهل أنا
سوى الغول والعنقاء والصاحب الوفيّ».
ويقول:
«معلّلتي بالهجر منذ أنا أنا
فما زلت لا ألقى زمانًا أناسبه».
ويقول:
«إنّي أنا السيلُ الذي بلغ الزُبى
لكنني لم أستطع إرجاعي».
ويقول:
«ولستُ أبالي لو طُعنت ولم أمت
فحبّكِ جرح ما عليه دليلُ».
المجموعة الرابعة:
في مواضع قليلة مالت التراكيب إلى النثرية، يقول:
«إنّا أمام تحدٍّ
لا مفرّ لنا منه
ولا ملجأٌ
إلا الذي انهدّا».
ويقول:
«ونضيّع الإسلام بين معسكرين
كلاهما متديّنٌ إسلامي».
ويقول:
«وحدي هنا حتى وإن أحرجنَني
كلّ البنات بلهفةٍ وهيامِ».
ختامًا
يرى القارئ خلال هذا الديوان كم كان الشاعر وفيًّا لرؤيته وأفكاره منذ الغلاف إلى آخر سطرٍ في الديوان، ويحسب لهذا الرؤية أنها إنسانية تنظر للبعيد وترى وتأمل. رهان الشاعر على الكلمات، وعلى اللغة، وعلى الهوية كان جازمًا وثريًّا. وما يلفت النظر بلا شكّ، ولعلَّ هذا مما يميّز تجربة الشاعر عبد اللطيف بن يوسف، هي زاوية النظر للأشياء وللعالم؛ فلدى عبد اللطيف قراءة خاصة للعالم، يأخذ بأيدينا بشعريةٍ تصنع فضاءها ديوانًا بعد الآخر، وتترسّخ تجربة بعد تجربة، كي نشعر بما يشعر، ونرى ما يرى.
لا تصنف كل المشاكل النفسية على أنها مشاكل في التفكير. إن محاولة علاجها بالوسيلة المعرفية فقط، عن طريق العلاج المعرفي...
أعد تلك المروحية إلى الحظيرة ودع أطفالك يجدون طريقهم بأنفسهم، استقلاليتهم ستدهشك على الأرجح.
الإبداع يتخلل الحياة، ويمكنه مثل الحب أن يكسر قلبك.
يتطلَّب خلقُ الفنّ تخطّيَ قدرتِكَ على عدم التصديق، وتركيزَك على اللحظة الحالية، والانفتاحَ على حدوثِ أمورٍ غيرِ مُتوقَّعة. وكذلك الأمر...
«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.