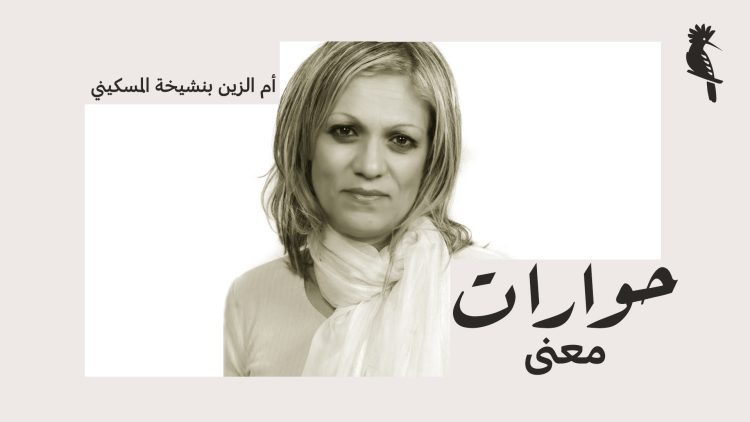تنتمي الكاتبة والباحثة التونسية أم الزّين بنشيخة المسكيني إلى فئة من الباحثات العربيّات فضلّن اقتفاء أثر درس الجماليّات داخل الفلسفة المعاصر، مُتوّجة ذلك بالعديد من المؤلّفات الفكرية ذات العلاقة بالفنّ والجمال، وما يرتبط بهما من أسئلة جوهرية حول قضايا تتّصل بالصورة ومُتخيّلها. لم تذهب أم الزّين إلى حقل الإسلاميات داخل الفكر العربي الذي أضحى يعجّ بالكثير من المؤلّفات التي يطغى عليها طابع التكرار والتداول، خاصّة وأنّ هذه المعرفية المُتّصلة بالخطاب الديني داخل الفكر العربي، بدت في الآونة الأخيرة تُكرّر نفسها على مستوى المادّة ومداراتها المنهجية. وإنْ كان ذهاب أم الزّين إلى فلسفة الفنّ، فهذا يعود إلى عشقها للجمال، ثم فطنتها إلى أنّ الفنّ هو مدخلنا صوب مجتمعات عربية متحرّرة تأخذ بزمام الحداثة بمفهومها المُركّب وتنفي كل أشكال التعصّب والقتل والإرهاب، بما يجعلها مجتمعات معاصرة تنتج الجمال وتتطلّع صوب حياة أفضل، حيث تكتسح الجماليّات كل مدارات التفكير وفضاءات العيش. ورغم أنّ أم الزّين لا تُمارس النقد الفنّي فإنّ ذلك لا يجعلها بعيدة عن الحركة التشكيليّة التونسيّة، لكون مُؤلّفاتها تُشكّل أرضاً خصبة لاستشكال مشروع نقدي ملتصق بمسام الصورة الفنيّة ومتخيّلها، كما نعثر على ذلك في كتابات المُفكّر المغربي موليم العروسي.
إنّ ما يُثير الانتباه في تجربة أم الزّين، يتمثّل في قدرتها على عيش تعدّد معرفي في ذاتها بين التأليف الفكري في الفنّ والكتابة الأدبيّة، بما يجعلها تتواشج فيما بينها وتخلق تناغماً معرفياً بين كتابة تنظيريّة وأخرى متخيّلة وحالمة، حتّى يغدو الأدب عبارة عن تأمّلات فلسفية مكتوبة بلغة تمزج بين دقّة المعرفة ورعشة الكتابة الأدبيّة وبياضها وهي تحفر في مناطق يباب من الاجتماع الإنساني.
بمُناسبة تتويجها مؤخرًا بالجائزة الوطنية “زبيدة البشير” في تونس عن أفضل بحث علمي عن كتابها “الفنّ والمُقدّس” كان لـمنصة معنى، هذا الحوار الخاصّ مع الدكتور أم الزّين بنشيخة المسكيني
– أم الزين بنشيخة المسكيني، أوّلاً، كيف تكوّن شغفك الأكاديمي وجاء اهتمامك الفكري بفلسفة الفنّ، خاصّة وأنّ هذا الحقل الفلسفي، الذي يُعنى بالجماليّات يعيش ضرباً من اللامفكّر فيه داخل مختبرات البحث العلمي ببلداننا العربيّة؟
لقد وُلدت بجزيرة قرقنة، تلك الجزيرة المستلقية حذو البحر كعرس إلهي نضّد لي ذاكرتي وشغفي بالإيقاع الشعري الذي يسكن طبيعة العالم المنتصب هناك. وعلى امتداد ثمانية عشر عاما -هي عمر طفولتي وشبابي هناك- كان البحر حضنا وأغنية تعلمت منها روح الأمل وخطر الإبحار معا .. وهو معنى شغفي بالفلسفة وبالفن معا. فالفلسفة لا تكون بدون محبّة الإبحار وركوب الخطر، أمّا الفنّ فيمنحنا دوما الأمل في عالم أجمل. لذلك قررت التخصص في مجال فلسفة الفنّ هذا الاختصاص الذي لا يزال يشكو وهناً في ثقافتنا رغم كثرة المنتمين إليه. ذلك أنّ الثقافة الإبداعية لدينا لم تعرف بعدُ طريقها إلى صياغة براديغم جمالي مناسب لذائقتنا وذلك يعود إلى أنّ ملكة الخيال في ديارنا مازالت تخضع إلى ضروب عديدة من الوصاية الدينية والسياسية والأخلاقية.
– تبقى تونس أكثر البدان المغاربيّة عناية بالفنّ بحجم ما تتوفّر عليه من كليات ومعاهد للفنّ مقارنة بالمغرب والجزائر. ولكن مع ذلك، فإنّ المُتابع للحركة الجماليّة التونسية يندهش من كثرة الفنانين واختلاط مفاهيمهم الجماليّة. الأستاذة أم الزين لماذا في نظرك لم يستطع النقد الفنيّ التونسي اجتراح مشروع نقدي جمالي يستند إلى إسهامات الباحثين في مجال فلسفة الفنّ، كما هو الحال مع أبحاثك العلمية؟
ما يحدث في تونس منذ عشر سنوات أي بعد ثورة 2011 طفرة إبداعية بكل ما في الطفرة من معاني متناقضة: في معنى الانبثاقة الفجئية كنبع ماء تدفقت مياهه دفعة واحدة لكن في ضرب من الفوضى التي تحتاج إلى مسار ونظام وبرنامج واضح. صحيح أنّ ميدان الكتابة الأدبية خاصة الرواية والشعر والمسرح قد ازدهر، لكن مجال النقد مازال يعاني من نقص في النقّاد. الحركة النقدية في تونس مازالت بصدد التكوّن وتحتاج إلى مشروع ثقافي يمنح مجال النقد منزلته الحقيقية. أمّا عن الجماليات فأكثر المشتغلين عليها لا يزالون بصدد شرح بعض النظريات الجمالية دون محاولة اقتحام ميدان التجربة الفنية نفسها. لا يمكن إنتاج براديغم جمالي بالاكتفاء بالنظريات الفلسفية. ستكون حينئذ فلسفة بلا فنّ.
-هل يُمكن أنْ نقول أنّ الدولة تتحمّل مسؤولية هذا التراجع المُخيف للنقد التونسي الذي يُعنى بمتابعة الحركة التشكيليّة والتأريخ لمسارها وتحوّلات منذ ستينيات القرن المنصرم من خلال عدم تشجيع النقاد على فتح مجلاّت خاصّة تهتم بتوثيق التجربة؟
طبعا السياسات الثقافية في تونس تحديدا لم تمنح مجال النقد الفني منزلة أساسية. وذلك يتنزل ضمن تهميش نسقي لميدان الثقافة بعامة في العهد السابق على الثورة، وهو تهميش تواصل في العشرية السوداء لحكم الإسلاميين الذين كانوا يمنحون لوزارة الشؤون الدينية ميزانية أكثر من ميزانية وزارة الثقافة.
– المُثير للدهشة في سيرتك الفكرية، هو أنّها ظلّت تتوزّع بين فلسفة الفنّ والكتابة الأدبيّة ودراسات أخرى ترتبط بالرأي وما يعيشه الواقع العربي من أهوال وتصدّعات. لماذا الاهتمام بكل هذه المجالات المعرفية رغم تباعدها أو بعبارة أخرى، كيف تعيشين هذا التعدّد الفكري في ذاتك قبل اختيار وبدء فعل الكتابة؟
كلّ ما أكتبه يتنزل ضمن أفق إشكالي واحد: كيف يمكن للإبداع بعامة -بما في ذلك الفلسفة نفسها كشكل إبداعي- أن يمنح الثقافة في لغة الضاد تجارب معنى وآفاقا تأويلية جديدة؟ بعبارة أخرى، ليس ثمة مسافة فاصلة بين كتاباتي الفلسفية (في اختصاص فلسفة الفنّ تحديدا) وكتاباتي الإبداعية (رواية وشعرا). وذلك لأن من يطمح إلى إنشاء فلسفة للفنّ مطالب بأن يعيش التجربة الفنيّة من داخلها، وإلاّ تحوّل إلى مجرّد متحذلق أكاديمي. لا يمكن أن ندخل ميدان صناعة المعنى ونحن لا نعرف كيف يتمّ إبداع المعاني وتبذيرها. أمّا عن الكتابة في مجال الفضاء العمومي فذلك في علاقة بمهمّتي كمواطنة تونسية أو إن شئت كمثقفة ملتزمة بقضايا وطني وبما يعيشه من تحوّلات سياسية من واجبنا الاشتغال عليها حتى يبقى لنا وطن نحيا على أرضه. وأنا أعتقد أن المثقف ليس مجرّد أكاديمي يبيع المعرفة، إنّما هو مناضل من أجل القضايا العادلة والفئات المهمشة والمسحوقة.
– في كتابك “الفنّ والمُقدّس” اشتغلت بقوّة على تبيان الاستقلال التام الذي نشأ بين الديني والفنّي، وكيف استطاع هذا الأخير خلال العصر الحديث أنْ ينفلت من قبضة اللاهوت، لا سيما إبان عصر النهضة، حيث الكنسية تتدخّل في كل شيء باسم الدين. الأستاذة أم الزين، ما المسار الذي قطعه الفنّ منذ القدم إلى اليوم في علاقته بالدين؟
كتابي «الفن والمقدس: نحو انتماء جمالي إلى العالم»، وهو الذي تمّ تتويجه منذ مدّة قصيرة بالجائزة الوطنية “زبيدة البشير” كأفضل بحث علمي، هو عبارة عن استشكال طويل النفس لجملة من المفاهيم العالقة بفكرة المقدس في عقولنا. وهو عبارة عن مقاربة فلسفية انطلقت من التأريخ لمفهوم المقدس منذ ديانة الأمّ إلى دوركهايم (1912) وصولا إلى حدود ريجيس دوبري (2012)، من أجل الترحال طيلة الأقسام الثلاثة للكتاب في تجليات العلاقة بين الفنّ والمقدس عبر خطوط فلسفية معقّدة: تجد في عنف الإرهاب على الفنّ معركتها الأساسية وفي المقدس الجمالي أفقها البعيد. بحيث يراهن الكتاب على تحرير فكرة المقدس من عنف المؤسسة الدينية حيث تعرّضت المتاحف إلى التدمير من طرف الإرهابيين وتمّ تحريم الموسيقى عندهم أيضا. المأمول هو قدرة الفنّ على اختراع حياة روحية ورمزية مغايرة للتعصب الديني ولكل أشكال الإرهاب والتطرف. أمّا عن تاريخ العلاقة بين الفنّ والمقدس فالكل يعلم أنّ المقدس نفسه قد ولد في أحضان الفنّ منذ الإلياذة والأوديسا والتراتيل والأساطير والخط العربي والسرديات الدينية بعامة، لكن لئن كانت العلاقة بينهما متشابكة وسلمية في العصور القديمة الوثنية منها تحديدا، فإنّ الصدام بينهما قد ظهر في ديانات التوحيد الثلاثة إلى حدّ تحريم الصور منذ الوصية اليهودية المعروفة إلى حدود معركة تحريم الصور في الإسلام والمسيحية، وهي معركة دامت طويلًا، وأريقت فيها الدماء أيضا .. وهذا كلّه ما يؤرّخ له كتاب الفنّ والمقدس ضمن فصل خاص بمسألة التسامح الجمالي.
– لكن ماذا عن تأثير ذلك على الفنون المعاصرة اليوم، وهي تستعيد مكانتها وبريقها بالعودة إلى هذه الجذور؟
إنّ الفن والمقدس بوصفه إمكانية لانتماء جمالي إلى العالم يجد له تجليات فنية عديدة منذ التصوف الذي وجد في الشعر والإنشاد تعبيراً أساسياً له، ولنا في تاريخنا القديم أمثلة عديدة من قبيل طواسين الحلاّج وكتابات ابن عربي وفي فنّ التجريد؛ بخاصة فنّ الخطّ العربي الذي كُتب فيه القرآن .. أمّا في الفنّ الحديث والمعاصر، سيشهد اللقاء بين الفن والمقدس في الرومانسية الألمانية مع نوفاليس وشيلنغ وهيجل الأول ضربا ممّا سماه هيجل “ميثولوجيا العقل”، وفي الفنّ المعاصر فسيكون الفنّ التجريدي منذ كاندنسكي ومالفيتش وغيرهم هو التعبير الحاسم عن قدرة الفنّ على اختراع حياة روحية مغايرة تجد “في اللون ضربا من الصلاة” بتعبير كاندنسكي نفسه، وهذا الأمر قد خصصنا له الفصل الأوّل من القسم الثالث من الكتاب بعنوان “التصوّف والفنّ المعاصر” حيث انتخبنا جملة من الآثار الفنية التشكيلية خاصة التي تجسّد إمكانية اللقاء بين الفن والمقدس حيث “يسائل اللون صمت الملائكة” في رسومات بول كلي، أو حيث تتجسد “الدرجة الصفر من الشكل ” في مربّعات مالفيتش، وحيث يراهن هذا القسم على المبدأ المنهجي الذي صغناه في الجملة التالية :” علينا أن نتيح للمقدّس أن يحدثنا من جديد” في عصر ما بعد ديني وما بعد ميتافيزيقي وما بعد إنسانوي. نحن مطالبون فقط بالقدرة على الإنصات إلى نداء الكينونة بوصفه نداء المقدّس الذي يمكن للشاعر أن يقتفي آثاره وأن يدرّبنا على أن “نسكن العالم شعرا” في هذه الأزمنة الرديئة، بحسب العبارات المشهورة لكل من هولدرلين وهيدغر.
– شهد الفنّ العربي تحوّلات كبيرة في علاقته بالسياسة والايديولوجيا عموماً، وإنْ كان ذلك ليس بجديد على الساحة العربيّة، لكنّ يبدو ذلك ثمّة تغيير جذري في النظر إلى هذه العلاقة المُتواشجة فكرياً، لا سيما إبان الربيع العربي، حيث برزت أعمال فنيّة عربية تتجاوز المتون البصريّة الستينية والسبعينية التي حاولت تقعيد هذه العلاقة. الدكتورة أم الزين، كيف تنظرين طبيعة الأعمال الفنيّة المُنجزة في تونس وخارجها ذات العلاقة بالربيع العربي؟ وإلى أيّ حد استطاعت السياسة اختراق بنية العمل الفنيّ؟
إنّ علاقة الفنّ بالسياسة علاقة أساسية جدّا. وهذا ما نظّرت له الجماليات المعاصرة منذ كتاب “ما هو الأدب” لسارتر (1949) مرورا بالنظرية الجمالية لثيودور أدورنو (1970) وصولا إلى كتاب “قلق في الجماليات” و”سياسة الأدب” لجاك رنسيار. لا يمكن للفنّ أن يبقى محايدا بالرغم من كونه مطالب بالبقاء على مسافة مع السلطة بكلّ أشكالها. فالفنّ هو بمثابة الثورة الرمزية على المجتمع خاصة حين يكون المجتمع قائما على الهيمنة واضطهاد الأفراد وتحويلهم إلى مجرد ذوات استهلاكية لحضارة تقوم على اعتبار كل شيء بما في ذلك الفن والثقافة سلعة تُباع وتُشترى. أمّا عن علاقة الفنّ بالربيع العربي، نقول أنّ ما حدث في بلاد الثورات العربية منذ 2011 هو محاولة واسعة النطاق لمصاحبة الفنون لهذه التحوّلات الحاسمة في طبيعة السلطة وفي شكل الحياة في أوطان لم تتقن بعدُ السير على الطريق الآمن للديمقراطية رغم أنّ الديمقراطية نفسها مخاطرة كبرى وذلك لعدم قدرتنا بعدُ على بناء مفهوم الإنسان – المواطن. الآن كيف يمكن للفنون أن تساهم في النهوض بالإنسان في بلاد الربيع العربي؛ أي أن تشتغل على تربية مواطنة عميقة تتيح لنا صناعة مفهوم مناسب للديمقراطية في ديارنا؟ ذاك هو عين المشكل. أمّا عن السياسة بالمعنى النبيل للعبارة فهي ليست مطالبة باختراق بنية الأثر الفنّي وإنّ الفنّ أيضا ليس مطالبا فقط بتسريد وتخييل ما يحدث على أرض الواقع، بل إنّ مهمّته الأساسية هي الاستباق واستشراف مستقبل أجمل. إنّ الفنّ مجال لإبداع أشكالا جديدة من الحياة، وجعل المخيلة هي التي تقود العالم وفق استعارة جميلة لشارل بودلير. لكن هل يتمتّع الخيال في بلادنا بصحّة جيّدة؟ أم تسطو عليه الأوهام والخرافات والكوابيس؟ كيف يمكن تربية ملكة الخيال في عقول أبنائنا على قيم إبداعية وتحرير المخيلة من الكهّان وصانعي الخرافات والأوهام؟ تلك هي مهمّة المبدعين الحقيقية اليوم في أوطاننا.
– رغم التراكمات الكبيرة التي حقّقها المُنجز الفني داخل العالم، لم يستطع النقاد والمفكرين والباحثين اجتراح مشروع فكري يصوغ جماليّات تنطلق من التراث العربي وتنتهي داخله. لماذا في نظرك تبقَ صياغة جماليّات عربية وكأنّها حلم مستحيل أمام ما حقّقه الغرب على مستوى التفكير الجمالي؟
هذا السؤال مهمّ جدّا لأنّه يضع يده على إحراج كبير. دعني أجيبك عنه بطريقتين: أوّلا كلّ ما نكتبه في اللغة العربية تنظيرا وإبداعا ونثرا وشعرا هو مساهمة في بناء جماليات عربية أي جماليات لا فقط تتخذ من لغة الضاد حضنها الأنطولوجي والميتافيزيقي، بل هي تصنع للسان العربي مساحة إضافية تضمن له استمراريته وحيويته من جهة وقدرته على اختراع ضرب من “الندّية الميتافيزيقية” لكل ما يحدث في العقل العالمي من أحداث إبداعية وفكرية. وثانيا: أنا أعتقد أنّ الإبداع لا عرق له. بحيث لا يمكن أن نتحدث إذن عن جماليات غربية وأخرى عربية إلاّ تجوّزا أي من أجل أن نشير إلى الانتماء اللغوي لبحث أو لفكرة أو لمجال ما. ومثلما نتحدث عن علم واحد للفيزياء أو للرياضيات. ثمّة جماليات واحدة أي مجال فكري عالمي يمكن لكلّ المختصين أن يساهموا فيه على أنحاء شتى. وإنّ كل تفكير في الإبداع هو إنتاج لخطاب جمالي بصرف النظر عن جنسية المفكّر أو هويته القومية وكلّ ما يكتب اليوم في هذا المجال باللغة العربية هو مساهمة في جعل لغة الضاد لغة عالمية معاصرة لما يحدث في العالم من أحداث إبداعية بصرف النظر عن انتمائها الثقافي.
– الخطاب المكتوب يطغى على البصريّ داخل الثقافة العربيّة المعاصرة. هل ثمّة عطبٌ أو تأزّم أو تغييب للثقافة البصريّة في تاريخ الفلسفة العربيّة؟
هذا الأمر يعود إلى ندرة النقّاد في مجال الفنون البصرية تعلق الأمر بالفنون التشكيلية أو السينمائية أو فنون الركح وفنون التنصيبات والآداء أيضا. أمّا عن تدخّل الفلسفة فهو شحيح أو غائب لأنّ الفلسفة لا تزال مرتبطة بمفهوم تقليدي لها، تواصله الجامعات أيضا. بحيث أنّ الفلسفة لا تؤمن بعدُ في بلداننا بأهمية اقتحامها للفضاء العمومي وضرورة مساهمتها في بناء تصوّر مدني ومواطني تجعل منها نضالا يوميا من أجل تغيير سياسات الحقيقة وإبداع أشكال جديدة من الخطاب خارج الحذلقة الأكاديمية. فالفلسفة لا تولد داخل جدران الجامعة بل من أحداث حيوية يعيشها شعب ما. وهذه الأطروحة دافعت عنها في كتاباتي السياسية بحيث وجب تنزيل الفلسفة إلى الفضاء العمومي وتحويلها إلى مكنة حرب ضدّ سياسات الحمق والتجهيل، وضدّ سطو الدعاة والدجّالين وسماسرة إعلام البروبغندا على عقول الناس. ويمكن العودة إلى مقال كتبته حول هذا الأمر منشور على النت تحت عنوان “هل يمكن الحديث عن عمومية الفلسفة”. ومقال ثان تحت عنوان “الفلسفة والمقاومة”.
– ثمّة تضخّم للمفاهيم والمصطلحات داخل بعض الكتابات التونسية، التي درست تاريخ الفنّ وخطابه البصري باستخدام مفاهيم كبيرة لهيجل وكانط وفوكو ودولوز وفق سياقات معيّنة، مع أنّ المطلوب أحياناً هو تشريح الحركة التشكيليّة التونسية بعيداً عن بعض المفاهيم الأجنبية. هل في نظرك تحتاج الساحة التشكيليّة إلى كل هذه المفاهيم الكبرى حتّى تُجدّد نفسها من الداخل أم أنّ الأمر يحتاج إلى ضبط دقيق لمثل هذه المفاهيم، بدلًا من إسقاطها على أعمال لا تتوفّر حتّى على شروط اللوحة أحياناً؟
لا أعتقد أنّ ثمّة تضخّم في تبيئة المصطلح الجمالي العالمي وجعله ممكنا في لغة الضاد. وعلى العكس من ذلك فأنا أعتبر أنّ الكتابة عن هذه النظريات الفلسفية والجمالية العالمية يدخل في باب جعل اللغة العربية قادرة على أن تكون في حجم سرعة العقل العالمي في مجال إنتاج المعارف. من واجب كلّ باحث في اختصاصه أن يعمل على إثراء ثقافته ولغته بآخر ما وصلت إليه المعرفة العالمية. لا يمكن أن نواكب التقدّم التكنولوجي العالمي بأن نجعله نمط إقامتنا في العالم من جهة، وأن نرفض من جهة أخرى نمط تقدّم المعارف النظرية لهذا العالم. بعض العرب المعاصرين الذين يعتبرون المعارف الإنسانية العالمية معارف غربية واستعمارية -ينبغي رفضها تحت راية انغلاق هووي- هم بمثابة عائق إبستمولوجي أمام ثقافتنا وسيظلّ تعاملهم مع مفهوم “الغرب” -الذي ليس سوى ادّعاء أنثروبولوجي- تعاملا سكيزوفرينيا. المبدعون هم مواطنون في العالم، وليسوا جذورا لأشجار قديمة. أمّا عن الذاكرة، فالفنّ مطالب بإبداعها دوما من أجل أن تكون ذاكرة للمستقبل وليست حائط مبكى على الماضي.
– من المؤلّفات الهامّة التي صدرت لك نعثر على “كانط والحداثة الدينية” بطريقة يُخيّل للقارئ المكانة المعاصرة، التي يحظى بها فكر هذا الفيلسوف الكبير. كيف جاء التفكير في كانط؟ وما دلالات فكره بالنظر إلى ما تعيشه المجتمعات العربيّة دينياً وأخلاقياً وجمالياً؟
لقد مثّل اهتمامي بالظاهرة الدينية المجال الأوّل لاشتغالي الأكاديمي. وكنت قد أصدرت فيه كتابا حول كانط والحداثة الدينية، وهو كتاب اشتغلت فيه على كيفية تنضيد كانط للمجال الديني بوصفه فيلسوفا نجح في توقيع مفهوم طريف عن الحداثة الدينية؛ أي عن الدين الكفيل بانتماء عقلي إلى الحداثة. وهذا الكتاب بيّنت فيه مكاسب هذا التصور الفلسفي ومدى قدرته على مساعدتنا في تطوير علاقة عقلية وسلمية وصحّية مع الدين وذلك في ثقافة صارت توسم منذ 11 سبتمبر 2001 بكونها ثقافة إرهابية. فكان الكتاب “كانط والحداثة الدينية” يستعيد الدرس الفلسفي الكانطي وذلك بالرهان على العقل ضدّ الخرافة، والنقد ضدّ الحماسة، والحرية ضدّ الاستبداد الروحي. وأنا أعتبر هذا الكتاب تمرينا فلسفيا على تربية الإنسان في أوطاننا على قيم العقل والإيمان الحرّ بعبارة رشيقة للمفكّر التونسي فتحي المسكيني الذي كتب كتابا ضخما تحت عنوان “الإيمان الحرّ” (518 ص).
– رغم أهميّة كانط داخل الدرس الجمالي والفلسفي، يبقَ تقليدياً في تأصيله لمفهوم الجمال ومقارنة مع ما يوجد اليوم داخل الساحة الفنيّة العالمية والتحوّلات التي طالت الفنّ المعاصر. وهذا الأمر يظلّ عادياً بحكم السياق التاريخي الذي وجد فيه كانط. أم الزين، إلى متى سنظلّ نختفي وراء كانط وهيجل مثلاً متناسين المجهود الفكري المبذول على المستوى الفني خلال الأزمنة المعاصرة، لا سيما عند بيير بورديو وإيف ميشو وناتالي إينيك؟
حينما نكتب نحن لا نختفي وراء أيّ عملاق أو صنم. بل نحاول افتراع أفق تأويلي جديد لزراعته في حديقة لغة الضاد. إنّ ما أكتبه أنا شخصيا إنّما ينتمي إلى مشروع فلسفي كبير يراوح بين التعريف بالنظريات الأساسية في اختصاص فلسفة الفنّ وبين التجريب الإبداعي في مجالي الرواية والشعر أيضا؛ لذلك حاولت في كتبي حول الفنّ- منذ كتاب الفنّ يخرج عن طوره (2010) ثمّ كتاب تحرير المحسوس (2014) وبعده كتاب الفنّ في زمن الإرهاب (2016) وأخيرا كتابي الفنّ والمقدس (2020)، ولديّ كتاب خامس في نفس الاختصاص هو حيّز النشر- أن أؤرّخ لهذا المجال من كانط إلى رنسيار مرورا بدريدا ودولوز وفوكو وفنّانين آخرين اشتغلت على تأويل لأعمالهم (سلفادور دالي- أرتو- بيكاسو – فان غوغ – غويا- كاندنسكي- مالفيتش- وكتبت أيضا حول الفنّ الهندي).
وحاولت من جهة أخرى أن أشتغل على الفنّ العربي المعاصر باختراع قيم جمالية مغايرة وذلك من خلال أبحاث حول أعمال الفنانة الفلسطينية منى حاطوم، وحول نماذج من الفنّ التشكيلي الفلسطيني (إسماعيل شموط وسليمان منصور ونبيل عناني) والروائي العراقي وارد السالم (روايته عذراء سنجار) ورسّامة الكاريكاتور البحرينية سارة قايد والفنان السوري تمّام عزّام والكاتب التونسي عبد الحليم المسعودي في تأويل لمسرحيته “كعبة جهيمان”. وحرصت في القراءات التي نشرتها حول هذه الأعمال الفنّية العربية على أن تُنشر ضمن كتبي الفلسفية إلى جانب أسماء عالمية أخرى، لأنّني أعتقد أن لا أفضلية لأيّ عرق على آخر في الإبداع. فالإبداع إنساني وعالمي وكوني، مهما كانت لغته. والفنّ لا يعترف بالجدران بين الثقافات والجنسيات. إنّي أؤمن بأنّ الحقيقة لا تزال دوما ممكنة وبأنّ ثقافتنا قادرة على العالمية في كلّ المجالات. علينا ألاّ نتخلى عن قدرتنا على الأمل في حياة أفضل. لكن مع ضرورة مواصلة النضال من أجل جعل الحلم ممكنا. إنّ السعادة الحقيقية للمبدع هي الاعتقاد في قدرة الإبداع على إنقاذ العالم من السقوط في الفراغ. أمّا عشّاق العدم والمدمنون على النواح فلا مستقبل لهم.