لوحات من الفلسفة الوجودية: إضاءة على أبرز مفاهيم ومقولات الوجود | أوس حسن
إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...
كان لنكبة فلسطين 1984 وما خلفته من مهانة وخذلان، والحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من دمار للعالم والإنسانية، بالإضافة إلى التخلف والفقر والأمة، الوقع الكبير على النفوس العربية وخصوصًا المثقفين منهم والشعراء الذين شككوا في التيار المحافظ، وواجهوا الوجود العربي التقليدي بعد أن انهار وزالت عنه صبغة القداسة، فتوفرت للشاعر شروط الإبداع والتجديد بعد أن ألهمته الحداثة الغربية، فكان البديل إلى شوقه إليها الاحتكاك بها والتحرر من كل تقليد محافظ يقيده. كان هذا أيضًا في ظل عوامل ثقافية تضمنت انتشار الفكر التحرري والمد الثوري بانتشار الفكر الشيوعي والاشتراكي، بالإضافة إلى الانفتاح على الحداثة الغربية والفلسفات والثقافات الإنسانية المتنوعة. والتأثر بأعمال بعض الشعراء الغربيين مثل توماس إليوت في قصيدته «الأرض الخراب»، »والتأثر بأعمال بعض الروائيين والمسرحيين الوجوديين كألبير كامو، وجون بول سارتر، وبعض النقاد ككولن ويلسن الذين ترجمت أعمالهم إلى اللغة العربية«[1]. بالإضافة إلى عامل المعرفة، حيث نهل الشاعر معرفته الجديدة من مشارب متعددة كالفلسفة والتاريخ والأساطير، والعلوم الإنسانية والديانات القديمة والمذاهب الصوفية، والاطلاع على التجارب الشعرية العالمية، والإلمام بالثقافات الشعبية والآداب العربية.
بدأ الشاعر العربي في رسم مخطط الحداثة العربية شعرًا بعد أن عجز عنه السياسيون واقعًا، فخلق مشروعًا ذاتيًا رمزيًا كسر فيه بنية الشعر العربي التقليدي، وجدد رؤياه. حيث ارتبط مفهوم تكسير البنية وتجديد الرؤيا بتيار شعري جديد اقترن بالشعر الحر أو ما يسمى بشعر التفعيلة، مال فيه الشاعر الحديث إلى خرق بنية القصيدة القديمة التي لم تعد تستطيع حمل أفكاره وقضاياه العميقة فخلق شكلًا جديدًا، وذلك حين أراد تجديد رؤياه الشعرية للتعبير عن رؤاه الخاصة حول الواقع والعوالم الإنسانية والقضايا السياسية والقيم التي أصبحت محط شك وتساؤل، فكانت القصيدة الشعرية الحداثية ثورة شكلية بتكسير بنيتها القديمة، وثورة مضمونية بتجديد رؤيتها إلى الواقع بمختلف أبعاده.
اتسمت المدرسة الشعرية الحداثية بمجموعة من الخصائص والسمات على مستوى الشكل والمضمون، جعلتها تتميز كتجربة فريدة عن سابقتها من التجارب الشعرية.
فعلى مستوى الشكل[2]،كسر الشاعر البنية التقليدية القائمة على نظام الشطرين والأوزان الخليلية؛ لأنها لم تعد قادرة على استيعاب الأسئلة الجديدة التي يطرحها الشاعر في ظل ما يسمى بالحداثة، وبالتالي بحث عن شكل جديد كبديل قادر على حمل أفكاره ورؤاه الجديدة. فقد تم تكسير بنية القصيدة العربية التقليدية، من خلال اعتماد نظام السطر الشعري والمقاطع بدل البيت الشعري التقليدي، فكانت الأسطر الشعرية تتراوح بين الطول والقصر حسب الدفقة الشعورية للشاعر، مما يحيل إلى الحرية في النظم لدى الشاعر وفق نزواته الفكرية والشعورية، كما أن هذه الأخيرة تتحكم في الوقفات العروضية في سطر أو سطرين، وبالتالي الانفتاح على ظاهرة التدوير العروضي حيث قد تنتهي التفعيلة وتكتمل في بداية السطر الموالي. كما تتحكم هذه الدفقة أيضًا في الوفقات الدلالية في سطر وتارة في أكثر من سطر، إذ لا وجود لاستقلالية معينة في المعنى بالسطر الواحد في القصيدة بأكملها.
عمد الشاعر الحديث إلى جعل موسيقى شعره أكثر حداثة حيث اعتمد التفعيلة بدل الوزن، وتنويع والأرواء والقوافي، وتارة التخلي عن القافية باعتبارها المرمى الأفقي النهائي للجمل المختلفة، وجعلها محطة وقوف اختيارية تستجمع فيها الدفقة الشعورية أنفاسها. بالإضافة إلى اعتماد البحور الصافية، فطول السطر الشعري قد يتراوح ما بين تفعيلة واحدة وتسع تفعيلات من ستة بحور صافية، وهي: الهزج (مفاعيلن)، والرمل (فاعلاتن)، والمتقارب (فعولن)، والمتدارك (فاعلن)، والرجز (مستفعلن)، والكامل (متفاعلن). فإذا كان عدد التفعيلات في القصيدة التقليدية محددًا ومحصورًا، تتوزعه الأعجاز والصدور، فإن التفعيلات في القصيدة الحديثة تمثل عددًا لا يحيط به الحصر. لهذا فقد امتاز نظام التفعيلة بالمرونة والطواعية، وساعد الشاعر الحداثي على تضمين رؤياه الخاصة بشكل مرن وأرحب.[3]
أما على مستوى المضمون فقد قطع الشعراء الحداثيون مع المضامين التقليدية، واستبدلوها بقضايا ذات مشروع سياسي ثوري، وبالتعبير عن الغربة والضياع، والموت والحياة من خلال لغة مألوفة ذات دلالات غامضة وعميقة، بالإضافة إلى الاستعانة بصور جديدة تعتمد الرمز والأسطورة. حيث عبر من خلاله الشاعر عن رؤاه الخاصة حول الواقع والعوالم الإنسانية، متخذًا بذلك مواقف جديدة من العالم والأشياء متجاوزًا السطح إلى العمق والظاهر إلى الباطن، ومتجاوزًا حدود العقل والحس والذاكرة، متخطيًا المقاييس الزمنية والمكانية باعتماد عالم خاص يمتزج فيه الرمز بالأسطورة.
جنح الشاعر العربي الحديث إلى التعبير عن تجربة الغربة والضياع، حيث الغربة في الحب؛ فالشاعر الحداثي فاشل في الحب، وفي التوغل في دواخل المرأة المحبوبة عكس الشاعر الرومانسي، بل إنه يرى أن الحب مرحلة وقتية مارة، لا تتناغم مع الواقع المخرب الذي يثور من أجله، لذلك قد يتحول أمام المرأة إلى مدينة مقفلة الأبواب، هذه المدينة التي يعيشها الشاعر خارجيًا وداخليًا، وبالتالي تهيمن على مشاعره في الحب تجاه المرأة. أما الغربة في الكلمة فتتراوح عند الشاعر بين قوة القول الثوري، وضعف الفعل، فغربته تتجلى في كلماته الشعرية التي تبقى رمزية لا تستطيع التغيير، وإنما فقط تصوير الواقع الفادح، لذلك يفضل القول لعل الكلمة أرحم من الصمت. وخير دليل على ذلك حين قال بدر شاكر السياب: ولساني كومة أعواد[4]. يعبر الشاعر أيضًا عن الغربة في الكون والمدينة، فالغربة في الكون تتجلى في عدم معرفة الشاعر لحدود ذاته في هذا الكون، فهو متفرد وحيد، منبهر به، وفي نفس الوقت يريد تغيير كل شيء فيه، وأن يتخذ الوجود صيغة جديدة، غير تلك التي يعرفها المثقلة بالمرارة والعتمة والظلمة. بينما الغربة في المدينة تتماهى مع الكون البائس عند الشاعر، فالمدينة في قصائد الشعر الحر مليئة بمظاهر الموت والأسى، يكون فيها الشاعر محاطًا باليأس باحثًا عن الأمل، تثقلها مرارة الزمن وملل الجدران والإسمنت، كما أن أناسها منهكون يجترون الموت من فسادها.[5]
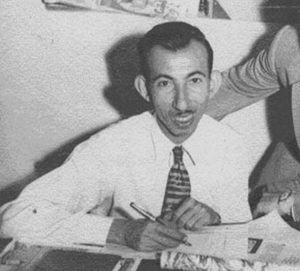
تتمظهر تجديد الرؤيا في شعر التفعيلة أيضًا في تجربة الحياة والموت، هذه التجربة التي أطرها مجموعة من الشعراء، وهنا نذكر أدونيس في خاصية التحوّل عبر الحياة والموت في رؤياه الشعرية حيث ينطلق من الحيرة، والبحث عن وسائل الانبعاث الحضاري، ثم إلى محاولة الكشف عن مفهوم التحول، للدفع بالواقع العربي نحو البعث والتجدد. والانعتاق من الانكسار الحاصل. بينما يعارض الشاعر خليل حاوي مبدأ التحول، من خلال خاصية المعاناة في الحياة والموت، التي تجعل قصائده مليئة بمظاهر الخراب والدمار والخيبة، فالموت والحياة كلاهما خطان متوازيان في مجتمع يصعب التحول فيه، فبرزت المعاناة من الواقع. هذا ما جعل الشاعر بدر شاكر السياب يميل إلى طبيعة الفداء في الموت، حيث الواقع الفادح الذي يحتاج إلى تضحيات ينهلها من تجربة المسيح، فالتضحية بالموت بعد اليأس من الواقع عند السياب هو أمل في انبعاث حضاري جديد: ستولد جيكور من جرحي[6]. ليعود الشاعر إلى نبرة اليأس بعد التشكيك في هذا الانبعاث وانتظاره المؤرق: أتولد جيكور… ؟[7] إلى غير ذلك من مظاهر هذه التجربة مثل جدلية الأمل واليأس عند عبد الوهاب البياتي وغيرها من تجارب الحياة والموت عند شعراء الحداثة.[8]
حاول الشاعر الحداثي تقريب اللغة الشعرية من لغة الحياة المتداولة مع الغوص في الغموض الحداثي؛ فلا وجود لمعنى سطحي للغة الشاعر، وإنما تغوص الألسن في العمق لتستخرج الرموز الموحية إلى ثنائيات عدة تدل على الموت والحياة، والأمل واليأس، والغربة والضياع، فما الصبح والنور والظلمة والملح والقمح والمطر؛ إلخ، إلا دلالات لغوية عميقة ترمز إلى الموت تارة والولادة من جديد وتارة أخرى للخصب والعقم والدمار؛ وغير ذلك. «فإذا كان الشعر الجديد تجاوزًا للظواهر ومواجهة للحقيقة الباطنية في شيء ما أو في العالم كله، فإن على اللغة أن تحيد عن معناها العادي، ذلك أن المعنى الذي تتخذه عادة لا يقود إلا إلى رؤية أليفة مشتركة. إن لغة الشعر هي اللغة-الإيضاح، فالشعر الجديد هو، في هذا المنظور فن يجعل اللغة تقول ما لم تتعود أن تقوله، فما لا تعرف اللغة العادية أن تنقله، هو ما يطمح الشعر الجديد إلى نقله. يصبح الشعر في هذه الحالة ثورة على اللغة »[9].
استنجد الشاعر أيضًا باستدعاء التراث الإنساني والتفاعل معه من خلال التاريخ والدين والأسطورة والرمز. وبالتالي توسيع آفاق الصورة الشعرية بتعميق دلالاتها النفسية والخيالية والثقافية والرمزية، وربطها بالتجربة الفردية والجماعية، حيث استخدام صور شعرية جديدة كالأسطورة والرمز.
فعلى سبيل الذكر لا الحصر، نجد قصيدة تموز جيكور[10] للشاعر بدر شاكر السياب حيث لجأ الشاعر إلى توظيف رموز ( الخنزير- عتمة- ظلمة، دمي …) في المقطع الأول للتعبير على اليأس والتشكيك في الحياة والأمل. وفي مقابل ذلك تأتي كلمات (جيكور ستولد- النور- القمح- النخل-اللحن …) للتعبير عن الأمل والحياة والانبعاث الحضاري، حتى ولو كان سبيل ذلك الصبر والتجلد بغية تحقيقه كما يرمز إلى ذلك النخل، وطبيعة الفداء عند الشاعر الذي أراد الحياة لجيكور من جرحه ودمائه. كما وظف رمز جيكور ليوحي إلى الحضارة والمدينة العربية المتردية التي يأمل في انبعاثها من جديد. لذلك فرمز جيكور يساوي الحضارة العربية التي تعيش الفساد والفداحة في الواقع ويأمل من خلالها الشاعر الانعتاق إلى الأفضل. أما بالنسبة للأسطورة فقد وظف الشاعر أسطورة بابلية أفرغ حشوها وجعلها قناعًا يلبسه ويتكلم به عن تجربته، فتموز في العالم السفلي هو الشاعر نفسه في جيكور رمز الأمة العربية التي تتوازى مع العالم السفلي الذي يوحي إلى موت الحضارة، فالشاعر مثل تموز ينتظر عشتار، ذلك الأمل الذي سيجعل الشاعر ينتقل إلى عالم الأحياء ويبعث الحضارة من جديد. وبالتالي فتموز هو الشاعر وجيكور هي الأمة العربية و قبلة عشتار هي الأمل. أدت الصور الشعرية وظيفة جمالية حيث نقل بها الشاعر اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى الرمزي، كما أدت أيضًا وظيفة تعبيرية حديثة حيث عبر بها الشاعر عن رؤيا جديدة رمزية من خلال الأسطورة والرمز، اللتين وسعتا أفق التعبير عن تجربة الشاعر.
هكذا تتنوع الرموز عند الشاعر الحديث بين الرموز الحضارية (بابل جيكور)، والدينية (الطوفان المسيح)، والطبيعية (المطر)، والشخصية (جيكور)، والأسطورية (ناب الخنزير، عشتار)، إلى غير ذلك. كما جعل الشاعر الأسطورة وتجربته الخاصة تتوازى في خط واحد وتسيران بشكل مستقيم، بل الشاعر غالبًا ما يفرغها من حشوها ويملأها بمعاناته في الواقع العربي الفادح، حيث هيكل الأسطورة يصبح قناعًا يضعه الشاعر ليصبح الشاعر هو الأسطورة نفسها. هذا ما جعل الشاعر الحداثي يوسع الصورة الشعرية التي أصبحت أرحب في التعبير مع الرمز والأسطورة.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
[1] انظر عزالدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، دار الكتاب العربي، ص: 356.
[2] للاطلاع أكثر أنظر محمد عزام، بنية الشعر الجديد، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء.
[3] أنظر الفصل الرابع أحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث، الطبعة الأولى، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ص: ابتداء 179 وما بعدها. بتصرف
[4] بدر شاكر السياب، ديوان أنشودة المطر، المجلد 1، دار العودة، بيروت، ص: 410-413
[5] أنظر الفصل الثاني أحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث، الطبعة الأولى، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ص: ابتداء 47 وما بعدها. بتصرف
[6] بدر شاكر السياب، ديوان أنشودة المطر، المجلد 1، دار العودة، بيروت، ص: 410-413
[7] بدر شاكر السياب، ديوان أنشودة المطر، المجلد 1، دار العودة، بيروت، ص: 410-413
[8] أنظر الفصل الثالث أحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث، الطبعة الأولى، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ص: ابتداء 87 وما بعدها. بتصرف
[9] علي أحمد سعيد:زمن الشّعر.دار العودة.بيروت.ط.1. 1972. ص 9 وما بعدها بتصرّف
[10] بدر شاكر السياب، ديوان أنشودة المطر، المجلد 1، دار العودة، بيروت، ص: 410-413
إن الفلسفة غير معنية بالوضوح أو بتقديم أي إجابات واضحة عن الإنسان والعالم. هناك مقاربات وتيارات فلسفية هي أشبه بلعبة...
رأى الطيار كينيث أرنولد، في 24 يونيو 1947م، تسعة أجسام هلالية الشكل تحلق بالقرب من جبل رينييه في ولاية...
ترجمة: هاشم الهلال - تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري هَدَفَ كتاب سوزان ستبينغ الفلسفيّ، إلى إعطاء الجميع أدوات التفكير الحُرّ. "هناك...
يدعونا جون بول سارتر في رائعته «الكينونة والعدم» -التي كُتبت خلال الاحتلال النّازيّ لفرنسا- إلى تخيّل مشهدٍ من الحياة اليوميّة:...
«معنى»، مؤسسة ثقافية تقدّمية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون، عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية. انطلقت في 20 مارس 2019، بهدف إثراء المحتوى العربي، ورفع ذائقة ووعي المتلقّي المحلي والدولي، عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف.